شاعر المدينة العربية يبحث عن معنى آخر لوجوده
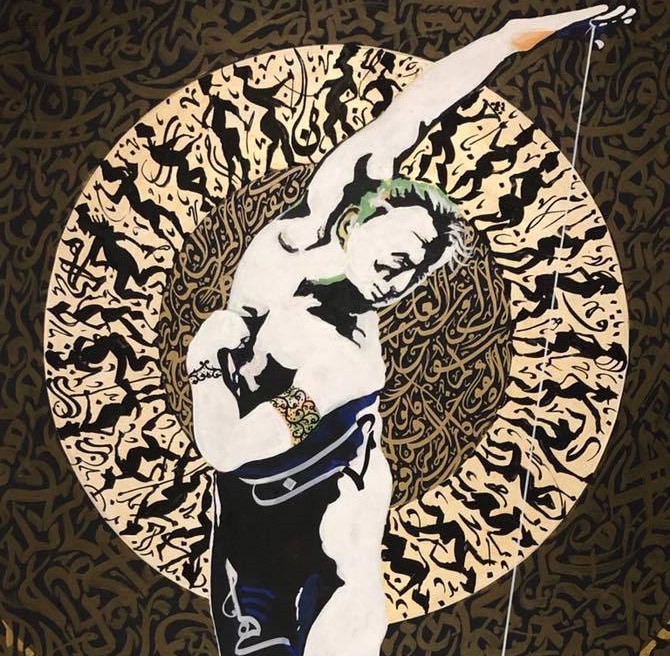
يفتح كتاب “شعرية الحداثة – الحركة الثانية لقصيدة الحداثة” للناقد ياسين النصيّر أفقا مثيرا في سياق قراءة مفاهيم الشعرية، تاريخيا ومنهجيا، وعبر تقانات استثمرت ما هو جمالي ولساني وفلسفي، وباتجاه ممارسة نقدية، هي أكثر تجاوزا، وأكثر نزوعا لتعرية نمطية النقد الأدبي التي فرضت خطابها منذ أكثر من نصف قرن، ولا سيما في مجال تحديد التجارب الشعرية تاريخيا، مقابل إخضاع هذه التجارب إلى مقاربات قرائية مفارقة، لها شغفها الاصطلاحي، والنقدي، ولها معالجتها لما هو قارّ في ذاكرتنا الشعرية.
“الحركة الثانية لقصيدة الحداثة” هي العتبة العنوانية الثانية للكتاب، الصادر عن دار المدى بغداد، لكنّها تشكّل المجال الإجرائي لمقاربات الكاتب النقدية، ولمحور أسئلته حول توصيفات وتعريفات القصيدة الجديدة، على مستوى علاقتها بالتاريخ والسياق والتكوين، أو على مستوى علاقتها بالمكان/ الفضاء والوثيقة والسلطة.
لعبة تداول المفاهيم النقدية تعكس خطورة ما يواجه العقل النقدي العربي من أسئلة وأزمات، ومن تعقيدات تخص أطروحات النظرية، ومعالجات المنهج، وإنّ إصدار أيِّ كتاب نقدي جديد في هذا المنحى يثير المزيد من الأسئلة حول طبيعة تلك المفاهيم، وطرائق توظيفها في الدرس النقدي للنصوص والأفكار.
الحركة الثانية
احتوى الكتاب على مُقدِمة وثلاثة أقسام تقصّى من خلالها الناقد تحولات الحركة الثانية لقصيدة الحداثة، وطرائق تمثلاتها في سياق التغيّرات السياسية والاجتماعية العراقية، وعبر صورها في الحياة اليومية، وفي فضاءات المعرفي والفلسفي والتشكيلي، والتي بدت تأثيراتها واضحة على هوية هذه القصيدة الجديدة في استشرافاتها الأولى، حيث كشف البريكان “عمق البعد الفلسفي في الشعرية الحديثة، وقد تعمقت بإنجاز الشاعر سعدي يوسف في تعامله مع المفردة اليومية والمألوفة”، فضلا عن تمثّلاتها في بيان الشعر 69، وتأشيره للاتجاهات العامة، والحاكمة للحركة الشعرية التي بدأها فاضل العزاوي بالقصيدة الكونكريتية، لينتهي بنثرية روائية متميزة، وقد جاورها فوزي كريم بنثرية شعرية عمّقت جوانب مهمة من قصيدته، خاصة الذاتية لتصبح نثريته بموازاة شعريته، واستقر سامي مهدي على القصيدة الغنائية الدرامية معمقا تحولاته بالعودة إلى اليومي والمألوف والأفول وحركة الواقع.
لم تكن الحركة الثانية لقصيدة الحداثة حركةً بريئة، أو جزءا من لعبة الكرونولوجيا التاريخية، بقدر ما كانت تمثيلا لتحولات عاصفة في “العقل الشعري” وفي مغامراته، وهوس شعرائه في البحث عن المغاير، وعن فضح العلاقة الملتبسة ما بين الكوني واليومي، والوجودي والذاتي، إذ بدت هذه الحركة وكأنها محاولةٌ للتمرد على مركزية الواقع ومركزية الأيديولوجيا، وانخراط في تحقيقات “تتمظهر فيها صور اليومي والمألوف واقعيا، وفي الوقت نفسه تتيح للشاعر أن يمتد خياليا وواقعيا وإيهاميا، وأن يعطينا هذا التصور فكرة شبه محققة نصيا على إمكانية خلق نص جديد”.
فضلا عن نزوعها إلى اقتراح فهم “الحداثة الشعرية” على وفق علاقتها بالمكاني واليومي والمألوف، وعن علاقتها بـ”الزمن الرمزي المجازي” وهي علائق تُحيل إلى شعرية القراءة، وإلى شعرية الفضاء، حيث تتحول القصيدة إلى مجال، وإلى رؤية، تتمظهر فيها “شعرية الواقع” وديناميته التي تتحفّز بالحضور والمحو أو بثنائية “الصيانية والتدمير”، كما يسميها النصيّر، وهي تقانات تفترض وعيا متعاليا في مقاربتها وفي كتاباتها، وفي إحالاتها، حيث تؤشّر مدى ما تعرّضت له قصائد شعراء رواد الحركة الأولى “السياب والبياتي ونازك الملائكة” من تغيّرات لها علاقة بالبناء التكويني لهذه القصيدة.
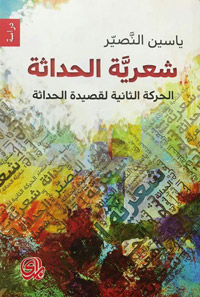
الحركة الثانية في الشعرية العراقية تقوم على فكرة “التفتيت” كما يرى النصيّر، تلك التي تتأنسن فيها القصيدة، عبر لعبة توظيف اليومي والمألوف والدرامي والحكواتي، وعبر ما تستدعيه من “الأساطير اليومية” حيث تتفكك “المهيمنة الإطارية” إلى توليدات شعورية، يشير الاضطراب فيها إلى اضطراب الإنسان ذاته، الإنسان الذي يُعنى بالجسد، والحلم، والمثيولوجيات المهيمنة، والتي تُشير إلى أضحوية الإنسان وسط القمع السياسي، والخراب الوجودي، فمفهوم “المدينة” الذي قرنه النصيّر بهذه الحركة هي الأفق التعبيري للتحولات الحادثة في بنية القصيدة، وفي شكلها، وفي فضائها الذي استغرقها بحميميته، وهواجسه، وبمرجعياته التي بدت أكثر انشغالا بموضوعات “الشاعر/ البيت” و”الشاعر/ المدينة” و”الجسد/ البيت” و”فضاء الشارع/ المدينة” وكلّها حوافز للتفكير، ولرؤية العالم كما يسميها غولدمان، فمن خلالها يرى الشاعر ما يتحول في وجوده وفي خطابه، وفي ما يهجس به من تحوّل في قصيدته، أو في ما يغويه أو ما يتمرد عليه.
علاقة الشاعر بالزمان والمكان هي الخيط الذي لم يعد سحريا، فكل ما يبدو صادما ومفارقا في الزمان السياسي أو الزمان الوجودي، نجد صداه في المكان، عبر مجموعات من السلطات التي اقترحها المؤلف، بوصفها حقولا معرفية كبرى لشعرنة اليومي والمألوف، وعبر ما تتبدّى علاماته وانزياحاته في “لغة المدينة” و”الأزياء والساحات” وعبر تضخم “الاستعارات” بوصفها “سلطة لسانية” لتبرير الهروب والتجاوز، أو لكتابة “النص المخفي”.
شاعر المدينة
يقترح المؤلف لقصيدة الحركة الثانية مستويات قرائية متعددة، تتمحور حول جملة من الفضاءات الأساسية، حيث الفضاء المرجعي، والفضاء الطوبوغرافي ذو الأشكال البنائية، وفضاء المخيّلة ذو الإيهام الفضائي الثانوي، والذي يدعو “على نحو أدق إلى تفحّص العلاقات التي يُقيمها الفضاء المُشخّص داخل نصٍ أدبي”.
هذه الفضاءات هي عتبات لفحص صور “اليومي والمألوف” الشعرية، وعبر تمفصلاتها مع العالم/ الوجود، ومع اللغة، وبما يُعطي للشاعر(حرية اللعب) في صياغة بنى درامية، أو تمثلات تتبدى عبر وظائف الضمائر، والصور واللقطات، وعبر مقاربة الوقائع والحوادث وما تضجّ به من صراعات وتشكّلات ويوميات، يسعى من خلالها المؤلف إلى وعي إرادة العالم ومقاربة عوالم اليومي في المدينة، والمؤلف -هنا- حريص على تأكيد علاقة شاعر “حركة الحداثة الثانية” مع تلك المدينة، حيث الاصطدام والمفارقة والنكوص والممارسة الطقسية، وحيث وضع صورة شاعر المدينة أمام مغامرة البحث عن وظيفة أخرى لوجوده، تلك الوظيفة التي تتجاوز ذاكرة القصيدة السيابية، إلى وظيفة مراقبة تحولات اليومي عبر الحكاية والسيرة والمثيولوجيا والطقوس.
في القسم الثالث من الكتاب عمد ياسين النصيّر إلى مقاربة موضوع تحولات الكلمة الشعرية في قصيدة المألوف واليومي -وهو ما أجده غير مناسب- ودورها في تشكيل الصورة اليومية، وكأنه أراد أنْ يضعنا أمام وظيفة افتراضية لهذه الكلمة، رغم أنّ أطروحات هذا التحوّل لم تكن بعيدة عن الجملة، والبنية، وهي الوحدات التركيبية والتصويرية الرئيسة في سياق التأليف الشعري، إذ أعطى للكلمة وظائف وعلائق، تقترب من التجريد، وعبر ما يشبه الاتساق مع “النغمة الشعبية” وما هو غنائي في الذاكرة العراقية، فضلا عن اعتمادها على السياق الحكائي والكنايات،
والسماع الشفوي، والطقوس والبطولات الشعبية.
إنّ أهمية قصيدة الحركة الثانية تكمن في تجاوزها، وفي طاقتها على تسحير اليومي، وعلى رفض “الأقنعة السياسية والطبقية والشخصية الذاتية كتعبير عن وضع مأساوي”، والاستغراق في التفاصيل، الحسية واليومية النابضة بالحياة.




























