رغم العلاقة المختلة بالآخر.. المسلمون لم يحرقوا مكتبة الإسكندرية
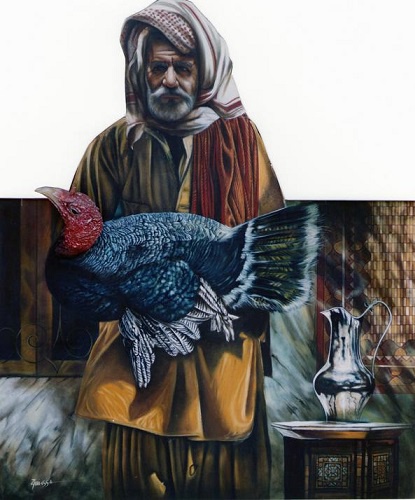
عمان – يرصد كتاب “إدراك العالم.. الصور النمطية المتبادلة بين الأنا والآخر” لزهير توفيق التصورات المتبادلة بين العرب المسلمين والآخرين في العصور الحديثة والوسطى، لاسيما الشرق الفارسي والغرب الكنسي.
ويضم الكتاب، الصادر حديثا عن “الآن ناشرون وموزعون” في الأردن، مقدمة ومدخلا تمهيديا وثلاثة فصول وخاتمة. يقول توفيق في المقدمة معرفا بالكتاب “يمثل هذا الكتاب دراسة استقصائية تاريخية وتحليلية لجدل الأنا والآخر، من خلال رصد التصورات المتبادلة بين العرب المسلمين والآخرين في العصور الوسطى والحديثة، كون العرب والمسلمين مثلا ذاتا لتعيين الآخر، وتخيله على المستوى الديني والإثني والسياسي؛ خاصة الفرس والأسود واليهودي والمسيحي، بفرعيه اللاتيني والبيزنطي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كونهم موضوعا للآخرين، أي صورتهم في المخيال الفارسي الشرقي (الشعوبية) والغربي الأوروبي؛ الرومي البيزنطي واللاتيني في القرون الوسطى، وتحولات تلك الصورة في أوروبا العصور الحديثة”.

ويؤكد المؤلف في الفقرة الأخيرة من المقدمة نظرة كلا الطرفين للآخر وكيف هي ثابتة لا تتزعزع، فيقول “لم يخرج لا الشرق العربي الإسلامي، ولا الآخر في الشرق والغرب قديما وحديثا عن مسلماته وطرائق تفكيره في فهم الآخر، فقد بقيت ثوابته الحضارية والدينية والإثنية سلطة مرجعية في فهم الذات والآخر، وتمييز الأنا عن الآخرين من فرس ويهود وبيزنطيين ولاتين، ومهما تغيرت الصورة وتحولت لأسباب داخلية وخارجية، فإن الثابت البنيوي فيها هو الآخرية وعمق الغيرية، أي تصعيد الخلاف والاختلاف، فالذات هي المركز الذي تدور حوله الأطراف، والأفضل والمعيار الأمثل، والآخر أو الآخرون مجرد أطراف، هوامش وبرابرة وكفار ومنحرفين، ولا يستحقون أكثر مما تمنحه لهم الذات المتعالية”.
ويأتي المدخل التمهيدي للكتاب مستشهدا بالعلاقة بين الأنا والآخر (الشرق والغرب)، على اعتبار أن الشرق حين يذكر يتبادر إلى الذهن الشرق المسلم على وجه الخصوص، والغرب يراد به الغرب الأوروبي بالأساس قديما وحديثا.
يقول توفيق في المدخل التمهيدي “تفترض قراءتنا للموضوع استمرار الصور النمطية للعرب والمسلمين، وهي الصور التي تشكلت في العصور الوسطى، ودخلت معجم الغرب بشكل نهائي كما هو في الاستشراق السياسي والأنثروبولوجي الحديث (الواعي لذاته) الذي نشأ في نهاية القرن الثامن عشر مع حملة نابليون بونابرت على المشرق العربي سنة 1798”.
ويحسم المؤلف القضية مؤكدا وضوح رغائب الغرب من الشرق (المسلم)، إذ يقول “لم ولن يتلطف الغرب مع الشرق إلا إذا تواطأ معه على ذاته، وتماهى في خطاب الغرب ومسيرته ورطانته من خلال نخبة فكرية وسياسية وكيلة، نجح الغرب في خلقها ورفعها إلى سدة السلطة، واستمدت مشروعيتها ومرجعية وجودها من دعمه المطلق على جميع المستويات، ومقابل ذاك الدعم سوقت خطابه في ثقافتها العالمة والشعبية على حد سواء، وهذا دليل نجاح الغرب في اختراق الشرق الذي وصل إلى طاعة الوكلاء، وامتثالية التابعين”.
وقريبا من نهاية الفصل الأول يفصل المؤلف القول حول أعلام الغرب البارزين الذين تبنوا أفكارا تنويرية ومنهم إدورد جيبون، يقول زهير توفيق “يبدو جيبون منسجما مع التنوير، ويقدم رؤية مستقلة نقدية خاصة لأحكام الغرب المتحاملة والسلبية عن الإسلام حتى ذلك الوقت، ففي عرضه لأخلاق العرب ودياناتهم قبل الإسلام يقول: غير أنه في الدولة العربية، وهي أكثر بساطة من الرومان واليونان، فإن الأمة حرة لأن كل فرد من أبنائها يستنكف أن يطأطئ الرأس في خضوع وذلة لإرادة سيد ما، ولقد حصن العربي نفسه بفضائل صارمة من الشجاعة والصبر والاعتدال ودفعه حبه للاستقلال إلى ممارسة عادة ضبط النفس، وحفظته خشية العار من أن يذل بالخوف من الألم والخطر والموت”.
لم ولن يتلطف الغرب مع الشرق إلا إذا تواطأ معه على ذاته، وتماهى في خطاب الغرب ومسيرته ورطانته من خلال نخبة فكرية وسياسية وكيلة، نجح الغرب في خلقها ورفعها إلى سدة السلطة
وأضاف جيبون “إن رجاحة عقل العربي وضبط نفسه واضحان في مظهره الخارجي. فحديثه يتميز بالأناة والجزالة والإيجاز، وقلما يستثار ليضحك، والحركة الوحيدة التي يقوم بها هي لمس لحيته، وتلك هي السمة الوقور للرجولة، وقد علمه شعوره بأهميته أن يتحدث إلى أقرانه دون استخفاف، وإلى رؤسائه دون رهبة، وقد بقيت الحرية العربية حتى بعد الفتوحات الإسلامية، وقد أجاز الخلفاء الأوائل أسلوب رعاياهم على ما فيه من رفع الكلفة والجرأة، على أن فنون النحو والعروض والبلاغة لم تكن معروفة للفصاحة العربية التي نشأت حرة، ولكن ذكاءهم كان حادا وخيالهم خصبا، ونكاتهم لاذعة وزاخرة بالحكمة، وربما نجد صدى هذا الكلام في أعمدة الحكمة السبعة للورنس العرب”.
ويفند توفيق القضية من وجهة نظر جيبون، ثم يختتم تلك النقطة قائلا “وأخيرا يبرئ جيبون المسلمين من حرق مكتبة الإسكندرية كما يروج الغرب دلالة على تدني المستوى الحضاري والثقافي للعرب المسلمين، يقول: ولكني أميل بشدة – وهذا رأيي الخاص – إلى إنكار هذه الواقعة ونتائجها كلية، فالواقعة حقا غريبة، يقول أبوالفرج نفسه: اقرأ وتعجب، ويرجح رواية هذا المؤرخ الأجنبي الوحيد الذي كتب بعد ستة قرون على ‘أرباض ميديا’ من مؤرخين أقدم منه”.
وفي خاتمة الكتاب يلخص زهير توفيق جوهر الموضوع الذي طرحه بين فصول الكتاب، فيقول “لم تكن الهوة واسعة، ولا المفارقة أشد معرفيا ومنهجيا إلا في قضية الأنا والآخر من العصر الوسيط إلى الوقت الراهن، وهو المدى الزمني الذي رصدناه في الكتاب، فعلى الرغم من المبادئ المؤسسة والوصايا التي جاء بها الوحي، بقي إسلام التاريخ أو الممارسة العينية ممثلا في إسلام السلطة ومعيش الأغلبية بعيدا عن مثاليات إسلام الوحي والنص، وبقيت العدالة والمساواة والرحمة والأخوة والإنسانية المطلوب ممارستها مع الآخر، محصورة في نطاق الأنا، وصعبت الذات العربية الإسلامية الأمور على نفسها في الصراع والمواجهة بتضييق مجالها العام وفضائها المذهبي والإثني، مقابل توسيع جبهة الآخر، وكلما توسع مجال الآخر وتعدد، تقلص مجال الأنا وضاق في الفكر والتاريخ الواقعي”.
ومن الجدير بالذكر أن زهير توفيق كاتب وشاعر وأكاديمي أردني، باحث في قضايا الفلسفة والنقد، رئيس جمعية النقاد الأردنيين، عضو الجمعية الفلسفية الأردنية، نشر العشرات من الأبحاث النقدية والفلسفية في الدوريات الأردنية والعربية. صدر له العديد من الكتب الفكرية والفلسفية كما حاز على العديد من الجوائز الأدبية.




















