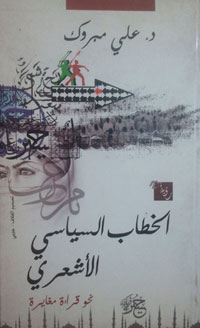رحيل المفكر المصري علي مبروك حامل مشعل طه حسين

القاهرة - عن عمر ناهر 58 عاما رحل الأحد الماضي المفكر المصري وأستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة علي مبروك، بعد صراع طويل مع المرض. ويعد الراحل أحد أهم المفكرين المصريين الذين ناقشوا في مؤلفاتهم التراث الإسلامي بجرأة، سعيا إلى إعادة قراءته من جديد، وتجديد الخطاب الديني، وقد ترك العديد من الكتب التي تعرضت لما هو مثير للجدل في الفكر والفلسفة الإسلامية.
ولد مبروك في 20 أكتوبر عام 1958، وقد تحصل على درجة الماجستير في الفلسفة الإسلامية – علم الكلام عام 1988، وعلى درجة الدكتوراه في الفلسفة عام 1995، من جامعة القاهرة، وعمل عام 2003، أستاذا مساعدا للدراسات الإسلامية، في قسم الدراسات الدينية، بكلية الإنسانيات في جامعة كيب تاون، بجنوب أفريقيا.
رغم مسيرة حياته المليئة بالعراقيل، قدم المفكر ما يزيد عن 12 مؤلفا فكريا، من أبرزها “لعبة الحداثة بين الجنرال والباشا”، و”النبوة… من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ”، و”أفكار مؤثمة، من اللاهوتي إلى الإنساني”، وكان آخر كتبه “نصوص حول القرآن، في السعي وراء القرآن الحي”، الصادر عن المركز الثقافي العربي.
نقد التراث
في حديثه عن الراحل يقول الكاتب والقاص المصري شريف صالح “لا أدّعي معرفة عميقة بمشروع علي مبروك، فرغم صداقتنا الافتراضية لم يحدث أن دار بيننا حوار، لكنني قرأت العديد من مقالاته التي كان ينشرها في صفحته، فتكوّن لديّ انطباع بأنه امتداد لبذرة طه حسين في كلية الآداب في القاهرة، إذ يعود الراحل إلى التراث يسائله ويحاكمه إذا لزم الأمر، نازعا عنه هالة القداسة. لكن أغلب من يغامر في هذا الحقل الفكري يتراجع في منتصف الطريق، حتى طه حسين نفسه، غامر ثم تراجع. لكن في هذا الامتداد تقف أسماء مرموقة، لعل أكثرها إثارة للجدل الراحل نصر أبوزيد، وآخر عنقود تلك المدرسة كان علي مبروك نفسه”.
يتابع الكاتب “لا أُريد أن يُفهم من كلامي أن نقد التراث بدأ مع طه حسين، فبالطبع كان للتيار العقلاني رواده من المعتزلة إلى ابن رشد وابن خلدون، وصولا إلى جورج طرابيشي الذي فقدناه أيضا قبل أسبوع.
الراحل فضح اﻷصل السياسي لكل من يرتدي مسوحا دينية، ليكتسب قداسة غير مستحقه، وعرى الجسد السياسي للأفكار
الملاحظة الأخرى التي لفتت انتباه شريف صالح هو أن المفكر الراحل أصدر في الأشهر الأخيرة مجموعة كبيرة من الأبحاث والكتب، أكثر من أربعة كتب في غضون سنة، كما نشط في كتابة المقالات وإجراء الحوارات، رغم الحذر الرسمي تجاهه بسبب تعرضه لأسماء راسخة مثل الشافعي والأشعري.
بدوره يتساءل الشاعر المصري محمد حربي عن المشاريع التي لم تكتمل، وهل صار قدرا على مصر أن تفقد أبناءها المبدعين قبل أن يكملوا غرس أسئلتهم في التربة العميقة للوجدان والعقل المصري، وهل صار قدرا على المبدعين أن تنتهي بهم الرحلة، بينما هم يغرسون فواتح الأسئلة الكبرى؟ أهو قدر أم سؤال مفتوح عن ضياع الأحلام تباعا نتذكره ونحن نودع كل يوم مبدعا مصريا لم يقل بعد ما يريد رغم أنه قدم إرهاصات لافته على نبوغه؟
|
يقول حربي “اليوم ودعنا مفكرا مصريا، كان يجدد في الدين تحت شعار ليكن القرآن ساحة لإنتاج المعنى والمعرفة والمحبة، بدلا من أن يكون ساحة لتناحر التفاسير والتأويلات حول القهر والسلطة والسلطان.
يتابع حربي “كان الراحل يمدّ بساط البحث والتساؤل الذي طرحه الإمام محمد عبده عن العقلانية في الإسلام وارتباط الإسلام بقيمة العلم، من دون الوقوع في التوفيقية المفرغة، وكان يجمع بين أسئلة الشك المنهجي التي استخدمها طه حسين في قراءته للموروث، وقراءة الإمام والمجدد أمين الخولي صاحب نظرية القراءة البيانية والجمالية للقرآن، وهي النظرية التي اتبعها نصر حامد أبوزيد الأب الروحي لعلي مبروك.
أهمية علي مبروك، كما يراها الشاعر، ليست في النتاج المعرفي الذي قدمه، بل في المنهج الذي استخدمه والذي طور فيه من رؤى أستاذه نصر أبوزيد، وإذا كان أبوزيد يسائل التراث في بنيته نفسها انطلاقا من درس اللغة ذاتها وعلاماتها ورموزها، فإن مبروك قد طور الأسئلة واقترب بها من أسئلة الإبستيمولوجيا التي تحاول تفكيك بنى إنتاح المعرفة في هذا الموروث من دون أن يتنكر للسيميوطيقا والهيرمنيوطيقا، حيث يعتبر مثلا القرآن ساحة لإنتاج المعنى وليس ساحة لتكريس السلطة مثلما حدث في قضية رفع المصاحف على أسنة الرماح وهي اللحظة التأسيسية برأي مبروك في تسييس الدين ورفع السياسة إلى مرتبة من القداسة لا تتحملها طبيعة الأمور ولا صيرورة التاريخ.
علي مبروك سعى إلى تفكيك العقل الأشعري والمعتزلي والعقل السائد الآن في المشهد الثقافي والمعرفي والسياسي
لكن الجزء السلبي في القصة، كما يقول حربي، يكمن في أن مبروك دفع فاتورة ما تعلمه، فقد آمن بحقه في انتقاد أساتذته الذين علموه لأنهم قالوا إنهم تقدميون، وعندما صدق المقولات ردّوها عليه سهاما من الإهمال والتجاهل والتنكر، فواجه مشكلة في الترقي الأكاديمي، إذ رفض أحد أستاذته الكبار مناصرته بينما كان يناصر من هم أقل منه مستوى ونبوغا.
ويؤكد حربي إن مصر خسرت مفكرا جديرا بالاحترام، لأنه في زمن التباس المشاهد الفكرية اختار الراحل درب الأسئلة الجذرية ولم يخش في العلم لومة لائم، لافتا إلى أن أهمية إعادة قراءة علي مبروك تكمن في استمرار منهج الدرس العقلي للتراث الإسلامي.
طبيب بمطرقة
من جهته يقول الشاعر والباحث المصري أشرف البولاقي “بالرحيل المفاجئ والصادم والمُباغت للمفكر علي مبروك، يتأكد لنا انفراط عقد أمل الثقافة العربية، في اقتراب الخروج من نفق العتمة إلى نور العقل والحرية.
|
يتابع البولاقي “كان مبروك يجد عزاءه وسلواه في بعض تلاميذه ومريديه، وفي كثير من قرائه الذين أقبلوا على كتبه ومقالاته قراءة وتفاعلا ونشرا لها، كان يحلم بمستقبل أفضل للعقل العربي وهو العقل العربي نفسه الذي استشرت علله وأمراضه واستوحشت ثقافيا واجتماعيا وفكريا، قبل أن تستشري وتتوحش مرضيا لتفتك به بغتة أثناء حلمه اليتيم بهذا المستقبل، سننتظر سنوات طوالا ليشرق علينا مفكر بحجم وقيمة علي مبروك”.
ويعتبر الكاتب المصري عمر شهريار رحيل المفكر علي مبروك خسارة فادحة للثقافة العربية، فلم يكن الراحل مجرد أستاذ جامعة تقليدي، بحسب رأيه، بل كان من القلائل الذين يعوّل عليهم في تجديد الخطاب الثقافي العربي، عبر تفكيك البنى المعرفية الجامدة لهذا العقل، والتي تمثل عائقا أمام تثويره وانطلاقه.
يقول شهريار “كان علي مبروك ينطلق من مقولة نيتشه "أنا فليسوف يعمل بالمطرقة" والتي كان كثيرا ما يقولها لنا ونحن طلاب نجلس أمامه في قاعات الجامعة، فقد كان مهموما ومنشغلا بتكسير وهدم كل اﻷصنام المعرفية التي توهم ببداهتها وبحقيقتها، فاضحا اﻷصل السياسي لكل من يرتدي مسوحا دينية، ليكتسب قداسة غير
مستحقه. مبروك عمِل على نزع هذه القداسة وتمزيقها، وجعل الجسد السياسي للأفكار والصراعات يقف عاريا من أي عباءة دينية يتدثر بها”. ويشير الكاتب إلى أنه رغم الرحلة القصيرة للمفكر الراحل مع الحياة، فإنه ترك أثرا لا يمّحي، حيث عكف على قراءة الثقافة العربية والوقوف على مناطق تعثرها وارتباكها، كاشفا عن الاختلالات البنيوية التي تمركزت في مفاصلها تاريخيا، ومن ثم جعلتها عاجزة عن المضي قدما في أي محاولة للانفلات. إنه كطبيب ماهر استطاع أن يشخص أسباب الكساح الذي أصاب العقل العربي، وجعله -رغم مرور السنوات والقرون- غير قادر على مفارقة لحظته التاريخية القديمة.