حنفي وعبده
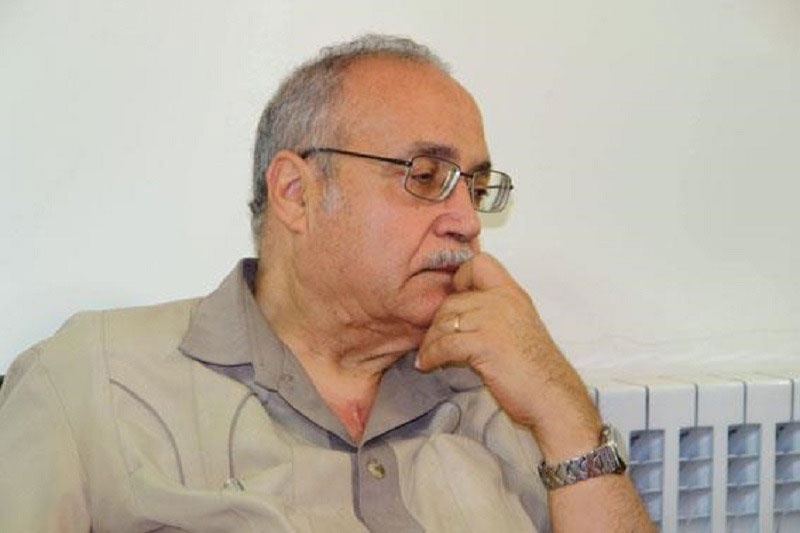
اختتم حسن حنفي حياته عن عمر يناهز السادسة والثمانين، بعد رحلة طويلة من الحفر في الصخر، لكي يجد لمشروع قراءاته الفلسفية للدين مكاناً في الحياة. ولم يستطع الرجل الأكاديمي خوض مجرى النهر الذي يسقي الوعي الشعبي من خلال التطور في وسائل الاتصال. التزم وسيلة التأليف والإصدارات، بينما الكتب باتت أقفاصاً أو صناديق مقفلة بحكم العزوف المتفشي عن القراءة. وبالطبع، لم يكن صعباً على الأصوليين التشكيك في إيمانه، لأن من يَحِد عن رؤية الوعي الديني كخادم للجماعات الساعية إلى الحكم أحادي الرؤية؛ تراه هذه الجماعات من أهل الضلال. والمترفقون بحنفي أطلقوا على اجتهاداته وصف اليسار، ولم يزعجه الوصف، فكتب عنه!
بدأ الرجل رحلة البحث من موقع العلوم الفلسفية، متأثراً برجل أسبق هو عثمان أمين الذي كان واحداً من المبتعثين إلى فرنسا للدراسة لكي تتوافر لمصر شريحة معتبرة من المتخصصين في القانون والآداب والعلوم الاجتماعية والفلسفة. وقد تأثر حسن حنفي بعثمان، وسار على ذات الطريق، عندما التحق بجامعة السوربون الفرنسية وقرأ في الأدب والفن، وفي العلوم والفلسفة، وتابع كبار الأساتذة، وامتلك ناصية اللغة الفرنسية. وكان عثمان ومن بعده حنفي، من المتأثرين بالشيخ محمد عبده إمام التنوير.
كتب حسن حنفي عن “عرب هذا الزمان” وأصدر موسوعة من خمسة أجزاء، عن “العقيدة والثورة” وطرح بقوة مسألة “التراث والتجديد”. وتحتَ مظلة مَشروعه أصدر “نماذج مِن الفلسفة المسيحية في العصرِ الوسيط” داعياً إلى السلام والتسامح والتعاون.
وفي ضوء ما حدث من رواج الجهالة في تفسير الدين، دعا حسن حنفي إلى الأخذ بفتاوى الشيخ محمد عبده الذي اتسمت مراحل تاريخه الفكري بالاستنارة والوطنية العالية، وغدت آراؤه أجمل ما في الفكر الإسلامي الحديث، من حيث تغذية الروح العربية التجديدية.
لم يخطئ حنفي في استلهام فكر الشيخ محمد عبده والعودة إلى تأمله والاجتهاد بهَديٍ منه. فقد اعترف المفكرون الأوربيون بفطنة عبده وذكائه، وهو الذي ثابر على مراسلة عدد منهم والتواصل مع الأديب الروسي ليو توليستوي، وترجم كتاب صديقه الأديب هيربرت سبنسر عن التربية، مستشعراً ضرورة أن يسعى المسلمون للأخذ بأسباب التقدم. فحب الوطن ـ حسب قوله ـ يدفعنا إلى الحفاظ على وحدتنا، وضمانة الوحدة هي المساواة في المواطنة، وعندما كان مفتياً لم يتردد في التقليل من أهمية وظيفته، وهذه حقيقة شجعت حسن حنفي على الكتابة في موضوع تجديد التراث. فقد كان الإمام يقول إذا تعارض العقل والنقل يؤخذ بما دل عليه العقل، ولكلّ مسلم أن يفهم عن الله، من كتاب الله، وعن رسوله من كلام رسوله دون توسيط أحد من سلف أو خَلف. بل إنه القائل “من الضلال القول بتوحيد الإسلام بين السلطتين الدينية والمدنية فهذه الفكرة خطأ محض، ودخيلة علي الإسلام، ومن الخطأ الزعم بأن السلطان هو مقرر الدين وواضع أحكامه ومنفذها. فالإنسان لم يخلق ليُقاد بالزمام، بل فُطر على أن يهتدي بالعلم”. وفي الثورة، لم يتأخر محمد عبده عن مناصرة أحمد عُرابي، وقد دفع الثمن نفياً وسجناً، رغم أنه الناصح له بالتدرج من قَبْل. وأفتي بجواز التصوير الفوتوغرافي وإقامة التماثيل وجواز أكل ذبائح المسيحيين واليهود، والسماح للمسلم بارتداء الزي الأوروبي، وارتداد القبعة، وأجاز فائدة البنوك والتأمين. ومعظم هذا يأخذ به الأصوليون المُحْدثون، وما زال بعضهم يخالفون بعضه الآخر.
رحم الله عبده وحنفي وأثابهما. فقد غادرا الدنيا، كل في موعده، تاركين “عرب هذا الزمان”!
























