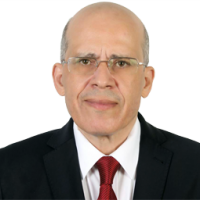تونس والغرب وسوء التفاهم المكلف

تميزت العلاقات بين الطبقة السياسية التي نشأت في تونس بعد “الربيع العربي” ومخاطبيها وشركائها في الغرب بحلقات مسترسلة من سوء التفاهم مهدت الطريق للكثير من خيبات الأمل بين الطرفين.
أول عناصر سوء التفاهم هذه كان اعتقاد النخبة الحاكمة في تونس بعد 2011 أن مجرد تفكيك مقومات المنظومة السابقة واتباع الوصفات التقليدية للانتقال الديمقراطي كانا كفيلين بتلبية حاجيات البلاد واستحقاقاتها وكسب التأييد المتواصل من الغرب.
ولم تستوعب المنظومة الجديدة درسا أساسيا وهو أن انهيار النظام السابق نتج إلى حد كبير عن تدهور الأحوال المعيشية لشرائح واسعة من المجتمع خاصة في المناطق الداخلية.
وبقيت تركز على الجانب الذي كان يستهويها أكثر من غيره وهو إعادة بناء المنظومة السياسية في ظل عملية للانتقال الديمقراطي.
سوء تفاهم تاريخي
في بعض جوانب النظرة الغربية إلى التجربة التونسية كانت هناك رواسب من عمليات الانتقال الديمقراطي السابقة في أوروبا سواء تلك المتعلقة بفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أو تلك التي تلت انهيار الاتحاد السوفياتي.
لا يبدو الغرب مستعدا لتوريط نفسه أكثر من اللزوم لإخراج تونس من أزمتها المالية خاصة وأنه يواجه هو نفسه أوضاعا صعبة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا
ولكنه لم يكن هناك أصلا وجه للمقارنة بين المسار الذي بدأته تونس سنة 2011 من جهة والمسار الذي انتهجه الغرب تجاه بلدان أوروبا من جهة أخرى. كان الهدف في الحالتين بالنسبة إلى الغرب هو إدخال البلدان الأوروبية، يومها مثلما هو الحال اليوم بالنسبة إلى أوكرانيا، ضمن مدار “الديمقراطيات الليبرالية”. كانت هناك قناعة بضرورة التصدي للتهديد الشيوعي (أو الروسي اليوم) وكذلك وعي بوجود قواسم مشتركة ثقافية وتاريخية تجمع المعسكر الغربي – الأطلسي ببلدان أوروبا، شرقها وغربها.
في تونس كان التحدي الأساسي الذي يطمح الغرب إلى تحقيقه هو طَي صفحة الحكم السلطوي وبناء تجربة ديمقراطية “كنموذج” يمكن أن تحتذيه بلدان عربية أخرى على أساس سردية “الربيع العربي”.
لم تكن تونس متحمسة كي تكون نموذجا إقليميا للديمقراطية، ولم يبلور الغرب أبدا رؤى مقنعة بهذا الصدد تتجاوز الشعارات. ولم يظهر استعدادا لتعبئة موارده لخدمة هذا الهدف.
سوء التفاهم السياسي
كان الغرب يتصرف على أساس الثقة في نجاح وصفات الانتقال الديمقراطي التقليدية في تونس ولو بشيء من الدعم الاقتصادي والمساعدة الميدانية على مقاومة الإرهاب.
كان هناك اعتقاد في قدرة الطبقة السياسية الجديدة في تونس على ضمان الحد الأدنى من النجاح للتجربة الديمقراطية.
وكانت القوى الغربية تتصرف على أساس أن المنظومة الناشئة في تونس بالرغم من قلة تجربتها والشكوك في كفاءتها في سدة الحكم، قادرة ليس فقط على تسيير شؤون البلاد وإنما على تحصين البلدان الأوروبية من أخطار التطرف والإرهاب والهجرة غير النظامية التي قد تجد منطلقا لها من البلاد التونسية.
لم يكن الغرب، بما فيه أوروبا والولايات المتحدة، مهتما كثيرا بالصعوبات والخيبات التي كانت تواجه مسار الانتقال الديمقراطي والاهتراء السريع لمصداقية النخبة السياسية. كان التركيز على الأطر الشكلية للممارسة الديمقراطية أكثر من جوهرها. وكان الانطباع السائد أنه ما دامت هناك انتخابات ودستور وبرلمان وتعددية سياسية فإنه لا موجب للقلق.
بقيت الثقة الخارجية في المسار الانتقالي التونسي راسخة ولم تتأثر بأحداث الإرهاب والعنف السياسي، ومن بينها اغتيال الزعيمين السياسيين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وقبلها الهجوم على السفارة الأميركية من قبل جماعات سلفية عنيفة.
وكان أكبر مصدر لسوء التفاهم السياسي عدم فهم الغرب مبكرا أن أولويات الأغلبية في تونس لم تعد متطابقة مع أهداف النخبة التي بقيت غير مهتمة كما ينبغي بالاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وبعكس التفاؤل الغربي بالتجربة التونسية كانت رؤية الرأي العام الداخلي لواقع بلاده أكثر دقة وواقعية. تآكلت الثقة في الساسة ومؤسساتهم نتيجة سلوكيات السياسيين واهتزاز الوضع الاقتصادي، وإن بقي التونسيون متعلقين بالحريات السياسية والإعلامية التي اكتسبوها منذ 2011.
المأزق الاقتصادي والاجتماعي

لم يكن لدى الطبقة السياسية بعد 2011 وعي بحجم التحديات التي كانت تواجه البلاد أو بالجهود الذاتية المطلوبة منها. بقيت تعوّل بشكل مبالغ فيه على المساعدة الخارجية من أجل مواجهة تحديات البلاد الاقتصادية والاجتماعية. بل إن البعض من مكونات هذه الطبقة كان يحلم بدعم خارجي في حجم “خطة مارشال” التي أعادت بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية بما قيمته مئتي مليار دولار تقريبا (حسب القيمة الفعلية للمبلغ في الوقت الحالي).
لم تكن لهذه النخبة السياسية، خاصة منها الحاكمة، رؤية حقيقية لكيفية تحقيق الانتقال الاقتصادي والاجتماعي. فاكتفت بالتأجيل والتسويف والجرعات المسكنة في مواجهة مختلف مظاهر الخلل التنموي وانخرام التوازن المالي. وتدريجيا انتفت كل إمكانية لتأجيل الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة.
وبعد عقد من الزمن استيقظت البلاد على واقع صعب ووجدت نفسها تفاوض صندوق النقد الدولي لإنقاذ موازنتها والنأي بنفسها عن سيناريو الخضوع لشروط نادي باريس في معالجة دينها الخارجي.
في المقابل ومنذ البداية لم تكن الدول المانحة من الغرب (إضافة إلى عدد من الدول العربية) ترى في مساعداتها الاقتصادية لتونس مقدمة للانخراط في مشروع بعيد الأمد لإعادة البناء وإصلاح منوال التنمية في البلاد. كان هدفها فقط تقديم جرعات من الأكسجين لاقتصاد على أبواب الاختناق.
بقيت الحكومات المتعاقبة في تونس تتصرف في المقابل وكأنما حبل النجاة الخارجي ثابت لا رجعة فيه وسيدفع بالضرورة مسار الإنعاش الاقتصادي حتى بدون مبادرات جدية من الداخل.
صحيح أن تونس حصلت على المليارات من الدولارات من داعميها في الخارج بعد 2011، ولكن الدعم المالي لم يكن استثنائيا بالمستوى الذي كان يمكن أن يسمح لتونس بإصلاح نقاط الخلل التنموية التي زعزعت استقرار نظام بن علي منذ 2008.
وأكبر دليل على ذلك أن معظم المساعدات الاقتصادية الممنوحة لتونس كانت في شكل قروض أو ودائع بنكية، خلافا للمساعدات الممنوحة لأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية والتي كانت نسبة الهبات فيها تفوق 90 في المئة.
اندرج الدعم أوروبيا في إطار سياسة الجوار المتبعة من قبل المجموعة الأوروبية منذ سنوات سابقة. وتركز أميركيا على مقاومة الإرهاب في نطاق سياسة واشنطن لدعم الاستقرار في شمال أفريقيا وجنوب المتوسط.
تلك المؤشرات كان يجب أن تنبه الحكومات التونسية إلى أن الكرم الحاتمي الذي كانت تحلم به من الخارج له حدود، وأن موازنة البلاد ستبقى تقف على رمال متحركة ما لم يحصل وعي بضرورة تنفيذ خطة متكاملة للنهوض بالاقتصاد وتلبية الاستحقاقات الاجتماعية المؤجلة.
ولكن ذلك الوعي لم يحصل. ودخلت تونس تدريجيا في حلقة مفرغة من التداين والعجز المالي لم تنته إلى اليوم، واستدعى ذلك الاقتراض المتواصل من أجل تسديد الرواتب ومواجهة المستحقات الاجتماعية العاجلة.
كان درء الاضطرابات في خضم ذلك هو الهدف الرئيس. ولم يكن بناء مشروع تنموي جديد من جملة أهداف الداخل أو الخارج.
برر بعض المسؤولين التونسيين لاحقا فشلهم في الحكم بعد 2011 بوقوعهم تحت ضغط الاحتجاجات الاجتماعية التي لا تنتهي بالإضافة إلى غياب الاستقرار الحكومي وتعثر الحوكمة نتيجة قلة التجربة للبعض وانعدام الكفاءة للآخرين أو سقوطهم في سوء التصرف والمحاصصة الحزبية.
مهما كانت الأسباب فالنتيجة كانت في نهاية المطاف تبخر الكثير من الأوهام لتحل محلها الكثير من خيبات الأمل.
المربع الأخير

اكتشفت الدول الغربية بشكل متأخر أن التأسيس لمنظومة ديمقراطية ليبرالية رائدة لم يكن من أولويات الطبقة السياسية الغارقة في انقساماتها وأزماتها، وليس ضمن أولويات عامة الناس في تونس.
كان الهدف الذي يهم أغلبية التونسيين هو تحقيق حياة كريمة تضمن لهم أوضاعا اقتصادية واجتماعية أفضل. كل شيء غير ذلك كان نوعا من الترف. لم يكن ذلك يتناقض وطموح التونسيين عامة لتأسيس منظومة سياسية متطورة ترسخ حرياتهم وتسهر على مساواتهم في الحقوق والواجبات وتقاوم الفساد والرشوة. ولكن تحسين مستوى المعيشة كان هو الأصل.
لم يكن أغلب التونسيين يرون أن النخبة السياسية قادرة عن ذلك. وكانت علامات عدم رضا الرأي العام على هذه النخبة واضحة المعالم. وأدى ذلك تدريجيا إلى ضرب مصداقية الأحزاب والحكومات والمؤسسات المنتخبة.
وكانت الهجرة المتزايدة للكفاءات من أكبر المؤشرات على تفاقم عدم الرضا عن هذه النخبة وانعدام الثقة في المستقبل.
كما كانت الهجرة أيضا مرآة تعكس قصر النظر عند الساسة في الغرب خاصة في أوروبا. ففي الوقت الذي كان يتوقع فيه الكثير من التونسيين مبادرات أوروبية لتنفيس الضغط عن سوق الشغل بعد 2011، بقيت السياسات الأوروبية محكومة بالاعتبارات السياسية الداخلية والاستحقاقات الانتخابية لبلدان المجموعة. وعلى خلفية المشاعر التي أججتها الأحداث الإرهابية التي تورط فيها مهاجرون من المنطقة المغاربية، قلصت فرنسا على سبيل المثال عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين والمغاربيين.
في نفس الوقت كانت البلدان الأوروبية، وخاصة فرنسا وألمانيا، لا تدخر جهدا لجذب الكفاءات التونسية في إطار سياسة انتقائية للهجرة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة هذه البلدان قبل كل شيء.
ليس هناك أي مفاجأة في أن يكتشف الغرب بعد سنوات وضعا معقدا في تونس يتداخل فيه الاقتصادي والاجتماعي بالسياسي. ونتيجة لهذا الوضع أصبح الغرب يواجه امتحانا عسيرا لقدرته على تنسيب الأمور والصبر على تعثر المسار الديمقراطي في تونس.
ومنذ تطبيق الرئيس قيس سعيد للإجراءات الاستثنائية التي منحته معظم السلطات في البلاد، إضافة إلى حل البرلمان وإعادة تشكيل الهيئتين المستقلتين القضائية والانتخابية، تبدو أوروبا والولايات المتحدة أمام مأزق سياسي ودبلوماسي، فهما تتأرجحان بين التعبير عن “الانشغال” بأوضاع تونس والأخذ بعين الاعتبار مستوى المساندة الشعبية التي ما يزال يتمتع بها الرئيس التونسي.
أما اقتصاديا، فلا يبدو الغرب مستعدا لتوريط نفسه أكثر من اللزوم لإخراج تونس من أزمتها المالية خاصة وأنه يواجه هو نفسه أوضاعا صعبة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. بل هو يبدو مستعدا ليخطو خطوة في الاتجاه المعاكس للمسار الذي درج عليه إلى حد الآن في تقديم المساعدة لتونس.
اليوم لا يتردد الغرب في التهديد، مثلما فعلت واشنطن، بتقليص المعونة الخارجية لتونس بالنسبة إلى العام القادم.
وفي الأثناء يبدو التونسيون في المقابل مستعدين لعدم الاكتراث كثيرا بما يفكر فيه الغرب تجاههم. الهم الذي يساور أذهان الكثيرين هو أن يجدوا الحلول الفردية التي تؤمن لهم ظروف الحياة الكريمة أو تيسر لهم الطريق للهجرة إلى الخارج إن انسدت أمامهم بقية الطرقات.