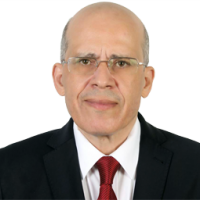تونس والخطوط الحمراء

يبدو من الغريب أحيانا أن تصر النخب السياسية من مختلف المشارب والأهواء في تونس على السير دوما نحو طريق مسدود وأن تسعى إلى عدم الاتفاق على شيء.
هناك على وجه التأكيد أسباب موضوعية للاختلافات والخلافات وحالة التشظي السائدة. ولكن هناك أيضا عائقا منهجيا في التطرق إلى سائر القضايا المطروحة.
يتمثل هذا العائق في الخطوط الحمراء التي يرسمها الفرقاء أو هم يتخيلونها مرسومة.
خطوط تجعل الهدف المنشود عامة مجرد محاولة لفرض صيغ جاهزة مسبقا بشكل لا يقبل بالتنازلات أو بالحلول الوسطى. ويصبح الاختلاف طريقا للمزيد من التصعيد والتقدم بخطى حثيثة نحو المواجهة حتى إن لم تحدث في نهاية المطاف.
◙ تونس لا تحتاج اليوم إلى خطوط حمراء تزيد في أجواء الشحن والصدام بقدر ما تحتاج إلى إعادة بناء جسور الثقة بين الأطراف الراغبة في المشاركة في البناء والمساهمة في رفع التحديات
الخطوط الحمراء يرسمها الفاعلون السياسيون والمثقفون كبديل للنقاش، يتخيلون أن لمواقفهم قدسية تجعلها غير قابلة للمراجعة أو التحوير. وليس في السياسة في الواقع قدسية سوى تلك التي يصطنعها الساسة.
عندما تتخندق الأطراف المتقابلة وراء عنادها الفكري وتتبادل النعوت والتهم فهي تلغي إمكانات النقد والنقاش وتمهد للصدام المدمر الذي لا يمكن إلا أن يعصف بالجميع لو حصل.
المواقف المبنية على الخطوط الحمراء تتضمن تهديدات ضمنية للطرف المقابل بأنه سوف يواجه مصيرا قاسيا غير محدد الملامح إن هو تجرأ على تجاوز الحدود المرسومة له مسبقا.
تذكرك هذه المواقف بالخطوط التي درج القادة العسكريون والسياسيون من عهد الإمبراطورية الرومانية إلى أيام جورج بوش في حرب الخليج على رسمها في الرمل.
المنطق الخفي فيها هو أساسا منطق القوة الصلبة والأمر الواقع وليس منطق الإقناع.
تلعب الخطوط الحمراء وتلك المحفورة في الرمل دور الحواجز الافتراضية التي تفصل بين الفاعلين والفرقاء. تفصلهم عن بعضهم وتجعل الهوة القائمة بينهم غير قابلة للجسر.
وفي نفس الوقت تسجن الخطوط الحمراء أصحاب هذه المواقف داخل أسوار عالية وتقطع عليهم خط الرجعة. يأسرهم خيار الرفض والممانعة وتأسرهم لاءاته.
أكيد أن هناك مبادئ أساسية تقوم عليها الدولة ويفترض أن يدافع عنها المجتمع مثل الانتصار لسيادة البلاد وأمنها ووحدتها الترابية. وهي مبادئ تنص عليها عادة دساتير الأمم، وأي محاولة للتعدي عليها ترفضها عادة الأغلبية سواء من خلال الاستفتاءات الشعبية أو دونها.
غير أن تلك المفاهيم الأساسية في العادة قابلة للنقاش. وتجارب الانتقال السياسي في تونس منذ الاستقلال أظهرت مثلا أن نصوص الدساتير، بما فيها الفصول “الممنوعة من التنقيح”، قابلة للإلغاء كليا أو جزئيا كلما تغيرت الأنظمة أو وجدت النخب الحاكمة مصلحة في تحويرها.
والاعتقاد بأن هناك نصوصا أو سياسات أو قوانين صالحة لكل الأنظمة والأزمان ولكل الظروف الاقتصادية والاجتماعية هو وهم لا علاقة له بالواقع.
◙ من الواضح أن الخطوط الحمراء لا ترسمها فقط حسابات المتنافسين على حلبة السياسة بل هي أيضا تعكس مشاعر الحقد والكراهية المتفاقمة
وشتان بين المبادئ الأساسية التي هي محل إجماع والملفات المرتبطة بتسيير الاقتصاد أو اختيار الأنظمة التي تجسد اختيارات المجتمع أو هي تقدم تصورات للإصلاحات الكبرى التي يجب أن تطول قطاعات مثل التعليم والصحة وغيرهما. هذه ملفات خلافية بالضرورة، نظرا لتباين الرؤى حولها، مما يحتم التشاور والبحث عن صيغ ترضي الأغلبية بما أنها سوف تحدد مستقبل الجميع.
فالمسارات التشاركية هي وحدها تقود الأطراف المتحاورة في نهاية المطاف إلى اتخاذ القرارات التي تضمن استقرار الأمم وتقدمها وليس القرارات الفردية والأحادية.
وليس من باب الاشتراطات الاعتباطية أن يطلب صندوق النقد الدولي من تونس، مثلا، تشريك النقابات وسائر الأطراف الاجتماعية في مناقشة الإصلاحات التي تحتاجها في نطاق اتفاقية للقرض للخروج من أزمتها المالية.
وليس من باب المزايدات السياسوية أن تشترط العديد من الأطراف الأجنبية المانحة مصادقة البرلمانات على اتفاقيات القروض وبرامج الإصلاحات ذات الانعكاسات العميقة على البلدان المعنية.
تلك الاشتراطات تشبه الضمانات التي تطلبها شركات التأمين عندما يطلب منها مواطن قرضا لبناء مسكن.
فقط من لا يحتاج قرضا بنكيا لبناء بيته يستطيع الاستغناء عن شروط شركات التأمين. أما المحتاج للقرض ليؤمن مسكنه وغذاءه فلا يمكنه أن يرفض الاشتراطات بحجة أن مطلبه سيادي.
تلك إكراهات الواقع التي أبرزتها تجربة الحكم في تونس منذ الاستقلال. لم يقبل نظاما بورقيبة وبن علي في أغلب الحالات بالحوار مع معارضيهما طريقا لتطوير التجربة السياسية في البلاد، ولكنهما اتبعا في معظم الحالات مقاربات براغماتية كانت تتكيف مع الظروف والمستجدات وتأخذ بعين الاعتبار إمكانات البلاد المحدودة.
وكلما زاغ أحد النظامين عن ذلك بالدخول في مغامرات غير محسوبة أو سقط في فخ الدغمائية والقرارات الخاطئة اضطر في نهاية المطاف إلى مراجعة حساباته. ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك تخلي نظام بورقيبة عن تجربته الاشتراكية المعروفة بـ”التعاضد” لما ظهرت نتائجها الكارثية على الاقتصاد والمجتمع. وفي حالات أخرى تعذرت المراجعات قبل فوات الأوان وتغلب الصلف على المرونة الفكرية اللازمة. فكانت الانهيارات. وللجميع في الماضي دروس. أو هكذا يفترض.
محاولة النخب فرض حواجز في النقاش والتفاوض هي قبل كل شيء انعكاس لضحالة الثقافة الديمقراطية وغياب جذورها التاريخية في المجتمعات. وقد يكون ذلك أحد أسباب تعثر مسار الانتقال الديمقراطي في تونس منذ 2011 وتبخر أوهام “الربيع العربي” بسرعة فيها وفي كافة أرجاء المنطقة.
◙ الخطوط الحمراء يرسمها الفاعلون السياسيون والمثقفون كبديل للنقاش، يتخيلون أن لمواقفهم قدسية تجعلها غير قابلة للمراجعة أو التحوير
فالديمقراطية لا يمكن أن تبنى على المعادلات الصفرية أو على استبعاد الاحتمال بأن يكون صاحب الرأي المخالف على صواب ولو جزئيا. الاعتقاد بوجود حقائق مطلقة، سواء المرتبطة بالدين أو بغيره من المسوغات الأيديولوجية، يشكل وهما مدمرا للمسارات السياسية.
ومحاولة فرض الخطوط الحمراء عند الاختلاف هو رفض لمبدأ الاختلاف ذاته. كما هو مؤشر على انقطاع أصحابها عن الآخرين وعن الواقع. ورفض هؤلاء للتفاعل مع مخالفيهم في الرأي أو حتى مجرد الإنصات إليهم لا يعني أنهم بالضرورة على حق. تدل التجارب السابقة في تونس وغيرها من البلدان أن بقاء الحكام في سدة السلطة أكثر من اللزوم وإحاطتهم لأنفسهم فقط بمن يشاركهم الرأي يجعلهم يتوهمون عكس ذلك إلى حين يتبخر الوهم دون سابق ميعاد.
لا تحتاج تونس اليوم إلى خطوط حمراء تزيد في أجواء الشحن والتوتر والصدام بقدر ما هي تحتاج إلى إعادة بناء جسور الثقة بين مختلف الأطراف الراغبة في المشاركة في البناء والمساهمة في رفع التحديات الكثيرة: أزمة اقتصادية تضع البلاد على باب الإفلاس، جفاف متواصل منذ أربع سنوات يهدد الناس بالعطش وأزمة سياسية تراوح مكانها بين الصراع على السلطة وعزوف المواطنين المحبطين عن الحياة العامة.
من الواضح أن الخطوط الحمراء لا ترسمها فقط حسابات المتنافسين على حلبة السياسة بل هي أيضا تعكس مشاعر الحقد والكراهية المتفاقمة.
ولكن الخطوط، مهما كانت ألوانها ومهما كان عمق الأحقاد التي ترسخها أو هي تعكسها، تحتاج في نهاية المطاف إلى أن تتقاطع وأن تلتقي يوم يكون مصير البلاد على المحك.
والظرف الحالي في تونس هو بالتأكيد أحد تلك الأيام.