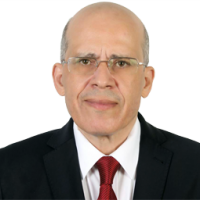تونس من منظور غربي: الصحيح والخطأ

يستضيف معهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة كينغس كوليدج في لندن الشهر القادم ندوة يناقش فيها أسباب “سوء فهم الغرب لتونس بشكل متكرر”.
ومن المقرر أن يقدم المداخلة الرئيسية في هذه الندوة الباحث والصحافي الفرنسي فرنسيس غيلس المتخصص في شؤون شمال أفريقيا.
منطلق الندوة مقال تحليلي لافت كان نشره الموقع الإلكتروني لمركز الشؤون الدولية في برشلونة منذ أشهر بإمضاء غيلس تقول فكرته الأساسية إنه “بعد أن أرغمت انتفاضة 2011 بن علي على مغادرة السلطة توهم العديد من الملاحظين الغربيين أن تونس كانت تبني نظاما ديمقراطيا بنجاح في حين كان جيرانها العرب يفشلون في ذلك”.
توجه صاحب المقال باللوم لهؤلاء الملاحظين الغربيين على خلفية مواقفهم من السياسات الاقتصادية للبلاد قبل عام 2011 وبعده. وقال إن “الأمر استغرق سنين عديدة قبل أن يكتشف هؤلاء أنهم أخطأوا التقدير”.
من الأكيد أن الحوار الذي سيدور بمناسبة هذه الندوة سوف يسلط الأضواء على جوانب مغمورة وأخرى مسكوت عنها حول المواقف الغربية تجاه تونس، وسوف يقدم طروحات خارج نطاق ما هو سائد من تحاليل منذ عقد ونيّف.
◙ تراجع الاهتمام الخارجي بتونس قد يشكل في حد ذاته عاملا إيجابيا، إذ هو يمنح التونسيين فرصة التركيز على حل مشاكلهم بأنفسهم، بغض النظر عن نظرة الغرب لبلادهم
لكنه من الهام أيضا ألاّ يسقط الحوار في القَدح المطلق في كل ما هو غربي. فمراكز البحوث الفرنسية والبريطانية والأميركية والألمانية وغيرها قدمت على مدى السنين مساهمات قيمة من أجل فهم أفضل لتونس وواقعها المتغير. والكثير من المفكرين والسياسيين الغربيين كانت لهم الجرأة للسباحة عكس التيار وإنارة سبل الباحثين عن حقيقة الأوضاع في تونس.
ولكن المنظور الغربي السائد حول تونس يحتاج بالضرورة إلى نقد موضوعي ونقاش بلا أفكار مسبقة.
يرى غيلس على وجه التحديد أن هناك ميلا استشرافيا لدى المحللين الغربيين يجعل هؤلاء “يُسقطون رؤيتهم للعالم على واقع بلدان تاريخها مختلف عن الواقع الغربي”.
كثيرا ما تمخضت عن الرؤية السياسية الغربية نزعة نحو جعل تونس “نموذجا” لشيء مّا وكان واقع تونس دوما أقوى من “النموذج” المسقط.
خلال العشريتين الأخيرتين للقرن الماضي وخاصة منذ التسعينات انخرط أصحاب القرار الأميركيون والأوروبيون في محاولات ترمي لدفع تونس كي تصبح “نموذجا” رائدا لتجربة ديمقراطية يريدها الغرب أن تتسع لاحقا لبقية البلدان العربية، وذلك بناء على ما كانت تراه العواصم الغربية من تقدم لتونس على صعيد المؤشرات التنموية وخاصة منها تلك المتعلقة بما تحقق في مجالات التربية والتعليم وحقوق المرأة واتساع الطبقة الوسطى.
ولكن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي لم يكن مقتنعا بلعب مثل ذلك الدور “الريادي”. وكانت دوما تساوره الريبة تجاه مشاريع الغرب من جهة وتجاه أيّ دعوات للإصلاح السياسي العميق من الداخل من جهة أخرى.
في نهاية المطاف بقيت فكرة “النموذج الرائد” معلقة إلى حين سقوط نظام بن علي في 2011. وعادت عندها الفكرة بقوة وأصبح المجال مفتوحا لبناء “انتقال ديمقراطي” حسب وصفات غربية – من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني القريبة منها – حددت الكثير من ملامح التجربة التونسية.

دارت الوصفات حول عناصر عدة من بينها تشكيل مجلس تأسيسي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وكتابة دستور جديد وإقامة نظام سياسي تتوزع فيه السلطات ويتم فيه تشريك كل القوى والأحزاب التي كانت مقصاة سابقا وخاصة منها الإسلاميين.
كان هناك حماس كبير لدى التونسيين لدخول مرحلة الديمقراطية والحريات. ولكن فهمهم لما يعنيه “الانتقال الديمقراطي” على وجه التحديد لم يكن واضحا، ولم يكن بالضرورة متطابقا منذ البداية مع الوصفات التي يقترحها الخارج. وكان ذلك بداية سوء التفاهم.
لو كان الملاحظون والخبراء الغربيون متابعين حقا للأوضاع في تونس ولتطور مزاج النخبة والشارع ما كانوا ليتفاجؤوا بمبادرة قيس سعيد في يوليو 2021 التي افتك بموجبها معظم السلطات وأنهى “المرحلة الانتقالية” السابقة. ما كانوا ليتفاجؤوا أيضا بالقبول الواسع لدى الرأي العام بهذه المبادرة. فقد كانت الشكوك المتزايدة حول المسار الديمقراطي واضحة للعيان منذ سنوات عديدة.
تظهر المعطيات الواردة في استطلاع البارومتر العربي لسنة 2022 على سبيل المثال التزايد التدريجي لهذه الشكوك من 2011 إلى 2021. تقول الأرقام إن نسبة التونسيين الذين كانوا يعتقدون أن “الأنظمة الديمقراطية ليست فعالة في الحفاظ على النظام والاستقرار” ارتفعت من 17 في المئة إلى 66 في المئة خلال تلك الفترة. وكذلك تزايدت بنفس النسق تقريبا الشكوك في قدرة الأنظمة الديمقراطية على تحسين الوضع الاقتصادي. كما ارتفعت نسبة تفضيل الأغلبية “لزعماء أقوياء” من أجل “تحقيق النتائج” المطلوبة.
لكن من الهام الإشارة أولا إلى أنه رغم هذه الشكوك بقيت هناك قناعة لدى أغلبية التونسيين بأن الديمقراطية “أفضل من أي نظام آخر”، مما يعني أن التونسيين ظلوا متمسكين بالديمقراطية ولو فشلت الوصفات التي حددها الغرب أو ساندها. وسيكون من باب الأخطاء الفادحة مستقبلا أن يعتقد أيّ من الفاعلين السياسيين في تونس أن التونسيين مستعدون للتخلي عن مبدأ الخيار الديمقراطي.
ومن الهام أيضا الإشارة إلى أن التونسيين في شكوكهم المتزايدة بخصوص قدرة الديمقراطية على حل مشاكلهم لم يكونوا مختلفين كثيرا عن بقية الشعوب العربية، وإن كان البارومتر العربي أظهر أن التونسيين – بمعية العراقيين والليبيين – كانوا من أكثر المجتمعات العربية تشكيكا في نجاعة الأنظمة الديمقراطية. وليس من باب الصدفة أن تشترك مجتمعات هذه البلدان الثلاثة في الشكوى من سوء التصرف الاقتصادي واستشراء الفساد والفوضى.
وفي الواقع فإن التشكيك في نجاعة الأنظمة الديمقراطية وقدرتها على حل مشاكل الناس ليست ظاهرة تونسية أو عربية فقط، بل ظاهرة عالمية تثير انشغال الجميع.
إضافة إلى كل ذلك لم ينتبه الغرب في إلحاحه على “تشريك كل التيارات السياسية” إلى أخطاء الإسلاميين في السلطة وهي أخطاء جعلت القواعد الشعبية لهؤلاء تنحسر وقدرتهم على التأثير في الأحداث تتقلص إلى حد أن مشاركتهم في الحياة السياسية أصبحت هامشية بشكل يبدو أنه فاجأ الغرب إلى حد كبير.
يرى غيلس في هذا الصدد أن على الأوروبيين أن “يتخلصوا في أسرع وقت من معتقدهم بأن التوجه الإسلامي هو التوجه الطبيعي في المنطقة”.
أما الجانب الثاني من المشهد التونسي الذي لم يوفّق الغرب في متابعته وتحليله بشكل ملائم فهو الجانب الاقتصادي والاجتماعي.
يرى غيلس أن المؤسسات المالية العالمية والقوى الغربية الكبرى أخطأت في تمسكها “بالعقيدة النيوليبرالية” في تونس رغم إرهاصات فشلها قبل 2011 في تجاوز مناطق الخلل الاجتماعية. أما بعد سقوط بن علي فقد كانت النخبة الحاكمة، حسب غيلس، مهتمة فقط بالبقاء في الحكم وكسب المنافع لنفسها.
◙ كثيرا ما تمخضت عن الرؤية السياسية الغربية نزعة نحو جعل تونس "نموذجا" لشيء مّا وكان واقع تونس دوما أقوى من “النموذج” المسقط
حاولت المؤسسات المالية الكبرى تقديم قراءات جديدة للأوضاع قبل 2011، ولكن مراجعاتها جاءت بعد فوات الأوان ولم تساعد هذه المؤسسات على ترميم مصداقيتها.
أما بعد 2011 فقد كان التوجه السائد في الغرب مدفوعا بالرغبة الجامحة في تشجيع تجربة “الانتقال الديمقراطي” بغض النظر عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم العجز المالي وزيادة نسبة التداين الداخلي والخارجي وهي عوامل كان من الواضح أنها تهدد التجربة الديمقراطية في أسسها.
تساهل معظم الخبراء والمؤثرين السياسيين مع ظاهرة إقصاء النخب السابقة من السلطة والإدارات الحكومية، وذلك على اعتبار أن هذه النخب كانت على علاقة بنظام بن علي. أضرت سياسة الإقصاء والملاحقة بمصلحة البلاد لأن هذه النخب كانت تشكل العمود الفقري للإدارات الحكومية وتختزن ذاكرتها ولعبت دورا حيويا في الحفاظ على استقرار الدولة رغم كل المطبات بعد 2011.
اختارت عديد العواصم الغربية ومنظمات المجتمع المدني التي تمولها أو هي قريبة منها أن يكون موقعها في المعسكر المناوئ أو المتحفظ على مبدأ المصالحة الوطنية الشاملة. وساهم ذلك في إحباط الآمال التي كانت معلقة على إمكانية طي صفحة الماضي ومشاركة كل الأجيال السياسية في بناء مستقبل أفضل. وأضاعت البلاد بذلك فرصة للقطع نهائيا مع إرثها الراسخ في السياسات الانتقامية.
مازالت تونس اليوم تواجه الكثير من التحديات الجدية. ولا تزال هناك الكثير من التساؤلات حول مواقف الغرب وسياساته تجاه تونس. وأهم تطور في هذه المواقف قد يكون ابتعاد الأضواء عن البلاد مع اهتمام الغرب بالحرب في أوكرانيا وتنافسه مع روسيا والصين على التأثير في العالم.
ولكن تراجع الاهتمام الخارجي بتونس قد يشكل في حد ذاته عاملا إيجابيا، إذ هو يمنح التونسيين فرصة التركيز على حل مشاكلهم بأنفسهم، بغض النظر عن نظرة الغرب لبلادهم وما قد تراه واشنطن والعواصم الغربية متلائما ومصالحها.