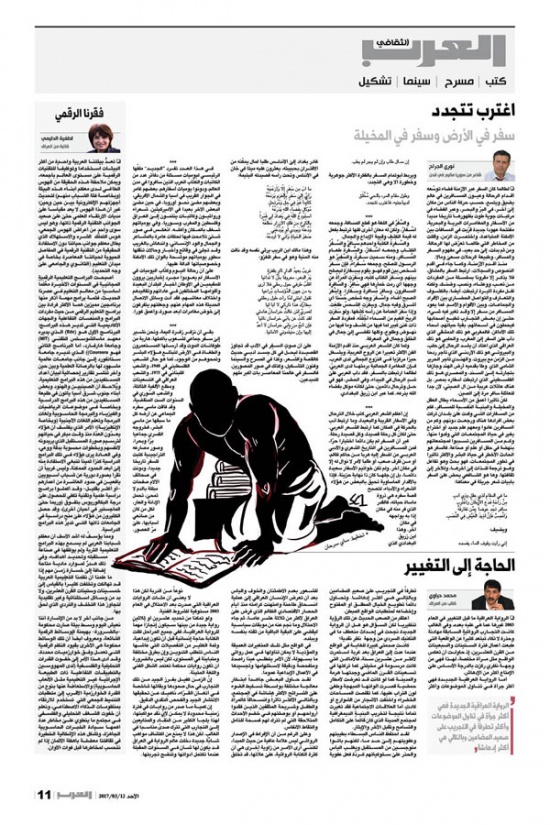بين الشخصية والموضوعية
بدأت مقالة بعبارة “لم أحب رواية كذا”، فكتب لي قارئ “أنت غير موضوعي، قل هذا رأيك الشخصي”.
كل رأي هو شخصي بالضرورة. الموضوعية أن تبرر رأيك بشكل قابل للنقاش. إن لم تفعل فإنه رأي خصوصي، لا ترغب في مناقشته مع أحد.
المخيف في الخلط بين الشخصي والخصوصي هو أن التميز يبدأ دائما من الشخصي، بمعنى الذاتي. أن يبدأ المرء التفكير من عندياته ومعطياته مندفعا من إحساسه الخاص ثم الاستعانة بالناجز والمتعارف عليه، هنا ثمة فرص لإضافة ولو ضئيلة تفتح الآفاق وتوسع الرؤى.
الموضوعية ليست عكس الشخصية أو الذاتية. وليست تحررا من علاقاتك مع الأشياء أو تجاهلا لمشاعرك تجاهها، أو التعامل معها بلا موقف واضح منها.
يعتقد البعض أن “الانطباعات الشخصية” حول الأعمال الإبداعية لا ترقى لأن تكون رأيا موضوعيا. في الحقيقة يستحيل في الأصل التواضع حول معنى للموضوعية في الرأي إلا أن تكون تبرير هذا الرأي بشكل يسمح بمناقشته. الموضوعية أن تجتهد في تبرير موقفك وتحليل دوافعك واستعراض أسس مشاعرك بشكل يسمح بالتعاطي معها. بهذا يبدأ الحوار.
ميزة البشر الكبرى قدرتهم على تبرير أفعالهم وأقوالهم ومواقفهم وشرح دوافعهم، هذه مقدرة خاصة بالإنسان يمكنه استغلالها أو تجاهلها، ولكن الفارق بين الحالين كبير.
إذا اتفقنا على أن الآداب والفنون أشكال تعبيرية تتوسل بالجمال، فإن السعي لاكتشاف سرّ هذا الجمال كان المحرك لكل أشكال النقد بوصفه محاولات لصياغة انطباعات تجاه أشكال الآداب والفنون.
البداية كانت في الرومانسية التي رأت الأدب تعبيرا عن ذات الأديب أو شخصيته، فاهتم أصحاب الرؤية العاطفية بالذات، واهتم أصحاب الرؤية النفسية بالشخصية..، ثم نشأت الواقعية وتفرّعت منها التاريخية والاجتماعية والمادية والجدلية..، ومنذ ذلك الحين والمدارس تتوالى إلى حد اضطر البعض لوصف الأمر بـ”فوضى المدارس النقدية”.
نخرج من الفوضى بالتمسك بقاعدة؛ النقد هو محاولة للإجابة عن سؤال الجمال. والجمال أمر شديد الصلة بالذائقة، والذائقة أمر شديد الذاتية، تختلف باختلاف الثقافة (وهي مجمل معارف الكائن الحاكمة لنظرته للكون وكائناته)، فالأساس إذن في كل نقد هو الرغبة في التعبير عن إحساس الفرد بما يشعر به من جمال أو عدم جمال في المنتّج.
هذه المحاولات شئنا أم أبينا مرهونة بثقافة ودوافع أصحابها، ومهما تعددت الاقتراحات يظل سؤال الجمال ظمآنا للمزيد. وقد يكون اجتهاد قارئ مثقف في التعبير عن ذائقته تجاه ما يقرأ أهم من كومة قراءات نقدية محكومة بأطر مدرسية.
الرؤية من داخل مدرسة بعينها تشبه ما يفعله المطبعجية حين يطلب الزبون قص الأوراق على شكل دائرة مثقوبة ولها زائدة على شكل مثلث؛ لا يعود الجمال هدفا، ولا يجوز لأحدهم أن يُبدع أو يبتكر، فالمعيار محدد في مطابقة نموذج الزبون.
هكذا يبدو النقد “الخاضع” لمدرسة، في مقابل النقد “النابع” عن ذائقة تجتهد في تفسير الجمال مستعينة بثقافتها ومعارفها، التي يَحسُن أن تشمل فيما تشمل دراية جيدة بالمدارس النقدية.
يمكن لجملة صغيرة أن تشكل إضافة للنماذج، وأن تكسر نمطية التعامل، وأن تفتح أفقا جديدا.
نموذجان لممارسي النقد الأدبي، الناقد (وظيفة)، و”صاحب العقل الناقد”، بينهما ما بين الصنايعي والفنان. الأول موظف عند مدارس النقد، والآخر عقل ناقد يمثل الدور الذي يجب أن يلعبه المثقف في مجتمعه، يثري النقاش، ينبّه ويشير ويثير العقول للتفكير والبحث.
عندما تقرأ مقالا نقديا للأخير تجده متحررا من الأطر المدرسية، وإن استفاد منها. إنه يكتب كما يفكر، لا يطبق أفكار الآخرين. يسعى للتعبير عن الأسباب التي جعلته يرى عملا ما مهما أو جميلا أو بديعا، وسواء اتفقت أو اختلفت مع أسبابه، فإنه يعرضها بشكل يسمح بمناقشتها أو بتجاوزها إلى آفاق أرحب في فضاءات الفكر والثقافة. ناقشه ولا ترفع في وجهه التهمة الجاهزة: عدم الموضوعية.
شاعر من مصر مقيم في الإمارات