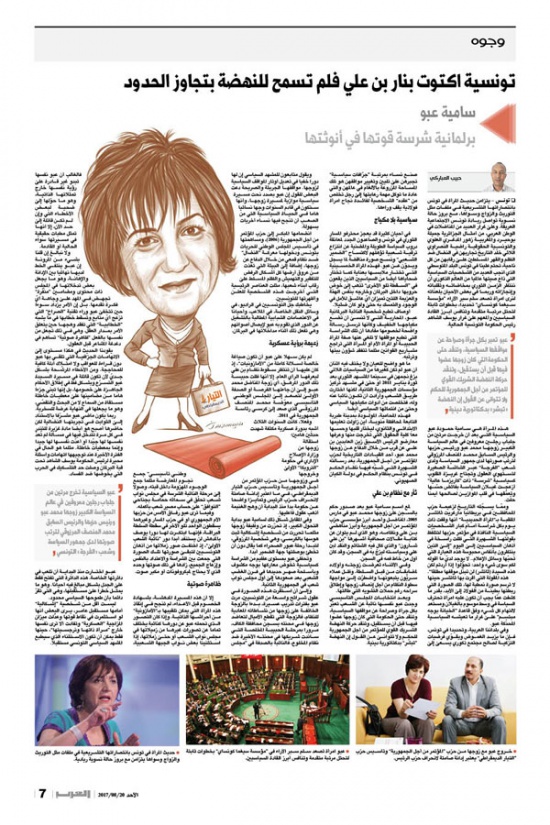باولو تشامبي: ليوناردو فيبوناتشي هو من أطلق جناحي العالم جهة المستقبل

فلورانسا (إيطاليا) – يُعيد باولو تشامبي صياغة الآصرة الأولى لشخصيته مع بجاية الجزائرية من حيث أجواؤها وحياتها، وبالذات آصرته الفارقة مع المعلّم الأول الذي أنار له الطريق. وكان ليوناردو فيبوناتشي قد انطلق من مدينته بيزا، (مدينة البرج المائل) ممتثلاً لطلب من والده الذي كان يعمل هناك، وبعد وصوله إلى هناك بفترة قصيرة تعرّف على الأرقام العربية وعاد بها إلى مدينته بيزا.
وحين يتندّر الإيطاليون حول من أُصيب بهلوسةٌ ذهنية أو اضطراب في التفكير يصفونه بكون «ينطق بالأرقام!»، لكنّ ليوناردو فيبوناتشي شَرَعَ بوّابات للعلم والحضارة والتقدّم، عندما نطق بالأرقام العربية ووهبها إلى إيطاليا وأوروبا. يبتسم باولو تشامبي للمقاربة الفارقة ويقول بأن الكتاب ولد لديه من الحاجة للبحث في حياة شخصية كان يُلاحقها منذ زمن طويل حيث يقول “كانت فيّ رغبة عميقة للتعريف بشخصية هي ليوناردو فيبوناتشي الذي كان يستحق أن يتعرّف القرّاء على ما قدّمه لنا وللمستقبل”، ويُضيف “كان فيبوناتشي الحلقة الأهم في سلسلة وصول الأرقام وعلوم الرياضيات العربية إلى أوروبا. وبما أنّه فعل ذلك في زمان تميّز بالمواجهة والتصادم والتوتّر، فقد كان في ذلك رجل سلام ورحّالة كبيراً وشخصية تُعلّم كيفية الاستزادة من المعارف العلمية الهامة أينما حلّت، كما فعل هو في استزادته من حقل الرياضيات الذي كان عامرا في الضفّة الأخرى من المتوسط، وحملها معه إلى أوروبا المسيحية التي كانت تتميّز بالتخلّف شبه المطلق على صعيد هذه الحقول والدراسات”.
يُركّز باولو تشامبى على أهميّة عنصر الشباب في نقل المعرفة فقد “تمكّن فيبوناتشي من مسعاه هذا من خلال رحلته إلى ضفة جنوب المتوسّط. كان حينها في مقتبل الشباب ولمّا يزل بعدُ فتى يافعاً حين استدعاه والده إلى بجاية في الجزائر، حيث كان يعمل قانونياً لعدد من التجار الإيطاليين في المدينة الجزائرية. استدعاه الوالد وأسكنه في فندق في المدينة لأنّه أدرك أنّ بإمكان ابنه أن يتعلّم الكثير من ذلك الواقع الحيّ ووفيرِ المعارف، وهي المعارف التي افتقدتها أوروبا في ذلك العصر. كان الوالد واثقاً أن بإمكان ليوناردو الشاب تعلّم فنون الحساب ليَفِيدَ منها في التجارة التي كانت مهنة عائلته”.
كان لمّاحاً ذلك القانوني الذي اكتشف نبع المعرفة في بجاية الجزائرية “بفراسة الأب القادر على قراءة مقدرات الابن”، يقول باولو تشامبي “لمس ذلك الرجل بيديه ما كان قائماً في الجنوب، وما كانت تُعانيه أوروبا في تلك المرحلة بسبب ممارسة عمليات الحساب بالأصابع ولاستخدام الـ’ آباكوس” في الحسابات التجارية”.
ليوناردو فيبوناتشي عندما سافر إلى بجاية، في جنوب المتوسط، لم يكن إلا فتى يافعاً، وربما كان أيضاً في نفس عمر الشبيبة الذين يعبرون المتوسط في هذه الأيام، من الجنوب إلى الشمال، وربّما جاء بعضهم من مدينة بجاية نفسها للبحث عما يفتح لهم كوة في عالم أفضل
كان “الآباكوس” اختراعاً شهيراً وهامّاً، لكنه كان أيضاً بمقدرات محدودة لمواجهة الحسابات الكبيرة، “وكان الأوروبيون يستخدمون الحروف اللاتينية للإشارة إلى الأرقام”. يقول الكاتب باولو تشامبي “أبإمكانك أن تتصوّر مقدار الصعوبات التي كانوا يواجهونها في ذلك خلال عمليات الجمع والضرب للأرقام!”.
وهنا بالفعل كانت تكمن فراسة فيبوناتشي الأب الذي ربط ما بين تلك المعارف ومقدرة ابنه في التعلّم والاستزادة، “فقد عثر على عالم فسيح يُشْرِع أبوابه أمام ابنه، وذلك هو عالم التجارة والتبادل الاقتصادي وتبادل العملات. كان الأب واثقاً من مقدرة ابنه ونباهته في النهل من تلك المعارف ومواجهتها مع المصاعب التي كانت شاخصة أمامه في إيطاليا وأوروبا بشكل عام بسبب التباينات في أدوات التعامل التجاري واختلاف العملات والمقاييس من مدينة إلى أخرى”.
وصل فيبوناتشي الفتى إلى هذه المدينة الجزائرية بعد رحلة بحرية طويلة استغرقت ما يربو على ثلاثة شهور. وبمجرّد وصوله إلى هناك أوكله والده في الحال إلى معلّم للرياضيات والحساب في مدينة بجاية “فتولّه الفتى ليوناردو في الحال بالمعارف الجديدة التي كان المعلّم الجزائري يضخّها إليه”، ويقول باولو تشامبي “كانت تلك معارف جديدة عليه بالمطلق، هو القادم من أوروبا. بإمكاني الآن أن أتخيّل كيف التمعت عينا ليوناردو واتّقد ذهنه عندما اختطّ المعلّم لتلميذه الأوروبي الشاب الأرقام العربية على بساط الرمل، وكيف التقط هو في الحال مغزى وكنه تلك الرموز التي كانت حتى تلك اللحظة عبارة عن مجرّد ألغاز وأُحجية”.
ومن بين تلك الأحجيات رقم مُحدّد غيّر جوهرياً عالم الرياضيات والتجارة والعلوم وذلك هو الرقم صفر. هذا الرقم، والذي لم يكن مُتداولاً في الاستخدام الغربي للحساب الرياضي رغم ما يختزن من أهميّة كما ظهر بعد دخول الرقم العربي إلى الغرب.
يقول الكاتب باولو تشامبي “اليوم، وبعد استيعاب العلم لكل مكتنزات هذا الحقل، تبدو جميع الأمور سهلة، وبات من البديهي أنْ تكون لدينا الأرقام كما نعرفها في حياتنا اليومية، إلاّ أن بلوغ هذه النتيجة كان عملاً جبّاراً تطلّب قروناً عديدة”، ويُضيف “تستند الثورة التي أحدثتها الأرقام العربية، جوهرياً، على عدّة معطيات من بينها أنَّ أيّ رقمٍ من الأرقام يمكن أن يُؤخَّر أو يُقدَّم عبر تراتب وتركيب عشرة رموز. أما المعطى الثاني فهو أنّ ما يمنح القيمة إلى الرقم هو موقعه داخل الرقم المركّب، فلأيّ رقم من الأرقام قيمة ووزن معيّنان قياساً إلى الموقع الذي يحتله في التركيبة المقروءة للرقم النهائي، فلرقم اثنان، مثلاً، قيمة ووزن معّينان إذا ما ورد في خانة العشرات، وهما غير القيمة والوزن إذا ما ورد في خانة المئات، وهكذا دواليك. وحتى يكون كل هذا فاعلاً فإن هناك ثمة حاجةً إلى شيء استثنائي بشكل حقيقي، وذلك هو الرقم صفر. فالصفر الذي يبدو الآن في الظاهر أمراً اعتيادياً وبديهياً فقد كان في الحقيقة إنجازاً عظيماً. يكفي أن نعلم بأن الإغريق الذين كانوا أصحاب معارف وعلوم استثنائية في الرياضيات لم يتمكّنوا من استنباط الرقم صفر”.
وقد تمكّن العرب من استنباط الصفر “وحقّقوا بذلك إنجازاً استثنائيا”، يقول تشامبي “وتنبع هذه الاستثنائيّة من طبيعة رقم الصفر نفسه، والمثير للدهشة فالصفر يمثّل اللاشيء، لكنّه يساوي جميع الأرقام الأخرى في الأهميّة. إنّه الفراغ-الصفر، وليس صدفة أن العرب أسموا الرقم صفراً، فهو الذي يمنح القيمة والنوعية والمغزى إلى الأرقام الأخرى. كان لا بدّ من شخصيات مثل ليوناردو فيبوناتشي ليحملوا هذا الإنجاز إلى العالم الذي نُطلق عليه اليوم اسم أوروبا والغرب”.
وإذا ما استعرضنا تواريخ الشعوب ورأينا ما عاناه العلماء من مصاعب وآلام وعواقب مأساوية، فإن بإمكاننا أن نتصوّر مقدار المصاعب التي واجهها ليوناردو فيبوناتشي وهو يعود إلى بيزا ليُزلزل القناعات التي كانت راسخة، بالضبط كما زلزل غاليلِيو غالِيلَيْ بعده ببضعة قرون قناعات الكنيسة الراسخة بكون الأرض مركز الكون.
|
يقول باولو تشامبي “ذلك صحيح ومُثبّت تاريخياً”، ويصيف “فالبرغم مما كان يتمتّع به فيبوناتشي من سمعة ومعرفة وعلوم فقد احتاج الأمر قروناً، ولم يكن إنجازا استثنائيا من هذا المعيار كافياً لإقناع أوروبا بأنْ تبدأ في الحال باستخدام الرقم العربي. كان هناك الكثير من الريبة والشك إزاء هذا القادم الجديد. أذكر لك مثالاً من فلورانسا، الذي كان يسود فيها فن تبادل العملات، أي ما يعني المجموعات الكبيرة والثريّة التي كانت تضمّ أصحاب البنوك وأصحاب الأموال الذين يقيمون تجارتهم مع أرجاء العالم آنذاك، وكانت عملة فلورانسا ‘الفيورينو’ بمثابة ما هو الدولار الأميركي اليوم، حسناً، كان فن تبادل العملات حتى عام 1399، أي ما بعد قرنين من عودة فيبوناتشي إلى إيطاليا، يواجه مصاعب حقيقية في التعامل مع الأرقام العربية ويُفضّل استخدام الأرقام الرومانية المكتوبة بالحروف اللاتينية”.
ولم يكن ليوناردو فيبوناتشي عندما سافر إلى بجاية، في جنوب المتوسّط، إلاّ فتى يافعاً، وربّما كان أيضاً في نفس عمر الشبيبة الذين يعبرون المتوسّط في هذه الأيام، من الجنوب إلى الشمال، وربّما جاء بعضهم من مدينة بجاية نفسها للبحث عمّا يفتح لهم كوّة في عالم أفضل. وإذا ما واجهنا بين حالتي الهجرة والرحيل فإن هناك إمكانية أن تختزن موجات المهاجرين الحاليّة على أصحاب إمكانيات وطاقات لم تُكتشف، إذْ يواصل الغرب في اعتبارهم مجرّد مهاجرين بائسين، وقضيّة أمنية، يقول تشامبي “أنا رأيت في ليوناردو فيبوناتشي على الدوام جسراً للسلام وللحوار عبر المعرفة والعلم”، ويضيف “فعل ذلك رغم صعوبة وعسر الحوار في تلك المرحلة، فقد كان وضع المتوسّط في تلك الأيام عسيراً بسبب الحروب والصراعات الدائرة على أطرافه، ومنها الحروب الصليبيّة. ورغم وجود من كانوا يسعون إلى تشييد الجدران الفعلية والمفترضة عبر إثارة النعرات والصراعات بين الحضارات، فمساعي بث الجهل وإثارة الصراعات التي كانت سائدة آنذاك ليست مختلفة إطلاقاً عمّا تسعى إليه بعض القوى والأطراف السياسية في يومنا هذا، لكن، ورغم كل شيء فقد كان هناك رجال تنبض قلوبهم بحب السلام وبالرغبة الجارفة في ردم الخلافات ودرء الصراعات. كانت لدى هؤلاء الناس القدرة على الحوار قبل كل شيء. وليس فيبوناتشي إلاّ واحد منهم. بإمكاننا أن نستعيد ذكرى فريدريك الثاني والقديس فرانسيس أو الخليفة الكامل الذي استقبل القدّيس فرانسيس في أرضه”.
وبالفعل، إذا ما أمعنّا في التفكير في العمق فإن ليوناردو فيبوناتشي كان بدوره وبشكل من الأشكال مهاجراً بحث عمّا هو مختلف ومُثرٍ خارج بلاده بالتأكيد”، ويقول باولو تشامبي “نعم لقد رحل ليوناردو فيبوناتشي إلى الجانب الآخر من المتوسّط، ليس للتعرّف فحسب، (وهو لم يقم بسفرات أخرى من أجله بعد سفرته الأولى)، بل أيضاً لتعلّم ما كان سيُفيده في حياته العملية. لقد واصل السفر والرحيل سواء في الجزائر أو في الدول العربية الأخرى، وفي الدول الأوروبية، لغرض تجميع المعارف والتوليف فيما بينها”.
ويُعرب باولو تشامبي عن قناعته “بأنّ بين الواصلين الجدد إلى أوروبا من جنوب المتوسّط ثمّة الكثيرون الذين يحملون قيماً ومعارف وخبرات ورؤى شبيهة بما كان يحمله فيبوناتشي في زمانه. ربّما لم يكونوا نوابغ في الرياضيات، لكن لدى الكثيرين منهم مواهب بالإمكان استغلالها وجعلها تُثمر. عندما تُشيّد الجدران العازلة وعندما تُدفع هذه الطاقات إلى الغرق في بحور الحدود لن يكون بمقدور أوروبا والغرب الاستفادة من طاقات القادمين الجُدد. بالحدود والجدران التي تُقام لن نزيد من أرقام الغرقى فحسب بل نحول دون الاستفادة من القادمين الجدُد ومن طاقاتهم. الحكومات التي تعجز عن استثمار هذه الطاقات الكامنة تُفقد بلدانها الكثير. خذْ إيـطاليا مـثالاً، فــنحن كـل عـام نفـقـد الآلاف من الطـاقـات والخـبرات العلـمية والعملية بفعل هجرة الأدمـغة إلى الـخارج، وبإمـكان وصول المـهاجرين التـعويض عـن جـزءٍ ولو يـسـير مـمّا نفـقد من مواطـنينا”.
قد يتصوّر القارئ بأنّ الكاتب باولو تشامبي أكمل الدراسة العلمية وبأنّه على آصرة خاصة مع علوم الرياضيات في صباه وبلوغه، لكن سحنته تحمّر خجلاً ويقول “أوه، على العكس. كانت دراستي أدبيّة وأكملت الآداب في الجامعة. لقد كنت كارثيّاً في الرياضيّات. أعطني أيّ نص في الإغريقية واللاتينية أو من الكوميديا الإلهية بلغة دانتي آليغييري، فسأبرع فيه، لكن لا تضعني أمام أيّ معادلة رياضية. لقد كان ذلك الأمر بالنسبة إليّ مأساة على الدوام. ربّما أحتاج أنا أيضاً إلى معلّمي العربي ليفكّ لي خط الحساب والرياضيات…”.
صدر الكتاب عن دار النشر الايطالية “مُورسيا” ويقع في 180 صفحة من القطع المتوسّط، ويأمل الكاتب باولو تشامبي في أن يتمكن القارئ العربي أيضاً من الاطلاع على حياة رجل قـادَتْهُ فراسته وحـبّه للعـلم وانـفتاحه على الثقافات الأخرى إلى تغيير العالم ودفع مسار البشرية إلى الأمـام قـروناً.
كاتب من العراق