الوباء ومجازاته المرعبة

الوباء، ليس مجرد مرض معد، مفض إلى الهلاك، هو أساسا ذلك الرهاب الناجم عن تفاقمه وانتشاره، وهو صور الهروب الكبير منه، وما يقترن بها من تبدّل في السلوك والعواطف والقيم، الكفّ عن التواصل الجسدي، الزهد في السفر، التوقف عن التقاسم والاشتراك، تحوّل المدن إلى هياكل خرساء وشوارع فارغة، ونأي الجميع عن الجميع، لم يكن ما يطالعنا يوميا من أخبار عن خارطة انتشار الوباء المستحدث طارئا، الطارئ هو الصور التي نراها عبر الشاشات للأرقام المتفاقمة، والموت المتنامي عبر الضفاف المتباعدة، والتوق الفطري لهذا الهلاك القصيّ إلى الاقتراب من مداراتنا الأليفة.
منذ الصفحات الأولى من حكايات: “الديكامرون” للكاتب الإيطالي بوكاشيو، يشرع السارد في وصف أثر الطاعون الأسود على إيطاليا ومدينة “فلورنسا”، يمكن أن نعتبر هذه التخاييل، المشبّهة دوما بألف ليلة وليلة، قد كتبت، بمعنى ما، لنسيان الوباء، والشفاء من ذكرياته المرزئة، ولمجابهته أيضا؛ هو النص الأكثر تمثيلا للعنة الوباء الأسطوري الذي اجتاح أوروبا أواسط القرن الرابع عشر، فيه نكتشف التشوه الداخلي للعواطف الإنسانية، الموازية لتآكل الأجساد وفنائها؛ تنكُّر الآباء للأبناء، وهجر الأزواج لبعضهم، وترك الفروع للأصول في المحاجز، وهروب الإخوة والأقارب والأصدقاء… قساوة لا تكشف عن نفسها بما هي تحجر للمشاعر، وإنما بوصفها خوفا مجنونا من الوقوع في دائرة العدوى، والسعي إلى الانعتاق من وهدة القدر الأسود.
حوّل الوباء سكان مدن إلى أشباح، وعمم الموت اليومي، ونذر أسماء حواضر لامعة إلى مجازات للشؤم، من القسطنطينية إلى يافا ومن ميلانو إلى مارسيليا ومن أثينا إلى إشبيلية، ومن فاس إلى لندن…، كانت الأعداد تفقد جبلة البشر لتتحوّل إلى مجرد جثث مؤجلة.
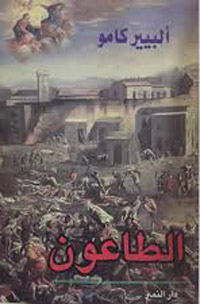
في لوحات وروايات يخلّد الوباء بقدر كبير من الرهبة وانعدام الفهم، وبدفقات باهرة من الإيمان والكفر معا، كيف يدبر الإله لعبيده هذا المصير؟ إن كان عقابا فلم يحصد المؤمنين والعاصين والمجدفين؟ البسطاء والملوك والجهلة والأطباء والكتّاب والفلاسفة والفنانين؟ ولم يكن النحات خوان مارتينيز مونتانيس وحده من خلّده الطاعون جنبا إلى جنب مع منحوتاته العظيمة، لكنه كان الأشد دلالة في ترحيل الجسد لحساب الحجر في مطحنة الوباء. آلاف التخاييل بعدها سيسكنها السؤال الحائر عن السبب والمعنى.
في لوحة للرسام الفلامنكي بيتر بروغيل، عن الطاعون الأسود تطالعنا عربة جماجم وعظام بشرية يجرّها جواد عليل يقوده هيكل عظمي، وفي الرصيف تطل الهياكل البشرية ملتفعة بالبياض، تراقب موكب الرحيل الجنائزي، مومياوات ناهضة من توابيتها لتراقب كنس المدينة من اليباب الجسداني المترحل، في اللوحة موت مرعوب مع صليب وغراب، ووجه امرأة مسرنم يرنو للفاجعة، ثم السواد وطبقاته الداكنة المظللة للأحمر الباهت.
كانت اللوحة من أكثر الأعمال حدّة في تمثيل الوباء المكتسح للناس والمحيط والمدن، ستتلوها مئات الأعمال الفنية عن المدن المنكوبة بالطاعون لفنانين معروفين وآخرين مجهولين، لكن أغلبها ستحمل عنوان “الطاعون”، مخلدة الفاجعة ومتسائلة وراثية، وناقلة إحساس الرعب الجهنمي؛ لكن ربما كانت لوحات الفنان الفرنسي ميشيل سير عن الطاعون في مارسيليا هي أكثر اللوحات التي ربطت الوباء بمدن بذاتها، على نحو شبيه ما قامت به رواية “الطاعون” لألبير كامو مع مدينة وهران.
في رواية ألبير كامو، نلاحق أحداث التلاشي منذ الصفحات الأولى، لجرذان تنفق فجأة، فرادى ثم جماعات، قبل أن تشرع مصالح البلدية في تجميع الآلاف منها صباح كل يوم لتحرق، إلى أن تتلاحق ترنحات المرضى الزائرين لعيادة الدكتور برنار ريو؛ وفي موجة الموت المحموم المطبق على مدينة وهران المستكينة لإيقاع العمل اليومي، يبرز القدر والفطرة الإنسانية والرعب الخارق من الموت الهادر المتدفق من الحنايا، تبدو الرواية عن “ما وراء” الوباء و”ما بعده” وما يسكن في أحشائه، ما يفرزه من تشوّهات داخلية، وما يشيعه من استسلام للقدرية والهروب من مواجهة الحقيقة، واعتبار الوباء عابرا لا محالة.
في فقرة من الرواية يسطر السارد ما يلي “يقول المرء لنفسه إن البلية غير حقيقية، إنها حلم مزعج سيمر. ولكنه لا يمر دائما، ومن حلم مزعج إلى حلم مزعج، يمر الناس أنفسهم، والإنسانيون بالدرجة الأولى، لأنهم لم يأخذوا حيطتهم… وكانوا يفكرون أن كل شيء ما برح ممكنا في نظرهم، وهذا ما يفرض أن البلايا كانت مستحيلة، ولهذا فقد كانوا يتابعون أعمالهم ويستعدون للأسفار، أنى لهم أن يفكروا بالوباء الذي يلغي المستقبل… لقد كانوا يعتقدون أنهم أحرار، ولن يكون أحد حرا ما دامت ثمة بلايا”.
في الرواية نستعيد ذلك النزوع الدائم لاستبعاد الفاجعة وتكذيبها، قبل السقوط في الموت الداخلي قرين رهاب العدوى، فيها يتجلّى الإحساس بالموت بما هو قدر يمكن خداعه بالجفاء والخسة، وفيها نعيش تخييليا ما يحاصرنا اليوم عبر الشاشات، أي الإحساس بان الوباء قادم لكنه سيخطئنا لا محالة، ولا جدوى من اعتبار الحياة قد زاغت عن طبيعتها في تركيب الموت على سكة العمر الفردي المنتقى.




























