الناقدة نادية هناوي تُسقط ظاهرة التجييل في الشعر العراقي
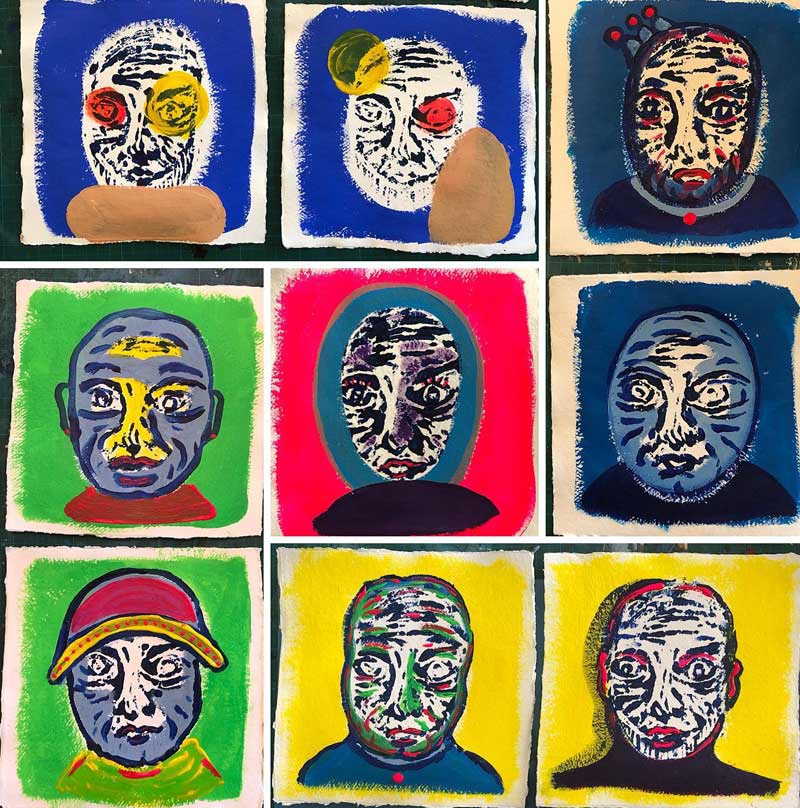
بغداد- تناقش الناقدة العراقية الدكتورة نادية هناوي في كتابها “الوهم والحقيقة في تجييل الشعر العراقي”، مقولة “التجييل العقْدي” التي شاعت في النقد العراقي منذ ستينات القرن العشرين، فكشفت ملابساتها ومدى صحة أن الأجيال الشعرية تتوالد كل عشر سنوات.
وترى هناوي في الكتاب، الصادر حديثا عن مؤسسة أبجد للترجمة والنشر والتوزيع، أن “التجييل العقْدي” ظاهرة حصلت كردة فعل على الهزة الكبيرة التي أحدثها رواد حركة الشعر الحر، ومن دلائل قوة هذه الحركة استمرار بعض الشعراء في القول بالتجييل العقْدي.
وتوضح أن ظاهرة التجييل بدأت بسيطة في الستينات، ثم أخذت تغزو المشهد الأدبي العراقي حتى بان أثرها في ثمانينات القرن العشرين والعقْدين الماضيين من القرن الحادي والعشرين، مشيرة إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى إعادة مراجعة؛ نظرا إلى خطورة هذه الظاهرة في فهم التجارب الأدبية وتقييمها؛ فبسببها صارت المقايسة العقْدية طبيعية ومعتادة في تجييل القصاصين والروائيين والشعراء.

ويتألف الكتاب من أربعة فصول مع مقدمة وتمهيد نظري وخاتمة، تتوزع على 402 صفحة، وتتصدى فصوله لظاهرة التجييل العقْدي التي استشرت “حتى صار معها الحلم حقيقة والوهم يقينا، وغدت التسمية كأنها اصطلاح لا غبار عليه، طغى وتعملق حتى صار حجمه كظاهرة أكبر من حجم الشعر كإبداع”، بحسب تعبير هناوي التي ترى أن أرضية هذا التجييل غدت “مفرخة لعقْديات تحت مسمى مغلوط هو (جيل الألفية الثالثة) وربما من بعده لأجيال الألفية الثالثة (جيل عشريني وثلاثيني.. إلخ)”.
وتؤكد أن الشعر هو المتضرر من عملية التفريخ هذه، إذ “سيفقد أهميته بالتركيز على أسماء الشعراء مع أنه لا يعرف عمرا زمنيا، كما أنه لا علاقة لتميز الشاعر بصباه وسواد شعْره أو بكهولته وبياض شيبته”.
وتتناول هناوي في التمهيد النظري مفهومي الجيل والتحول. ويستكمل الفصل الأول التنظير لظاهرة “التجييل العقْدي” محددا ملابساتها من ثلاث نواح: التفريق بين العمر الزمني والعمر الإبداعي، وفئوية الشاعر المنظر وتجييله شعره بكتابة بيان أو شهادة، وغموض مقولات الحداثة.
ويناقش الفصل الثاني نقائص التجييل العقْدي، بينما يتتبع الفصل الثالث أوهام التجييل العقْدي ومسالكه، ويستعرض الفصل الرابع دواحض المجايلة العقْدية من خلال تجربتي الشاعرين محمد مهدي الجواهري وحسب الشيخ جعفر.
ولا تنكر المؤلفة أهمية “التأرخة الأدبية للأجيال”، بل تؤكد أن ستينات القرن الماضي شهدت تجارب شعرية فردية مهمة، لكنها كانت امتدادا للمرحلة التي سبقتها، ومنها تجارب الشعراء الرواد وتجارب من جاء بعدهم.
ظاهرة التجييل بدأت بسيطة في الستينات، ثم أخذت تغزو المشهد الأدبي العراقي حتى بان أثرها في ثمانينات القرن العشرين والعقْدين الماضيين من القرن الحادي والعشرين
وتضيف أن بعض شعراء هذا الجيل استمرّ يجرّب في القصيدة خلال العقود اللاحقة لكنه ظل إما منتسبا بفردية تميزه الإبداعي إلى سياقات التجييل أو كان خارج تلك السياقات أصلا.
وتشير إلى أن الاحتمال الأخير ينطبق على تجربة حسب الشيخ جعفر الشعرية، نظرا لقوة موهبته في التجريب بكتابة “السونيت” والمسرحية والسيناريو والسيرة الذاتية والرواية. وبسبب هذا التميز وتلك الفرادة اختلف في تصنيفه جيليا لاسيما بعد رحيله، وهو ما حرك مياها راكدة حول إشكالية التجييل كما أعاد مقولة الجيل الستيني إلى الواجهة، فالكثير من المهتمين عدوا هذا الشاعر من هذا الجيل، والقليلون رأوا الأمر ليس كذلك وأنه “يمثل مدرسة شعرية ذات فرادة وخصوصية بما اصطنعه واشتغل عليه وتمرّس فيه حتى انتسبت القصيدة إليه وعرفت به”.
ونقرأ على الغلاف الأخير للكتاب “لم يستطع بعض الشعراء – الذين أثارهم هذا التحول ممن جايل رواد هذه الحركة أو من جاء بعدهم – تقبل الأمر أو استيعابه، فتفاوتت ردود أفعالهم وأسقط في أيدي بعضهم، فراح يبحث عن طريقة ما، بها يغالب هذا التحول ويصاديه، فوجد في التجييل العقْدي خير طريقة بها يؤكد حضوره في خضم هذا الزلزال الشعري الكبير، متنكرا لقوانين الجيل الطبيعية، ومتخذا من اسم العشر سنوات معيارا. وسرعان ما وجدت نغمة (العقْدية) هوى في نفوس شعراء آخرين، وهكذا ترسخ التجييل العقْدي وهو اليوم مقولة معتادة في نقد الشعر العراقي وظاهرة ابتدأت مفتعلة بسيطة وانتهت مقعدة ومعقدة”.




















