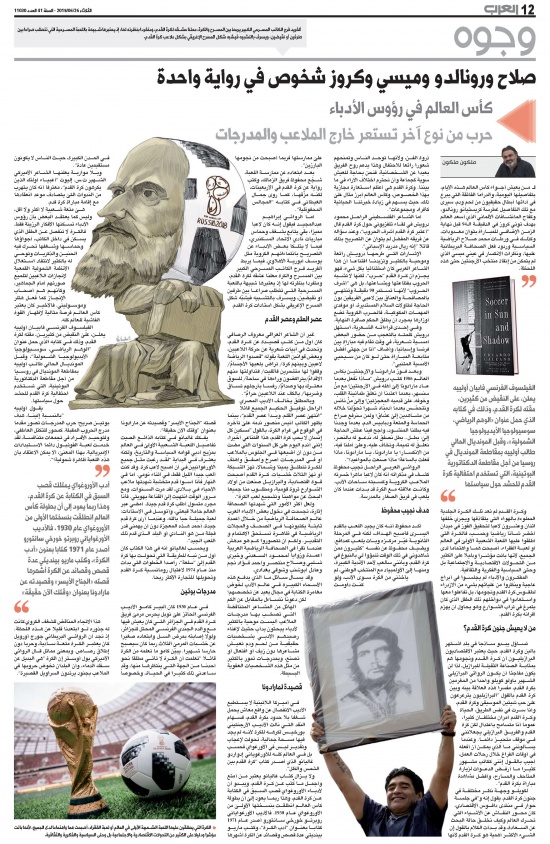اللغة الخضراء

بفضل شقاء الطفولة، والتجارب المريرة التي كابدها في السجن، تحول الفرنسي ألفونس بودار إلى كاتب مرموق تماما مثلما هو الحال بالنسبة لجان جينيه. ومن وحي سيرته المعذبة، أصدر العديد من الروايات التي حصلت على جوائز هامة، وتُرجمت إلى جلّ لغات العالم.
وكان ألفونس بودار قد قرأ في السجن رائعة لوي فارديناند سيلين “سفرة إلى آخر الليل”، وفي نفس اللحظة التي أنهى فيها هذه الرواية التي رسمت صورة مرعبة لمصير الإنسانية بعد الحرب العالمية الأولى، شعر أن الأدب لا يمكن أن يكون” مغلقا على ذاته” بأيّ حال من الأحوال، مُعَاينا في ذات الوقت أن لغة سيلين تختلف عن لغة كل الكتب التي قرأها حتى ذلك الحين.
وهي لغة لم تكن مألوفة من قبل إذ أنها تستمدّ قوتها وشاعريّتها من لغة الشوارع والأسواق والأماكن الخلفية في المدن الكبيرة. وكان الكتّاب الفرنسيون الكبار يتحاشون استعمالها باعتبارها لغة “العوام” و”السوقة”.
لذا نحن لا نعثر على أيّ عبارة أو مفردة من هذه اللغة في مؤلفات معاصري سيلين أمثال جان بول سارتر وأندريه جيد وفرانسوا مورياك وألبير كامو وغيرهم. وحده لوي فارديناند خاض المغامرة بكثير من الجرأة والتحدي، مُحققا نجاحا هائلا كاشفا عن نضارة اللغة اليومية، وشاعريتها، وجاعلا منها لغة “خضراء” بحسب تعبير ألفونس بودار.
وكان جان جينيه الذي أمضى سنوات طويلة في السجون، مُختلطا بعتاة المجرمين واللصوص، قد تجنّب في روايته، كما في مسرحياته، استعمال مفردات وتعابير اللغة اليومية.
وكان يبرّرُ ذلك قائلا إنه اختار الكتابة بلغة كلاسيكية رفيعة لكي يثبت لـ”العدو” الذي سجنه، وعذبه استنادا إلى قوانينه ومؤسساته الرسمية، أنه قادر على إتقان لغته الراقية التي يخفي وراءها قبحه ورياءه ونفاقه. وكان جان جينيه يردد دائما بأنه يحبّ أن “يحارب العدو بسلاحه”.
وفي مصر، تجرأ كتّاب أمثال نعمان عاشور ويوسف إدريس وعماد الديب وإبراهيم أصلان، وسعيد الكفراوي وآخرون على استعمال اللغة اليومية ليفلحوا في ذلك إلى حد كبير، نازعين عن اللغة الكلاسيكية قداستها وهيبتها. أما نجيب محفوظ فقد حافظ على استعمال اللغة الكلاسيكية حتى في الحوارات لكي يكون “مفهوما من قبل كل القرّاء العرب” بحسب تعبيره.
وفي روايتيه البديعتين “عرس الزين” و”بندر شاه”، جعل الطيب صالح من اللغة السودانية اليومية لغة “خضراء”، مشرقة بالشعر، وبأنغام الحياة في انسيابها البديع.
وفي تونس، خيّرَ محمود المسعدي الكتابة بلغة كلاسيكية لا تكاد تختلف عن لغة المتصوفة، وأبي حيان التوحيدي، وابن المقفع. وبذلك أعاد لتلك اللغة إشراقتها التي كانت قد فقدتها بحيث لم تعد قادرة لا على تسمية الأشياء بأسمائها، ولا على ملامسة الواقع بعد أن “حنّطَها” فقهاء وبلاغيو عصور الانحطاط.
وربما فعل المسعدي ذلك تحديا للاستعمار الفرنسي الذي كان يعتبر اللغة العربية لغة “ميتة” تماما مثلما هو حال اللغة اللاتينية. ولعله فعل ذلك أيضا لكي يثبت للتونسيين الذين بدأوا يشككون في قدرتها على مواكبة العصر، أن اللغة العربية لا تزال تتمتع بنضارتها وإشراقتها القديمة.
مع ذلك، لم تمنع بلاغة المسعدي بعض الأدباء المعاصرين له مثل علي الدوعاجي من استعمال الدارجة التونسية في قصصه وأزجاله بهدف “تطعيم” اللغة الكلاسيكية بمفردات وتعابير جديدة توثّقُ صلتها بالواقع وبالعصر. وكذا فعل الروائي الكبير البشير خريف في جلّ أعماله الروائية والقصصية، مؤكدا بأن اللغة اليومية لا تقل قيمة وقوة ونضارة عن لغة الضاد.
وراهنا أصبح العديد من الكتّاب العرب مشرقا ومغربا يقبلون على استعمال تعابير ومفردات اللهجات الدارجة. وظني أن هذا إثراء للغة العربية وليس اعتداء عليها كما يزعم حرّاس البلاغة الركيكة والمزيفة.