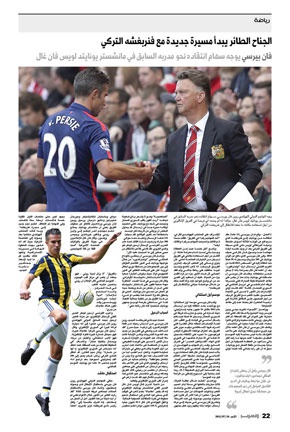الصوت المتوحد: الناقد الأيرلندي اوكونور يصف القصة القصيرة

يفتقر المجتمع النقدي المتحدث باللغة الإنكليزية إلى ناقد يملك ناصية القصة القصيرة كما هو الحال مع الأميركية هيلين فيندلر ناقدة القصيدة الغنائية. ومع الوضع في الاعتبار وجود القصاصين العظام أمثال تشيكوف أو جويس أو هيمنغواي قد يساورنا العجب من هذا النقص. ولكن هيمنغواي تحول إلى كتابة الرواية بعد مجموعته القصصية “في عصرنا” تماماً كما فعل جويس بعد مجموعته القصصية “أهالي دبلن” على حين اتجه تشيكوف خلال سنوات نضجه إلى الدراما.
وبينما توجد استثناءات مثل إسحاق بابل أو جريس بيلي اللذين قضيا حياتهما يكتبان نثراً مكثف الأسلوب يأبى عامداً الاتفاق مع النماذج الطويلة، يسود الزعم أن القصة هي ما ينتجه الكُتاب الشبان في سبيلهم إلى رواياتهم الأولى أو ما ينتجه الكُتاب الكبار ما بين رواية وأخرى. وبصرف النظر عن ذلك، لعل القصة، مع انتقالها التاريخي من الحكاية غير المتماسكة عضوياً إلى لحظة التنوير المكثف، لا تحتمل الإفراط في التحليل المنهجي.
الوحشة الإنسانية
لقد نشر الناقد والقاص الأيرلندي فرانك أوكونور دراسة عن هذا النوع الأدبي بعنوان “الصوت المتوحّد”. أراد أوكونور أن يعثر على وسيلة للتفرقة بين القصة من ناحية والأقصوصة والرواية من ناحية أخرى.
وقد أوحى عنوان دراسته بطبيعة استنتاجه: إن تقنيات القصة لا تميزها عن غيرها لأنها بوصفها فناً انتقائياً، وليس شاملاً، قد تبني نفسها من خلال عدد لا نهائي من الوسائل. أشار كذلك إلى أن طول القصة لا يحسم المسألة، فالعديد من القصص العظيمة طويلة للغاية.
يعتقد أوكونور أن ما يجعل القصة شكلاً أدبياً مميزاً هو “وعيها الحاد بالوحشة الإنساني. كانت قصة غوغول “المعطف” قد شكلت النواة الأولى لنشأة القصة، وفيها يتمكن موظف فقير من شراء معطف دافئ في الشتاء، فينتهي به الأمر إلى أن يُسرق منه، وهي كارثة تدفع به إلى حتفه.
ومن النماذج المعاصرة نجد أمثلة على هذا التصور في كتاب المختارات القصصية “فن القصة: مختارات عالمية من القصص القصيرة المعاصرة”، منها قصة “في ظل الحرب” للكاتب النيجيري بين أوكري، وكذا “اختفاء الفيل” للياباني هاروكي موراكامي، وهي فانتازيا برجوازية تحفل بإحساس بالغربة الاجتماعية. كما تروي قصة “مُرافِق” للتنزاني عبدالرزاق قرنح حكاية رجل تنزاني يعود إلى بريطانيا ليُدرّس الشعر، فيتورط رغماً عن أنفه مع سائق تاكسي.
مقياس القصة يجعلها ميالة إلى عزلة النفس. ووعي القاص بالوحشة هو الكرامة الأدبية التي يمنحها لشخوصه رغم ظروفهم
إن القصة الحديثة نوع أدبي يتعامل مع “الفئات المغمورة من السكان،” أفراد مُنعوا من العيش ضمن ثوابت الحضارة – أقليات ودخلاء ومهمشين، ومثالنا على ذلك امرأة نبذتها قريتها وأُرغمت على العمل في الدعارة في قصة الكاتب الكيني نجوجي واثيونجو “دقائق المجد” التي تسبر الجانب المظلم من التقدم الاقتصادي.
وعلى النقيض يعتقد أوكونور أن الأدب الروائي يفترض أن الإنسان “حيوان يعيش ضمن حدود المجتمع مثلما يتضح في روايات جين أوستن وترولوب”. ولكننا نستطيع أن نأتي بقصص تدور حول أناس يستقرون تمام الاستقرار في مجتمعاتهم كما نجد في قصص كاثرين مانسفيلد أو هنري جيمس، أناس ليسوا مهمشين وإن قد ينزل بهم الاغتراب من جراء أفعالهم كبطل قصة “أبي والإنكليزي وأنا” الكولونيالية للصومالي نور الدين فرح.
مغمورون روحيا
ربما توقع أوكونور هذه المشكلة، فعدّل فرضيته لتتضمن الفئات المغمورة على المستوى الروحي من فنانين وحالمين ومثاليين ولا أبطال. لكن مَن ذا الذي لا ينتمي إلى جماعة مغمورة؟ إن الصوت المتوحد جوقة عالمية، وما تبقى لدينا هو حقيقة غير مجدية تقول إن القصة بوصفها شكلا أدبيا تتعاطى مع الحالة الإنسانية.
علاوة على أننا نستطيع أن نورد روايات ليست متأصلة اجتماعياً مثل “الغثيان” لسارتر أو “ابن البلد” لريتشارد رايت أو ثلاثية “مولي” لصامويل بيكيت. لذا تشوب محاولة أوكونور لتمييز القصة في إطار علم الاجتماع الكثير من المغالطات.
سوف نعترف بنزوع القصة إلى عزل الفرد، وربما يكمن السبب – للمفارقة – فيما رفضه أوكونور من عوامل تقنية. لا يمكن تعريف القصة من خلال بنيتها أو طولها، وإنما العامل الحاسم هو مقياسها. فبحكم أبعادها الأصغر من الرواية، فهي أدب يفترض أن المجتمع ما هو إلا ظلمة تحوم حول دائرة قصصية من الضوء.
وبمعنى آخر، إن مقياس القصة يجعلها ميالة إلى عزلة النفس. ووعي القاص بالوحشة هو الكرامة الأدبية التي يمنحها لشخوصه رغم ظروفهم، نفس المكانة الأخلاقية التي تُسبَغ حتى على أحقر الأشخاص عند وفاتهم وفقاً للناقد والتر بنجامين.
أراد أوكونور أن يعثر على وسيلة للتفرقة بين القصة من ناحية والأقصوصة والرواية من ناحية أخرى
قيد أدبي محطم
لقد بيّن لنا جويس، الذي علا بالقصة الحديثة إلى درجة الكمال، أن نقطة بدايتها قد تقترب زمنياً من حل عقدتها، أي أنها قد تسبر حياة أحدهم في الوقت الذي تصل فيه اتفاقاً إلى لحظة تعريف أخلاقي لا رجعة فيها. وقد أضاف هيمنغواي تقنية أخرى، وهي نسج قصة ينشأ ما بها من ترقب من عدم ذكر مشكلتها المحورية.
وإليكم الأخبار: ينساق قصاصو اليوم في كتاب “فن القصة” بعيداً عن نموذج القصة الحديثة. إذ يبدون أكثر ميلاً إلى القصة غير المتماسكة عضوياً عن قصة التكشف المفاجئ، لذا فقصصهم تتجه إلى النموذج المبكر للحكاية، تتسم بالطول وتبتعد فيها نقطة البداية عن حل العقدة، وكذلك تتضح مشكلتها الأساسية كل الوضوح. الغريبة أن القارئ يخامره إحساس مريح بالحرية تجاه ما ظنه المجتمع الأدبي اتجاهاً محافظاً، اتجاهاً يشيح ببصره نحو القرن التاسع عشر، وكأن قيداً أدبياً قد تم تحطيمه.
ومع أن دانيل هالبيرن محرر الكتاب أعلن أنه انتقى القصة بعد الأخرى بلا أيّ تفكير في تأثيرها الكلي أو علاقة الواحدة بالأخريات، فقد تبلورتْ لتغدو مجموعة تعكس التركيبة السكانية المتطورة للمجتمع الأدبي العالمي.
فشخصياتها من غانا ولبنان وكوبا والهند والمكسيك وفيتنام والمجر وتنزانيا والمغرب وتركيا ونيجيريا وكينيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا والصين، مما يعود بنا مجدداً إلى نظرية فرانك أوكونور التي يتعذر درأ الانتقادات الموجهة إليها.
أظنه من الممكن أن نتبين في هذه المجموعة عالمية الضمير الأدبي. قد تجد أيضاً دليلاً على ما منحه انصهار المهاجرين إلى الأمم الغربية من طاقات نابضة بالنشاط والحياة. ولكن قبل كل شيء سوف يستشعر القارئ الحياة المحسوسة يعطيها القاص الموهوب المرسل على الدوام صوتين في العالم المتوحد، صوت الشخصية وصوت الكاتب.
كاتبة من مصر مقيمة في ليدز/بريطانيا