التيه المنهجي في الكتابة العراقية المعاصرة: تناقض وإنشائية وحماس مفرطان
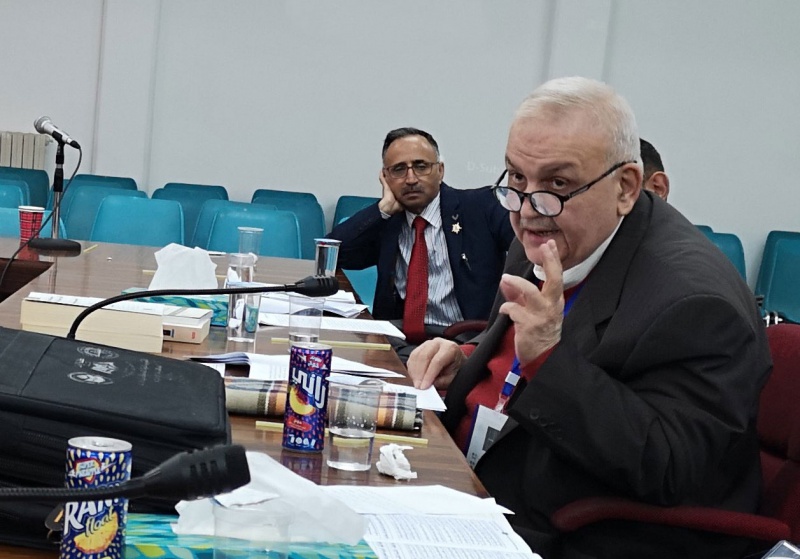
عمان - يؤدي النقد وظيفة قد تلامس قضايا وجوانب جوهرية في العمل الأدبي الذي يجري تناوله، وقد تحوم حوله دون أن تقدم فائدة ترجى. وفي الوقت نفسه، كثرت الأبحاث التي تعد لنيل الدرجات العلمية، لكنها لا تضيف للموضوعات المدروسة شيئا يذكر.
أمام هذا الوضع، الذي يسميه الدكتور وليد خالص “التيه المنهجي”، صار لزاما دراسة هذه الظاهرة، في محاولة لرصد القوانين المنهجية التي تستتر في تلافيف الكتب موضع الدرس، وكذلك مواضع الخروج عليها.
وفي كتابه الصادر أخيرا عن “الآن ناشرون وموزعون” في مجلدين، يطرح المؤلف سؤالا منهجيا هو: هل هناك قوانين منهجية أو غير منهجية نظمت الكتابة العراقية أم إن لكل كتاب شخصيته المستقلة عن غيره بما يمثل مؤلفه فقط واهتماماته وقناعاته الأيديولوجية والثقافية عموما؟

ومن خلال القراءة المتأنية، استطاع الباحث أن يلتقط مفردات تلك القوانين المنهجية، والخروج عليها في آن واحد، وسجل أن الكتابة العراقية بعد عام 2003 شكلت مرحلة خاصة، إذ تغيرت موضوعاتها، وتبدلت أساليب معالجاتها، وداخلتها تحولات مفصلية من حيث الشكل أو المضمون. وبدأ فهم مغاير لما سبق يزاحم غيره، بل يفرض سطوته عليه في الكثير من الأحيان، كما شرعت الكتابة العراقية الحديثة بطرح أسئلة صعبة، وحاولت تقديم الإجابات عنها.
واتبع المؤلف معايير صارمة في كتابه الذي جاء بعنوان “التيه المنهجي ومحاولات الإفلات”، محددا منهجه والأهداف التي يسعى إلى الوصول إليها، وملتزما بمحاور أساسية عند تناوله الكتب التي راجعها، وهي: مقياس الدراسة، وعنوان الكتاب، ونوعية الكتب المدروسة، والسمات العامة التي اتسمت بها الكتابة العراقية الحديثة، وإيضاحات لكل موضوع.
ويشتغل الكتاب بجانبين معا: التيه، ومحاولات الإفلات منه، واقتُبس عنوانه من مشاغل المباحث بوجهيها، لهذا جعل المؤلف دراسته في ثلاثة أقسام؛ نقرأ في الأول مقدمة نظرية، وفي الثاني نماذج من التيه المنهجي الذي أوقع بعض الباحثين أنفسهم فيه، وتناول سبعة كتب. أما القسم الثالث، فاشتمل على نماذج من محاولات الإفلات من ذلك التيه، واتباع المنهج العلمي في البحث، وتناول ثلاثة كتب، مع تحليل موسع لها.
وتلك الوفرة من الكتب، باهتماماتها المختلفة، أعانت الباحث على وضع اليد على مكامن القوانين المنهجية وغير المنهجية التي انتظمت الكتابة العراقية الحديثة، والتقاط مجموعة من السمات التي لازمتها، ومنها: التناقض، والإنشائية المفرطة المقترنة بالحماسة بغية ترسيخ الرأي، والتهويل في النتائج غير المستندة إلى نصوص أو شواهد، والنقص الواضح في المصادر المتمثل خصوصا في عدم اطلاع الباحث على ما يُصطلح عليه في منهج البحث بـ”أدبيات” الموضوع المدروس، وغلبة روح الثقافة الدفاعية في مقابل ضمور الثقافة من أجل المعرفة، وشيوع روح السجال وما ينتج عنه من افتقاد الموضوعية، والتبعية الصريحة للنظريات الغربية بلا مساءلة أو أدنى فحص، وتوظيف مقولات الحداثة وما بعد الحداثة الغربية وترويضها لتتناسب مع رغبات الباحث عبر بترها وقطعها عن جذورها المعرفية وحواضنها الفكرية.




















