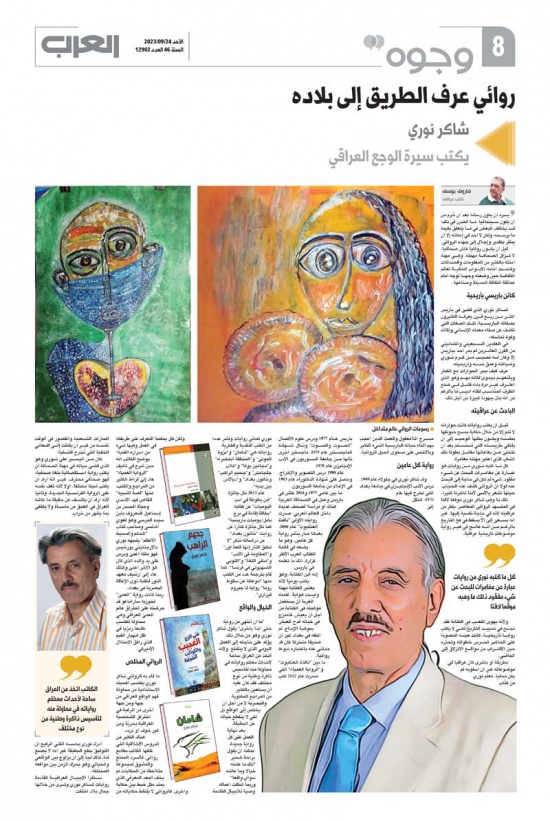التاريخ الجديد ثورة الذاكرة التي تراهن عليها المجتمعات المتطورة

شهد القرن الماضي اهتماما متزايدا بمسألة الذاكرة، وقد ولد هذا الاهتمام أعمالا بحثية وعلمية حول الذاكرة، في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية وحقولها. ومن المفيد هنا أن نستشهد ببعض الباحثين أو الإبيستمولوجيين الذين ساهموا في التطوير النظري لهذا الموضوع، ومن بينهم بول ريكور حول العلاقة بين الذاكرة والزمن والسرد، وموريس هالفاكس حول الذاكرة الجماعية والأطر الاجتماعية للذاكرة، وجاك لوغوف حول الذاكرة والتاريخ، وبيير نورا حول أماكن الذاكرة.
كما اتسع أيضا الاهتمام بالذاكرة الجماعية ليطال مسألة الهوية. إن الاهتمام بالذاكرة ودراستها، وعلى وجه التحديد بماض مرغوب فيه ويمكن استعادته، هو ظاهرة محملة ومشحونة، برزت في نهاية القرن العشرين نتيجة التغييرات المربكة في مجتمعات كبيرة، وقوميات متنافسة وتناقص فاعلية الأواصر الدينية والعائلية والروابط السلالية.
ويتطلع الناس الآن إلى هذه الذاكرة المجددة، ولاسيما في شكلها الجمعي، ليمنحوا أنفسهم هوية متماسكة، وسردا قوميا، ومكانا في العالم، مع العلم أنه قد يصحب هذه العمليات تلاعب وتداخل في صيرورة الذاكرة بمآرب ملحة أحيانا.
◙ المجتمعات التي لها ذاكرة شفوية على وجه الخصوص والتي راحت تشكل لها ذاكرة جمعية مكتوبة هي المجتمعات التي تمكنت على أحسن حال من إدراك ذلك الصراع الهادف إلى سيطرة الذكرى والتقليد اللذين هما في منزلة تحريك الذاكرة
الذاكرة هنا هي ليست بالضرورة ذاكرة أصلية، بل هي على الأصح ذاكرة نافعة، حيث يلاحظ تصرف الإنسان في الموروث، بالاختلاف والحذف؛ وهو منهج واقعي في استخدام الذاكرة الجمعية من خلال طمس قطع معينة من الماضي القومي وإبراز البعض الآخر بأسلوب توظيفي بكل ما قد تحمله الكلمة من معنى. وخير مثال على ذلك هو الكيفية التي وظفت بها قضية الهولوكست لتعزيز الهوية القومية الإسرائيلية بعد سنوات من عدم الاكتراث بها.
إن المدى الذي يشغله فن الذاكرة في العالم الحديث أمر في غاية الأهمية والخطورة في نفس الوقت؛ حيث يستفيد منه المؤرخون والمؤسسات والمواطنون المثقفون منهم والعاديون، غير أنه يساء استخدامه واستغلاله إلى حد كبير، لأن الذاكرة ليست ممثلة في شيء ساكن يمتلكه أيّ امرئ أو يحتويه، بل هي شيء قابل للتركيب وإعادة الصياغة.
أشار أندريه لوروا غورهان إلى المراحل التي قطعتها الذاكرة الجمعية: النقل الشفوي، والنقل الكتابي من خلال الألواح والمصنفات، واستخدام البطاقات البسيطة ومن ثم الوسائل الميكانيكية، وتاليا الوسائل الإلكترونية. لكن الانقلاب الذي جرى للذاكرة إبان القرن العشرين، وتحديدا بعد عام 1950، قد شكل ثورة فعلية لم تكن الذاكرة الإلكترونية فيه إلا عنصرا واحدا، وعظيما دون شك.
ويندرج ظهور الآلات الحاسبة الضخمة خلال الحرب العالمية الثانية في إطار تسريع واسع للتاريخ، وخصوصا التاريخ التقني والعلمي، بدءا من عام 1960، ويمكن إدراجه أيضا في مجرى التاريخ الطويل للذاكرة الأوتوماتيكية. وبوجود التطور التقني وحضور الكمبيوتر أضحت الذاكرة في المقام الأول والأخير إحدى ثلاث عمليات تتكون من كتابة (Ecriture)، وذاكرة (Mémoire)، وقراءة (Lecture) . وهذه الذاكرة، يمكن أن تكون في بعض الحالات غير محدودة، وهنا تدخل في التمييز بين الذاكرة البشرية والذاكرة الإلكترونية حيث تبرز هشاشة الأولى وضعفها، وقوة الأخيرة وقدرتها الهائلة على استرجاع المعلومات.
ومهما كان الأمر فإن الإنسان هو الذي يتحكم بسائر هذه العمليات. فالذاكرة الإلكترونية ليست سوى مساعد، وخادم للذاكرة والعقل الإنساني. لكن يمكن إبراز أمرين اثنين قاد إليهما ظهور الذاكرة الإلكترونية: الأول هو استخدام الحاسوب في مجال العلوم الاجتماعية، وتحديدا حين تكون الذاكرة هي المادة والموضوع: أي التاريخ، والذي عاش ثورة توثيقية حقيقية بظهور نوع جديد من الذاكرة هو بنك المعلومات. أما الثاني فهو توسيع استخدام مفهوم الذاكرة قياسا على الذاكرة الإلكترونية، وعلى أنواع أخرى من الذاكرة مثل أبحاث العالم فرانسوا جاكوب الحائز على جائزة نوبل في كتابه “منطق الكائن الحي: تاريخ الوراثة” (La Logique du vivant: une histoire de l’hérédité) حيث ينصبّ عمله على الذاكرة البيولوجية.
وبالعودة إلى الذاكرة الاجتماعية، فإن الانقلاب الذي عرفته في النصف الثاني من القرن العشرين تم التحضير له أساسا من خلال التوسع في مقاربة الذاكرة في حقلي الفلسفة والأدب. فالفيلسوف الفرنسي هنري برغسون نشر في عام 1896 مؤلفه الشهير “المادة والذاكرة” (Matière et mémoire) حيث وجد أن مقولة الصورة تلعب دورا محوريا على مفترق الذاكرة والإدراك. ومن خلال تحليل طويل لهنات الذاكرة: نسيان اللغة أو فقدان النطق، اكتشف برغسون طي ذاكرة سطحية، مجهولة، تشابه العادة، ذاكرة عميقة شخصية، صافية (Pure)، لا يمكن تحليلها من خلال عبارات الأشياء ولكن من خلال مفهوم التطور.
هذه النظرية التي عثرت على روابط الذاكرة بالفكر كان لها الأثر الكبير على الأدب. فالسوريالية التي اعتمدت على الحلم، انقادت إلى التساؤل حول الذاكرة، وقد لعب سيغموند فرويد دور الملهم، خصوصا في كتابه “تفسير الأحلام” (L’interprétation des rêves) عام 1899، إذ أكد أن سلوك الذاكرة خلال الحلم ذو أهمية كبرى لكل نظرية عن الذاكرة. وإسهام كل من برغسون وفرويد كان بارزا على مستوى الذاكرة الفردية.

تعرضت الذاكرة الجمعية لتحولات عديدة عندما تأسست العلوم الاجتماعية ولعبت دورا هاما في الحقول العلمية المتداخلة بين بعضها البعض.
فالسوسيولوجيا مثلا شكلت عاملا محفزا لاستكشاف هذا المفهوم الجديد. ففي عام 1950 نشر موريس هالفاكس كتابه “الذاكرة الجمعية”. ولأن هذه الذاكرة مرتبطة بالتصرفات وبالعقليات، وهذا موضوع جديد بالنسبة إلى التاريخ الجديد، فإن علم النفس الاجتماعي يقدم مساهمته. وبقدر ما يقدم مصطلح “ذاكرة” للأنثروبولوجيا مفهوما أكثر ملاءمة لحقائق المجتمع التي تدرسها مما يقدمه مفهوم “التاريخ”، تستقبل هذه الأنثروبولوجيا مفهوم الذاكرة وتستكشف أبعاده مع التاريخ، وهذا يتم طبعا من داخل التاريخ الأنثروبولوجي، أو الأنثروبولوجيا التاريخية التي تعد واحدة من المساهمات الحديثة والأكثر أهمية بالنسبة إلى العلم التاريخي.
إن عملية بحث وإنقاذ وتمجيد للذاكرة الجمعية لم تكن من خلال الأبحاث المهمة فحسب، ولكن في الزمن الطويل الممتد أيضا. بحث عن الذاكرة في النصوص، وفي الكلام والصور والأفعال والطقوس والأعياد. إنه الاهتداء والاعتناق للنظرة التاريخية، اعتناق شارك فيه الجمهور العريض الذي تملّكه هاجس الخوف من خسارة الذاكرة، ومن النسيان الجمعي، الذي عبر عنه بشكل سلبي تجاوز الذاكرة؛ لأن الذاكرة أصبحت أحد موضوعات المجتمع الاستهلاكي الشديدة الرواج.
ويعرف بيير نورا الذاكرة الجمعية بأنها كل ما بقي من الماضي في معاش الجماعات، أو ما تصنعه هذه الجماعات بالماضي، وهذا التعريف يمكن أن يعارض للوهلة الأولى ما يسمى بالذاكرة التاريخية. فالخلط عمليا وبحسب جاك لوغوف كان هو السائد بين التاريخ والذاكرة، فيظهر التاريخ وكأنه حقق تطوره الخاص بناء على نموذج إعادة التذكر (Remémoration) وعلى استعادة الماضي (Anamnèse) وعلى تعبئة الذاكرة (Mémorisation)، ويعطي المؤرخون صيغة “الأساطير الجمعية الكبرى” وأننا ننتقل من التاريخ إلى الذاكرة الجمعية.
لكن تطور العالم المعاصر وتحت ضغط التاريخ المباشر أو الفوري (L’histoire immédiate)، وهو في الجزء الكبير منه يصنع فوريا بواسطة وسائل الإعلام، وينحو نحو الإنتاج المتعاظم للذاكرة الجمعية، جعل هذا التاريخ يكتب أكثر من أيّ وقت مضى تحت ضغط هذه الذاكرة الجمعية. فالتاريخ المسمى “جديدا” والذي يجهد نفسه لتأسيس تاريخ علمي انطلاقا من الذاكرة الجمعية، يمكن أن يتم تفسيره كمرادف لـ”ثورة الذاكرة” مستكملا تمحور الذاكرة حول عدد من الموضوعات الأساسية.
تاريخ يصنع انطلاقا من دراسة الأمكنة، ومن الذاكرة الجمعية: أمكنة طوبوغرافية مثل: الأرشيف، المكتبات والمتاحف. أمكنة تمتلئ بالنّصب مثال: المقابر والأبنية الهندسية. أمكنة رمزية مثل: ذكرى الاحتفالات، الحج، الأعياد السنوية أو الشعارات. أمكنة وظيفية مثال: الكتب المدرسية، السير الذاتية أو الجمعيات. وهذا يجب ألا ينسينا الصانعين والمهيمنين على الذاكرة الجمعية: دول، أوساط اجتماعية وسياسية، جماعات الخبرة التاريخية، أو الأجيال التي وجدت نفسها تؤسس أرشيفها الخاص تبعا لاستخدامها المختلف للذاكرة.
وبالتأكيد أسست هذه الذاكرة الجمعية جانبا من معرفتها بواسطة أدوات تقليدية ولكنها مدركة، ومستخدمة بشكل مختلف كليا. تجلّى ذلك في فروع جديدة لدراسة التاريخ، كما حصل في الولايات المتحدة الأميركية حيث تم إنشاء التاريخ الشفوي بين عامي 1952 و1959، في جامعة كولومبيا وبركلي ولوس أنجلس، وانتقلت التجربة بعد ذلك إلى كندا والكبيك وإنجلترا وفرنسا، وظهر الاهتمام بتاريخ العمل والعمال من خلال الوعي بأهمية الماضي الصناعي والحضري والعمالي للشريحة الكبرى من السكان.
وساهم مؤرخون وعلماء الاجتماع على وجه الخصوص في دراسة الذاكرة الجمعية العمالية، لكن المؤرخين وعلماء الأنثروبولوجيا انصرفوا نحو حقول أخرى للذاكرة الجمعية في أفريقيا وأوروبا، مستخدمين طرائق جديدة في الاستذكار مثل تواريخ الحياة (Histoire de vie). وفي حقل التاريخ وتحت تأثير المفاهيم والتصورات الجديدة للزمن التاريخي، تطور شكل جديد من أشكال كتابة تاريخ التاريخ التي غالبا ما تكون في الفعل دراسة التحوير أو التلاعب الذي تقوم به الذاكرة الجماعية لظاهرة تاريخية، كان التاريخ التقليدي وحده قد درسها.
◙ الناس يتطلعون إلى الذاكرة المجددة، ولاسيما في شكلها الجمعي، ليمنحوا أنفسهم هوية متماسكة، وسردا قوميا، ومكانا في العالم، مع العلم أنه قد يصحب هذه العمليات تلاعب وتداخل في صيرورة الذاكرة بمآرب
أضحت الذاكرة إذن، وخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين، جزءا من الرهانات الكبيرة للمجتمعات المتطورة والسائرة في طريق التطور، للطبقات المسيطرة والمسيطر عليها، والتي تناضل كلها من أجل السلطة والحياة، ومن أجل البقاء والارتقاء. صارت الذاكرة عنصرا أساسيا لما يطلق عليه الهوية الفردية أو الجمعية، والتي يكون البحث عنها بمنزلة نشاط أساسي يبذله الأفراد والمجتمعات اليوم، في غمرة الحمى والقلق.
لكن الذاكرة الجمعية لم تعد أحد الرهانات المجتمعية فحسب، بل هي وسيلة وهدف احتمالي. فالمجتمعات التي لها ذاكرة شفوية على وجه الخصوص والتي راحت تشكل لها ذاكرة جمعية مكتوبة هي المجتمعات التي تمكنت على أحسن حال من إدراك ذلك الصراع الهادف إلى سيطرة الذكرى والتقليد اللذين هما في منزلة تحريك الذاكرة.
وقد بين بول فاين مثلا في أبحاثه حول اليونان والرومان، كيف أن الأغنياء ضحوا بجزء كبير من ثرواتهم ليتركوا أثرا يدل عليهم وعن دورهم. لذلك يبدو من المهمات الملحة أمام المختصين بالذاكرة، من مؤرخين وأنثروبولوجيين وصحافيين وعلماء اجتماع، السعي من أجل دمقرطة الذاكرة الاجتماعية بمواجهة المعارف الخاصة التي تحتكرها مجموعات محددة تدافع عن مصالح خاصة. فالذاكرة بما هي منهل للتاريخ ومصدر تغذية في الآن عينه، لا تبحث في إنقاذ الماضي إلا لكي تنجح في خدمة الحاضر والمستقبل. لذا من الضروري العمل على أن تسهم الذاكرة الجمعية في تحرير الناس لا في استعبادهم.
لا تشكل الذاكرة استرجاعا مباشرا وشاملا للتجارب الماضية المعيشة بل هي على الأصح إعادة بناء وإعادة هيكلة لذلك الماضي. إنها تراث ذهني، وطائفة من الذكريات التي تغذي التصورات وتؤمّن تلاحم الأفراد ضمن مجموعة معينة، أو في نطاق مجتمع محدد، وتلهم بالتالي مختلف أعمالهم ومجمل أنشطتهم الحاضرة. إن استخدام الذاكرة بالمعنى الأخير كان قد تعمم منذ حوالي ثلاث عقود وغالبا ما اقترن بفكرة واجب الذاكرة (Le devoir de mémoire)، ولقد كان تعميم هذا الاستخدام من الاتساع والشمول في نهاية القرن الماضي، وهو ما دفع بيير نورا إلى القول إن نهاية القرن العشرين لتبدو وكأنها “لحظة ذاكرة”.
• ينشر المقال بالاتفاق مع "الجديد" الثقافية الشهرية اللندنية