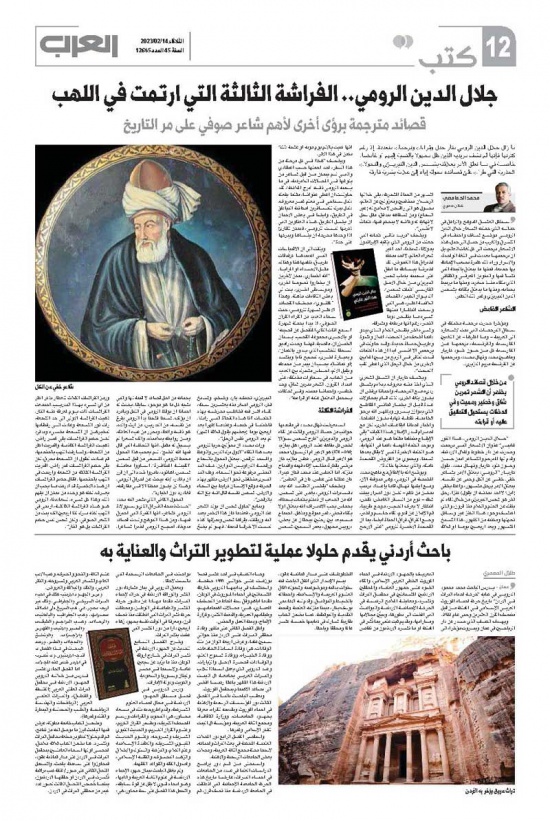البحريني حسين المحروس: في الخليج ذاكرة واحدة يوثقها الأدب والتصوير

يمتلك الفنان البحريني حسين المحروس تجربته الخاصة التي ميزته في الساحة الثقافية البحرينية والخليجية، لكنها تجربة تؤمن بأن الذاكرة في الخليج واحدة، أو هي متشابهة حد التطابق، تتكشف ملامحها في الأدب وخاصة في التصوير الفوتوغرافي الذي هو خير امتداد لكل ما هو زائل من أمكنة وشخوص.
مسقط - يقدم الكاتب والمصور الفوتوغرافي البحريني حسين المحروس تجربة فنية مغايرة تتجسد في اشتغاله على الكلمة من خلال الصورة وأبجدياتها المتقاطعة. ولأن المحروس كاتب مسكون بقضايا المكان وأدبياته، ترى ذلك واضحًا بصورة جلية في أعماله التي تنسجم مع تنوع قضاياها وأفكارها المتناغمة.
للكاتب الذي زار سلطنة عُمان أخيرًا لأجل معرضه الفني “بستان الأحجار الكريمة” العديد من الأعمال الفنية والسردية الروائية، بما فيها روايتا “مريم” و”حوّام” وغيرهما من الأعمال التي أثبتت فرادة تجربته مع الأدب على وجه الخصوص. في هذا التطواف نقترب من الكاتب حسين محروس لنتعرف على قضايا الكتابة والصورة في آن واحد.
تجانس ثقافي

يقترب حسين المحروس من التجانس الثقافي الخليجي الذي شكّل ذاكرة وعيٍ نوعيٍّ استفاد منه الكثيرون في الشأن البصري والتشكيلي مرورًا بالسرد، ويصفه “لدينا في الخليج ذاكرة واحدة؛ لذا الحديث عن التجانس يعني الحديث عن ذاكرات هي في الأصل لم تكن كذلك! أو ربّما أنّ هذا التجانس حدث لاحقًا، وأنه يمكننا ملاحظته حين نستخدم شبه الجزيرة العربية ونعني بها الأرض كلّها من البصرة حتى آخر اليمن، والكتابة عن حدث ما جرى في مكان ما فيها دون متابعة ردود فعله أو أثره في مكان آخر منها يعني متابعة قاصرة جدا”.
ويضيف “بيننا ألفة، لغة، تاريخ، صلات اجتماعيّة، سيرة حياة أيضًا كلّها أخذتنا إلى هذه الحالة التي تصعب فيها نسبة منتج ثقافي مكتوب أو بصري إلى مكان محدد أحيانًا. في كثير من الأحيان أمسك صورة من الأرشيفات القديمة فيها بحارة، أو مزارعون أو سوق نختلف في نسبتها إلى مكان ما لولا تدوينة المصور، وكلّما اقتربت الصور من الوجوه صعبت نسبتها إلى بلد محدد، ومزاجي مع هذا المصطلح المربك فما بيننا في الخليج أكثر من مفهوم هذا المصطلح”.
ويوضح “بقي كيف يأخذ كلّ واحد منه، كيف ينظر إليه، يتلقاه، يفهمه، وكيف يوظفه في شأنٍ فنّي، كتابي أو بصريّ، هو عائد إلى تجربة هذا الشخص التي أظنّ أنّها بصريّة في أصلها”.
وفي شأن تجربة الصورة في منطقة الخليج عمومًا وسلطنة عُمان على وجه الخصوص، يشير المحروس إلى أي مدى استطاعت هذه التجربة مواكبة تفاعل الحياة تصاعديًّا في الشؤون الاجتماعية والثقافية والعلمية وغيرها، مرورًا بالصعيد الدولي، وموضع الفنان الفوتوغرافي الخليجي اليوم، ويقول “في الخليج نشاط فوتوغرافي طويل، حيويّة بالغة، ظهور لحملة الكاميراوات الثقيلة، مقاولون لرحلات التصوير، مغامرات بعضها خطر، صور مهمة في التوثيق الطبيعي والثقافي، لكنّ أغلبها يذهب للنشر السريع جدًّا، دون العمل على وضعها ضمن مشروعات طويلة، فيها البحث مجاورًا للصورة، أو الصورة التي تأتي من تجربة بحث أو استقصاء بصريّ. طبعًا، أستثني عددًا قليلًا من المصورين”.
ويشير إلى أنه “لدينا عدد نادر من مؤسسات الصورة، ومركز واحد على الأقل للحفاظ على الصورة، وسوف أبتعد عن مقارنة المصورين في الخليج بغيرهم، لأنّه عندما يتعلق الأمر بالرؤية الشخصية للصور لا توجد منافسة، فكلّما حاولنا إثبات شيء عبر هذه المقارنات في الصورة تخلينا عن الحياة، ما هو مهم في الصورة تحويل التفاصيل الصغيرة إلى مشروعات”.
وتشتغل تجربة المحروس الأدبية والفنية على إيقاع الصورة لتشكّل نموذجًا من نماذج الإنتاج الثقافي. وعن مدى حضورها في سياق ما وصل إلى القارئ من إنتاج روائي أيضًا، يقرّب الكاتب والمصور البحريني المتلقي من هذا السياق، ويؤكد “يبدو لي أن العمل على المشروعات الفوتوغرافية له دور في صياغة الكاتب أيضًا، بما ترفده الصورة بمخزونها غير الثابت، بأثرها الماديّ أحيانًا، وبالتفاصيل الصغيرة فيها والتألق بها، أو ما يسميه رولان بارت ‘الولع بالقسمة’، بالذهاب إلى أرشيفها، بدراسة كيفية التعامل مع الصور في تلك الأرشيفات أيضًا، وهناك مخازن الحياة التي مرّ الكثير، والمثير منها، وتحولات الحياة، وأمور كثيرة في الصورة تملأ لك خزانات الخيال، وتجعل التجربة في حراثة دائمة”.
ويبّين “في ظنّي أيّ كتابة لا تمرّ عبر تجارب من الاهتمام البصريّ لا يعوّل عليها، وسوف تفقد تلك الآلة التي تجعل القارئ يرى الذي رأيت، ويقول لك: كنت أشاهد صورا، تسجيلا بصريًّا”.
تجربة البحريني حسين المحروس الأدبية والفنية تشتغل على إيقاع الصورة لتشكّل نموذجًا من نماذج الإنتاج الثقافي
وكتب المحروس رواية “مريم” لتكون عملا روائيا ذا أبعاد اجتماعية وإنسانية عميقة، وهنا يشير إلى الكيفية التي استطاع من خلالها إيصال صوت حقيقتها إلى المتلقّي، ويفسر ذلك بقوله “لم أصنّف هذا العمل، جعلته نصًّا سيريّا مفتوحًا بطباعاته الثلاث المختلفة، فيه شيء من الرواية، أو على وشك منها، حيث يصعب الفصل الحاد جدًا بين المصطلحات رواية، سيرة روائية، رواية سيرية، سيرة.. إلخ، مثل صعوبة الفصل بين التدرجات اللونية غير النهائيّة”.
ويتابع “هي سيرة مريمات حيّ النعيم في المنامة، في الموضع الذي ترى فيه حقيقة مهمّة: أن رأي الرجال في المجالس والمساجد والتجمعات هو في الأصل رأي هؤلاء النسوة المريمات، وليس رأيا حقيقيا للرجل، لكنّهن يهبن هذا الخروج بالرأي للرجل، وعلى الرغم من ذلك تضيع أسماء النساء في الحيّ، تعرف الواحدة منهنّ باسم بالإضافة لاسم ولدها (أم عيسى) أو بالإضافة لاسم أبيها إن لم يكن لها ولد (بنت يوسف)! وينسى حتى أقرب النّاس إليها اسمها، تمرّ الحياة كلّها بأفراحها، بيومياتها، بطقوس الحزن الطويلة عند النساء في الحيّ بين غياب صاحبة الرأي وبين ضياع اسمها”.
ولكون روايته “حوّام” تقترب أكثر من المرأة أيضًا، هنا يصف فكرتها وهي تحاول معالجة تفاصيل لمجتمع لا يخلو من التعقيد في تركيبته الاجتماعية، ويقول “في ‘حوّام’ العلاقات التابو، العلاقات المنفيّة في السطح، النشطة في الأسفل، أخذتني إليها تقارير طويلة نشرتها في صحيفة ‘الوقت’ حيث العمل الصحافي الاستقصائي رافد قصصي خصب غير عادي للكاتب. لكنّ تلك العلاقات تمرّ عبر حياة مربي الحمام في البحرين، هناك يمكن معرفة ما يحدث من تشبّه عند الإنسان بعالم الحمام الأخّاذ”.
ويضيف “كان عليّ تقصّي هذا العالم أيضًا ورفقة أصحابه ميدانيا، مدونا ومصورًا. كانت سيرة العمل في الحقلين: لقاء ضحايا التابو، ومجانين عالم الحمام لا يخلوان من الجمال ذي الطبيعة المتوترة، الظنونة، التي لا أنساها أبدًا”.
الصورة امتداد للزائل

الكاتب حسين المحروس مسكون بتفاصيل المكان ونبش الذكريات، وهذا ما يتجلى في حقائق صوره ونتاجه الأدبي، هنا يوضح تأثير وقع المكان في خصوصيتنا مع الكتابة، وما إذا ثمة محفزات تعمل على تعميق ذلك، ويقول “نعم، محرّض واحد يكفي للكتابة أو للتصوير: أن ترى المكان في النّاس بخرائطه الرطبة”.
ويأتي معرضه الجديد “بستان الأحجار الكريمة” ليكون نتاج عمل لسنوات طويلة. هنا يقرّب بعضًا من تفاصيله القريبة إليه وما يميزه عن غيره من إصداراته الأدبية السردية ويقول “كلّ إصدار له سيرته، نيته، كتابته، حفره وبحثه ومزاجه، لا أقارن بينها. لكن مشروع ‘بستان الأحجار الكريمة’ جاء بعد عمل ميداني وبحثي لسنوات. وفي البستان، وفي أي مكان لا يمكنكَ أن تقولَ أكثر ممّا ترى، حين بدأتُ التصوير في بساتين شارع النخيل في منتصف التسعينات بكاميرا كانون (AE1) الفيلميّة، قال لي أحدهم: تأخرت كثيرًا. أنتَ لم تر البساتين!”.
ويضيف “حملت كاميرتي وعبارته معًا لم ينفكّا أبدًا، يظنّ أنّ الصورة امتداد للزائل. رأيتُ أنّ تجربة تصوير البساتين تشبه تجربة تصوير الصيادين في سواحل البحر: البساتين والسواحل في طور الزوال؛ فالكثير من البساتين التي صورتها بشكل ممتدّ، وصورت نشاط الزرّاعين فيها أزيلت والبحر لم أعد أجده”.
ويتابع “حدث كلّ ذلك في فترة وجيزة جدًا. صارت الصور تحمل معنى يتجاوز الجمالي إلى التوثيقي التاريخي، تصير لها وظيفة أخرى: إيلام الآخرين! الذين هم نحن. في العام 2006 حين دخلت ‘الشاذبية والصبيخة’ أوّل مرّة والتقيت فيها بالحاج عبدالله بن خميس وإخوته الثلاثة كانت عبارة النخلاويّ (تأخرت كثيرا أنت لم تر البساتين) في وجهي! قلت لنفسي: صحيح جدًا، أنا لم أرَ البساتين لكنّي رأيت العين التي رأت البساتين: عبدالله، جميل، رسول وحبيب”.
ويوضح المحروس في سياق حديثه عن “بستان الأحجار الكريمة”، “كنت حذرًا للغاية في البداية، وربّما تركتُ كاميرتي في حقيبتها؛ ليس لأنّ العلاقة في بدايتها، لكن المكان في البستان كلّه جدّ، كلّه قصد، كلّ شيء في موعده، ولا يليق بمصور ليس جادًا أن يذهب إلى المزارعين، يرفع الكاميرا في عيون حتى الضحكُ فيها جادّ، كيف أعرف معنى أنّهم يعرفون مواسم الغرس بالرائحة، لا بالمواقيت؟ كيف يمكن كتابة ذلك فضلًا عن تصويره؟”.