الأنثروبولوجيا الفلسفية محاولة متكررة للوصول إلى التفكير في الذات وذات الآخر
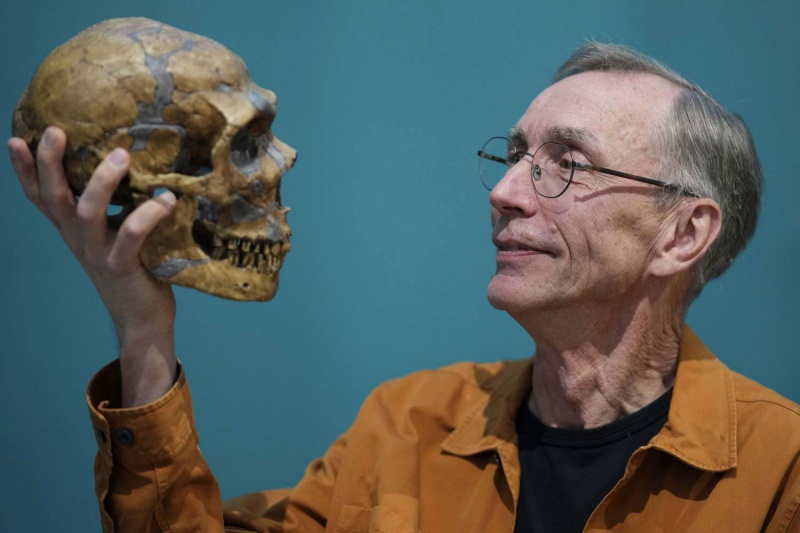
من الواضح تماماً، أن علم الأنثروبولوجيا أو ما يُعرف بـ”علم الإنسان”، على علاقة بكافة صنوف العلوم الأخرى، وأما عن علاقته بالفلسفة، فكانت علاقة تتسم بطابع معين، فكما يرى الفلاسفة الأوائل، مثل أرسطو الفلسفة على أنها علم المبادئ والأسباب الأولى، والتي تهدف إلى البحث عن الحقائق بأكملها، وبكافة أساليب الفكر نظاماً وتماسكاً، فهي بذلك تشترك مع الأنثروبولوجيا في عملية البحث عن الحقيقة، حتى وإن كانت وسيلة الوصول إلى الحقيقة في الفلسفة بدت بشكل مختلف عنها في الأنثروبولوجيا.
ويهدف البحث في الأنثروبولوجيا إلى الوصول إلى حقائق ميدانية، من خلال التعايش مع مجتمعات الدراسة، أو اعتمادا على معلومات توفرها مصادر أخرى، وذلك عكس الفلسفة التي تعتمد في الأساس على العقل، لأن نظرة الإنسان إلى الكون والحياة والموت، وهي من الموضوعات الهامة للأنثروبولوجيا، هادفة إلى الكشف عن مختلف أنماط التفكير والسلوك لدى الجماعات الإنسانية عبر المكان والزمان، كما تطورت العلاقة بين الأنثروبولوجيا والفلسفة، وبالأخص في فترة عشرينات القرن العشرين، حيث يظهر مصطلح الأنثروبولوجيا الفلسفية، والذي تحول إلى نظام فلسفي نافس التخصصات الفرعية التقليدية الأخرى في نظرية المعرفة والأخلاق والميتافيزيقا.
وتُعد الأنثروبولوجيا الفلسفية محاولة لتوحيد طرق متباينة، هدفها فهم سلوك البشر، مع تحليل علم الوجود، الذي قام بلعب أهم الأدوار في العلاقات الإنسانية، لتصبح التبادلية الداخلية موضوعا أساسيا فيه، وفي داخل حيز مشترك لدراسة كيفية فهم شخصين، وقد ركز بعض علماء الأنثروبولوجيا الفلسفية، مثل مايكل د. جاكسون أبحاثهم وأعمالهم الميدانية على المواضيع الوجودية في العالم، وأيضاً العلاقة بين الأشخاص، في أسلوب منهجي تحدى الأنثروبولوجيا التقليدية، من خلال تركيزها على تجربة الشخص الأول.
◄ مسألة الاهتمام بالإنسان ضمن محيطه الحضاري والثقافي باتت من الإشكالات القديمة والجديدة معاً، وبصورة بدت أبدية، وكان أساس تلك الإشكالات القلق والرهبة والخوف والمرض والحروب، وفي نهاية المطاف يكون الموت
كما استكشف جاكسون مفهوم السيطرة، والذي أشار فيه إلى أن البشر يقومون بتجسيد الأشياء الجامدة حولهم، لأجل الدخول في علاقة شخصية معهم، وبتلك الطريقة يستطيع البشر أن يشعروا وكأنهم يتحكمون في مواقف يصعب عليهم السيطرة عليها، بدلاً من التعامل من الكائن نفسه، ليعاملونه كأنه كائن عقلاني قادر على فهم مشاعرهم ولغتهم.
قد يبدأ خطاب الأنثروبولوجيا الفلسفية حينما يتأمل الإنسان في العالم الآخر، وعندما يقوم بإدراك ذاته في داخل التاريخ، والذي قد أسماه جورج فيلهلم هيجل (1770 – 1831) بـ”الروح الذاتية”، وإدراجها في داخل فلسفة التاريخ وفي تلك المرحلة من الوعي، تصبح لكل أفعاله دلالة أنثروبولوجية فلسفية، ما يؤكد على مدى تقارب وجهات النظر بين الأنثروبولوجيا الفلسفية وبين فلسفة التاريخ، وفي حالة اقتصار النظر إلى الإنسان خارج التاريخ سيظهر رؤيتنا إلى الإنسان علي اعتباره مجرد آلة تحكمها قوانين الطبيعة، أو عبارة عن عدة وظائف غريزية بيولوجية، علماً بأن هيلموت بليسنر مؤسس الأنثروبولوجيا الفلسفية هو من أكد على ذلك الأمر.
بينما رفض مارتن هيدجر (1889 – 1967) وقتها هذا الرأي، مفضلا الوظيفة العضوية على حساب الوظيفة التبادلية، وهي ما يعرف بفرع من الألسنية يُعالج علاقة المتخاطبين مع لغاتهم حين يتواصلون من خلال استعمالها، ما يعني أن التواصل هو أساس ما تهدف إليه دوماً وتبتغيه الأنثروبولوجيا الفلسفية، وهو نفس الأمر الذي كان ينادي به الفيلسوف والعالم الألماني يورجن هبرماس من خلال نظريته التواصلية، ولذلك السبب ظهرت تساؤلات هامة مفادها هل يجب الاهتمام بالأنثروبولوجيا الفلسفية يلي ذلك اهتمامها بالإنسان؟ وتلك التساؤلات باتت تُشكل محور اهتمام بحث الأنثروبولوجيا الفلسفية، وبالأخص في وقت اكتشاف التحول المخيف الذي تعرفه الإنسانية في العديد من المجالات التي تتعلق بالبيئة أو الصحة.
بينما فهَّم الفلسفة على أنها علم الإنسان لأنه الكائن المدرك على نحو أكثر فاعلية لماهية الاجتماعية في العلم، كما يؤكد هبرماس على أن الفلسفة هي علم أنثروبولوجي فلسفي، وفي الوقت الذي فقدت فيه الفلسفة النقدية أمام الأنثروبولوجيا الفلسفية، قام إيمانويل كانط (1724 – 1804) في عام 1773 بمعالجة تلك الفلسفة ضمن مصدره الموسوم بـ”الأنثروبولوجيا من وجهة نظر علمية براغماتية”.
☚ ينشر المقال بالاتفاق مع مجلة "الجديد" الثقافية الشهرية اللندنية
وأكد الفيلسوف بول ريكور (1913 – 2005) على أن الأنثروبولوجيا الفلسفية تختص بالتفكير في الذات عينها، وهو أساس قيامه بتعريفها قائلاً “لما كان الضمير هو ذاته يرتقي بدوره إلى الملء الذي يحتوي كافة الأزمنة، حين يكمل لفظة هو نفسه، المرتبطة بصيغة المصدر، أن يدل نفسه على نفسه، ومن هنا فإني أترك جانباً مؤقتاً الدلالة المرتبطة بلفظة ‘عين’ في تعبير الذات نفسها”.
ويُعد عالم الاجتماع الألماني الشهير ماكس شيلر (1874 – 1928)، هو من شكَّل هيمنة الفلسفة في ألمانيا في بداية القرن العشرين، ولمدة زادت عن عقدين من الزمن، مع سعي شيلر إلى وضع أسس ومنهج إدموند هوسرل للظواهر المختلفة، وإلى تأسيس الأنثروبولوجيا على اعتبارها نظاماً فلسفياً لكي تتنافس مع الظواهر وغيرها من التخصصات الفلسفية الأخرى، وفي الوقت الذي عرّف فيه شيلر الإنسان على أنه ليس حيواناً عقلياً، إلا أنه في الأساس كائن محب، وهو بذلك كسر المفهوم التقليدي للشخص البشري.
كما قام شيلر بوصف الوجود البشري على أنه مكون من بنية ثلاثية للجسم والروح، وكان التركيز الكبير للأنثروبولوجيا الفلسفية منصباً كذلك على العلاقات بين الأشخاص في محاولة لإيجاد توحيد طرق متباينة لفهم السلوك البشري كمخلوقات لبيئتهم الاجتماعية ومبدعي قيمهم الخاصة، كما كان تركيزها على تحليل علم الوجود، الذي يقوم بلعب دور هام في العلاقات الإنسانية، والذي تُعد التبادلية الداخلية موضوعاً رئيسياً فيه.
الحيز المشترك لدراسة كيفية فهم شخصين، وكيفية فهم موضوعاتهما وتجاربهما وتفسيراتهما للعالم، بشكل مختلف جذرياً ويتصلان ببعضهما البعض، كما اعتبر شيلر أن الذات أو الأنا قادرة على معرفة الآخر والتواصل معه من خلال حدس وجداني للمعاني التي يريد التعبير عنها ولمقاصده وانفعالاته ونواياه، وهو يؤكد على ذلك بقوله “أستطيع أن أقول لأحد من الناس بأدب وصواب إنك تقصد أن تقول شيئاً غير ما تقوله، إنك سيء التعبير”، وهو ما يعني أن الذات لا تُدرك الجسد وحركاته فقط، لكنها في نفس الوقت تستطيع المشاركة الوجدانية والتعاطف مع الغير، لأن الإدراك الخارجي لا يتم بمعزل عن الإدراك الداخلي، أي أن الغير أو الآخر وحدة كلية لا تقبل التجزئة إلى ظاهر وباطن، نفس أو جسم، لأن حقيقته تكمُن في ملامح تجلّ ناتجة عن حركات التعبير الجسدية، وهي التي تحمل دوماً دلالات ومعاني عمّا يبطنه من مقاصد وأحاسيس.
◄ الأنثروبولوجيا الفلسفية تُعد محاولة لتوحيد طرق متباينة، هدفها فهم سلوك البشر، مع تحليل علم الوجود، الذي قام بلعب أهم الأدوار في العلاقات الإنسانية، لتصبح التبادلية الداخلية موضوعا أساسيا فيه
جرى اعتبار الأنثروبولوجيا الفلسفية كمحاولة متكررة هادفة إلى الوصول إلى التفكير في الذات وذات الآخر، وذلك وفق تصورين أساسيين حددهما الفيلسوف الألماني كارل ياسبرز (1883 – 1969)، فعن الأول فهو إما أن يفكر في ذاته، للعمل بما يخصه شخصياً من أفعال أو مواقف يحيا بها العالم من خلال تجربته، وإما أن تصبح الذات عينها قابلة للمعرفة، وما دام الإنسان داخل مُجمل الحياة فيكفيه أن يرى بشكل جلي ما قد يخصُّه من نشاط وفعل، ليكتشف الحياة انطلاقا من تجربته المعيشة.
كما عنيت الأنثروبولوجيا الفلسفية عند ياسبرز بالخبرة الحياتية المعيشة، ودعوته إلى أن ينطلق الإنسان من سبر أغوار حياته الخاصة، كونه الإنسان الذي دوماً ما يبحث عن الحرية وعن الصدق، من خلال أقواله وأفعاله، وهو الإنسان الذي يعمل على رفع الحب وإرساء الحق فوق سلطة الكره والباطل، والذي يكون دوماً مناصرا للحق والحقيقة، بعيداً عن الاستعداد المكتسب الغريزي للنفس المريضة والضالة.
ولم يركن ياسبرز أبداً إلى ذاتية أنا وحدية، وإنما ركن إلى علاقة مشتركة بين الذوات، التي بات يُطلق عليها حالياً “حوار الحضارات”، أو مثل ما أطلق عليه الفيلسوف وعالم الإنسانيات الفرنسي بول ريكور (1913 – 2005) الفاعلية التداولية، وحتى يحافظ الإنسان على إنسانيته فقد وجب عليه أن يقوم بممارسة فعل الفلسفة، وهذا ما يعني بشكل ضمني أن من يبتعد عن الفلسفة ويرفض طلبها لا يُعد إنساناً، ومن خلال كل ذلك يتضح أن الأنثروبولوجيا الفلسفية لا يمكن دراستها أو تدريسها إلا في حالة اعتبارها تجربة معيشة.
ومن خلال ذلك المنظور، برز وعي أدى إلى تحولات اجتماعية مذهلة، في علاقة الذات عينها، وعلاقة الذات بالآخر، وعلاقتهما سوياً بالزمانية، ولا يكاد يكون له من تجربته الحياتية سوى الكوارث الطبيعية والتي كان هو سببها الرئيسي، لذا باتت مسألة الاهتمام بالإنسان ضمن محيطه الحضاري والثقافي من الإشكالات القديمة والجديدة معاً، وبصورة بدت أبدية، وكان أساس تلك الإشكالات القلق والرهبة والخوف والمرض والحروب، وفي نهاية المطاف يكون الموت.






















