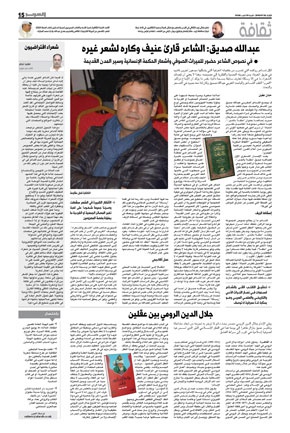الأرياف والمدن تتبادل الاتهامات في مسؤولياتها عن صناعة التطرف

الريفي يهاجر إلى المدينة في عالمنا العربي، ولا يحمل معه حقيبته وطموحاته فحسب، بل ما خفي من أنماط تفكير وسلوك تظهر عند أول تصادم واحتكاك مع ذهنية المجموعة القاطنة في تلك التجمعات الحضرية التي قصدها، وإن كانت الغايات والدوافع التي جاءت بهذه التجمعات البشرية إلى المدن، لا تختلف كثيرا عن بعضها ولا تتباين.
الأكاديمي والباحث الاجتماعي السعودي، مازن عطية، أوضح أن هناك أسبابا طاردة في الأرياف وأخرى جاذبة في المدن، تقع خلف ستار الهجرة، مستعرضا العوامل الجاذبة في المدن بالقول إن «المحفزات الاقتصادية، وفرص العمل التي تحسن دخل المهاجر، إلى جانب الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، ووسائل الترفيه والحياة العصرية، تصنف كعوامل جاذبة لغالبية المهاجرين، فيما يفتقدها سكان الأرياف”.
أسباب هجرة الريف العربي إلى المدينة، لا تخفى على أحد، وهي متعلقة بالمسألة التنموية بدرجة أولى، ففي غياب أي مساع حكومية حثيثة لتنمية الريف وتأمين الخدمات فيه، كي يكون مقرا للسكن، وتخصيص المدن للعمل فقط، إلى جانب العقلية السائدة في مجتمعاتنا والتي ترفض فكرة السكن بعيدا عن مكان العمل، وتفضّل شراء منزل في قلب المدينة لتجاوز مشكلة البعد في المسافة.
كل هذا يتم في الوقت الذي يفضّل فيه مواطنو الدول المتقدمة السكن في الريف الذي يتمتّع بخدمات تضاهي ما بالمدينة، إلى جانب انخفاض معدلات التلوث وانعدام الضجيج والازدحام، ولذلك تتقبّل شعوب هذه الدول فكرة قطع مسافات طويلة بالسيارة أو باستخدام وسائل النقل العامة للوصول إلى أماكن العمل التي تختص بها المدن.
هذا الحرمان الذي عانى منه الريفي في البلاد العربية قبل وصوله إلى المدينة، سوف ينعكس -وبلا شك- على سلوكه وردّات فعله إزاء قضايا كثيرة كشكل من أشكال الانتقام، أو حتى كآلية دفاع، علما أنّ الحرمان الذي كان يعاني منه ريفيون كثيرون، اختاروا الاستقرار في مراكز المدن، لم يتبدّل كثيرا إلاّ في بعض مظاهر الاستهلاك، هذا إذا لم نقل إنّ الأمر قد زاد بؤسا واغترابا، لكنّ العودة إلى الريف تصبح شبه مستحيلة، وعندئذ تتمّ هذه العودة عبر مجموعة سلوكيات وأنماط تفكير، في ما يشبه ردّة الفعل.
العلاقة بين ترييف المدن العربية والتطرف، تتأتى عبر عدة نواح متداخلة، أهمها الثقافية وأزمة الهوية والمستوى الاقتصادي، فترييف المدن يصاحبه نزوع إلى ثقافة تقليدية محلية متشددة وغير منفتحة، تؤدي إلى تهميش أو تراجع الدور المدني التحديثي والتنويري والإبداعي، والثانية هي أزمة البحث عن الهوية واغتراب قيم الريف والبداوة عن القيم المدينية.
ظاهرة التطرف تجد طريقها إلى المدن والأرياف على حدّ سواء، ولكن بأساليب مختلفة من حيث الحجم والتمظهر ودرجة الخطورة، ذلك أنّ أسبابها تكاد تكون واحدة، على اعتبار التداخل الهائل بين الريف والمدينة في العالم العربي.
مدن خضعت لسطوة الريفيين وطباعهم
|
حالات اتهام المدينة في الذهنية العربية السائدة، بشتى أشكال القسوة والتفسخ الأخلاقي والاجتماعي والظلم والانبتات، قديمة قدم القرية والقرويين، وهي في عمومها ردّات فعل طبيعية، ومتأصلة في الذات البشرية التواقة إلى منابع السكينة والصفاء، كشكل من أشكال الحنين إلى فردوس مفقود.
الأمر لا يتوقف عند هذا الإحساس الإنساني والطبيعي لدى أبناء الأرياف في العالم العربي، بل يتعدّاه إلى سلوك أقل ما يقال فيه، بأنه عصابي، ويأخذ أشكالا عدائية في غالب الأحيان، تصل إلى حد التصادم والتجريح والتشكيك في القيم الأخلاقية.
لا يختلف اثنان في أن المدينة، هي صورة للقوة والفقر والحرمان والضعف، فمن هذا التعريف نستنتج أنها تعتبر العمران المنظم والحضارة والتاريخ والتقدم والرقي والمجتمع المبني على تشريعات وأنظمة سياسية واقتصادية وأمنية وعلمية، والتطور البشري في أصله، يبدأ بقرية تتحول إلى مدينة، وليس العكس، كما يحدث في الكثير من الحواضر العربية المشهود لها بالعراقة.
يقول الكاتب العراقي همام طه، وبتأثر بالغ ممّا أصاب الحواضر والمدن العراقية من تغييرات وصفها بالتفخيخ الديموغرافي “لم تعد هناك مدينة أو حاضرة، لا بغداد ولا البصرة ولا الموصل؛ إنها مسارح لأشكال التخلف الاجتماعي والثقافي والخدمي والقيمي، وكذلك للتطرف والعنف بأنواعهما، وهذا العراق المتريّف اليوم، هو الذي يحتضن هذه العملية السياسية البدائية، العشوائية، الشفوية، وذات الطابع الارتجالي”.
يقول الباحث سعد الصوبان في لهجة وصفها محاوره بـ”التحامل” أثناء مقابلة تلفزيونية “إنّ العقلية الريفية عقلية سكونية راكدة، لا تعترف بالتغير وترفض التطور وتفتقر إلى الحركية والمرونة الكافية للتعامل بشكل عقلاني وخلاق مع المستجدات والتحديات”. ويضيف الباحث “طبيعة العقلية الريفية أنها عقلية محافظة، تشكك في الحاضر وتخاف من المستقبل بينما تقدس الماضي إلى درجة تصل عند البعض إلى حدّ عبادة الأجداد”.
الثابت أنّ الأمر قد وصل إلى حدّ أن البعض أشهر السلاح في وجه البعض الآخر منا، وصوب المتطرفون أدواتهم التدميرية لكل منجز حضاري، مثلما صوبوا سهام التكفير والإلحاد والتصفية الجسدية لكل من يحاول البحث عن مخرج عقلاني من مأزق التخلف الذي تئن المجتمعات العربية تحت وطأته.
الوازع الديني في المجتمعات الريفية، يتصف باللين والبعد عن التشدد، ذلك أن طبيعة الحياة الزراعية، ومشاركة المرأة للرجل، تجعلان من المسألة الدينية لا تتجاوز كونها إيمانا عاديا
وفي دراسة للمركز العربي للبحوث والدراسات جاء أن أغلب قيادات أعضاء الجماعات التكفيرية، هي من الجنوب، وبالتحديد من محافظات بني سويف والمنيا والفيوم وأسيوط وقنا، وهي من المحافظات الأكثر فقرا، وتتركز فيها الثروة في يد عائلات تمكنت عبر جميع الحكومات المتتابعة من احتكار الثروة.
وتضيف الدراسة أنّ مسألة التطرف لا تقف عند غياب التنمية عن الريف الصعيدي، بل تبدأ من هذه السيطرة القبلية لجماعات أو عائلات، احتكرت الثروة والسياسة وفرص التطور. وكما يقول بودريار إن الإرهاب صنيعة الهيمنة إذ “أنه الظل المرافق لكل نسق من الهيمنة، وهو موجود في صلب هذه الثقافة التي تحاربه”.
ليس من الصواب، طبعا، أن نقارن بين الريف والمدينة مقارنة أخلاقية قيمية بين سيء وجيد، بل هي مقارنة أسلوبية بين نمط حياة تقليدي وآخر حديث، فقد تكون المدينية وعاء لأخلاقيات غير مقبولة، لكن الأغلبية المطلقة من أهل الريف تخضع لمعادلة بسيطة، وهي عدم مغادرة الأرض طواعية، وعندما تصبح السلطة “أرضا جديدة”، تصبح عندئذ المطلب الأسمى، وتنتقل الشهوة من ميل جارف للتعلق بالأرض، إلى ميل مقابل متعلق بالسلطة وهي الأرض الجديدة، وينتج عن ذلك ترييف المدن وسيادة الأيديولوجية الريفية.
الدارسون والمتخصصون يتفقون على أنّ التطرّف هو ردات فعل غير متزنة على حالات وسلوكيات، يراها المتطرف لا تناسب منطقه وثقافته، كما أنه شكل من أشكال حماية الذات في نظر صاحب السلوك المتطرف، ممّا يضمن له الاستمرار دون الذوبان مع المجموعة البشرية التي يعاديها، هذا بالإضافة إلى العوامل الثقافية والأسرية وحالات الاستقطاب المنظمة من طرف الشبكات الإرهابية التي تتمركز في المدن طبعا.
خبراء متخصصون في أوروبا أكدوا أن ذوي الأصول الريفية في بلدانهم الأصلية، شكلوا مصدرا للتجنيد والاستقطاب، وذلك لكون العلاقات داخلها تتأسس على الولاء والطاعة بين الآباء والأبناء. وأوضح الباحث البلجيكي بيير فيرميرن، في هذا الصدد “أن بنية المجتمع الريفي تتميز بـانتشار قيم ومفاهيم مثل الشرف والانتقام والعرض والانصياع للأوامر و«الثورة»، وهي القيم التي تدفع العديد من الشاب إلى رفض الآخر ومن ثمة يشكلون فريسة للتنظيمات الإرهابية المتطرفة”.
ريفيون ظلمتهم السياسة في عيشهم وتفكيرهم
|
دراسات كثيرة تؤكد أنّ الوازع الديني في المجتمعات الريفية، يتصف باللين والبعد عن التشدد، ذلك أنّ طبيعة الحياة الزراعية، ومشاركة المرأة للرجل في الحقل وباقي الأعمال اليومية، تجعلان من المسألة الدينية، لا تتجاوز كونها إيمانا عاديا، وأداء لشعائر تعبدية، لا تخرج من سياقها الاجتماعي.
الديانات والعقائد والمذاهب، استوطنت في المدن، وليس في الأرياف والقرى والبوادي، وذلك لأسباب عمرانية وبشرية وسياسية وفكرية واضحة ومعروفة، ذلك أنّ الجدل يكثر ويزيد بكثرة الناس وتنوع مشاربهم ومصالحهم، أمّا في المناطق الريفية فالأولوية في حياة الناس، هي لمعيشتهم وزراعتهم وما تقتضيه مصالحهم التي تتطلّب التوادد والتعايش، وليس الجدال والغلو.
يقول الباحث محمد جابر الأنصاري “في نظرتنا لمجتمعات التسامح يجب أن نفرّق بين عربين، عرب البيئة الصحراوية الذين تعودوا الصراع اليومي من أجل البقاء، بحيث يصبح التسامح هنا شيئا من التهاون في حق الذات وحق الجماعة، وعرب البيئات الحضرية أي الذين سكنوا تجمعات المدن الصغرى في الوديان والواحات وعلى حواف الصحراء، وكذلك عرب الطبيعة النهرية التي يتعامل فيها الناس مع نهر يمر عليهم وعلى غيرهم وعليهم جميعا أن يتفاهموا على تقسيم هذه المياه، ولا بدّ أن يسود بينهم مناخ من التسامح والتآلف، يفرضه انتظار الفيضان ومواقيت الغرس والبذر والحصاد”.
ربما يفيدنا هذا الرأي المبني على دراسات أنتروبولوجية، إلى ضرورة التفريق بين نماذج لسكّان الريف والقرى ذات الأنماط والأحجام المتعددة في العالم العربي، ومع اختلافات واضحة بين بلد وآخر، فليس من المنطقي أن ننظر إلى كل الريفيين على درجة واحدة من الطباع والتفكير، وبعيدا عن الآراء ذات المعايير القيميّة، فابن البيئة الزراعية والجبلية، أكثر ميلا للانفتاح من غيره في مناطق ذات طبيعة قاسية، وذلك بحكم طبيعة علاقات الإنتاج والعوامل المناخية وغيرها.
التجمعات السكنية ذات الكثافة العالية، شكلت ولا تزال، مجالا حيويا لتحرك الجماعات التكفيرية، وفضاء مناسبا لنشاطاتها، ثم إن تمركز دور العبادة التي جعل المتطرفون من بعضها منابر لخطابهم التكفيري، لا توجد مثيلاتها في القرى والأرياف التي يعرف أفرادها بعضهم بعضا، ويصعب على الجماعات الإرهابية التخفي في القرى، كما يفعلون عادة في المدن وأحزمة الفقر، ذات الكثافة السكانية العالية.
طبيعة العقلية الريفية أنها عقلية محافظة، تشكك في الحاضر وتخاف من المستقبل، بينما تقدس الماضي إلى درجة تصل عند البعض إلى حد عبادة الأجداد
أمر آخر لا يمكن إنكاره، ويتمثل في أسباب ابتعاد الريفيين عموما عن التطرف، وهي حالات الصفاء الذهني والاجتماعي، واقترابهم من الطبيعة، خصوصا في المناطق الزراعية والجبلية، وهذا من شأنه أن يكسبهم شيئا من الاعتدال والتوازن، كل ذلك، بالإضافة إلى غياب جهات الاستقطاب وندرة وسائله المعهودة، وهي وسائل التواصل الإلكتروني، والتي عادة ما تعجّ بها المدن والتجمعات السكنية الكبرى.
الريفيون ينزعون بطبيعتهم إلى البساطة والتلقائية، والبعد عن التعقيد في كل مظاهر الحياة، والتي تشمل التدين بطبيعة الحال، ثم إنّ أهالي القرى بعيدون عن كل أشكال المحرّضات التي قد تستفزّ طبيعة تربيتهم، وهذا أمر كفيل بالسير في طريق التعايش والسلم الأهلي. ثمة جانب آخر، يلاحظه كل المتتبعين لتاريخ الفكر والثقافة والفنون في البلاد العربية، وهو أنّ روّادا كثيرين في هذه المجالات، هم من الريفيين الذين جعلهم التعطش إلى العلم ومعرفة الآخر، سبّاقين إلى قيم التسامح ومدّ الجسور مع الثقافات المختلفة.
نعم، يمكن الإقرار بأنّ المدنيين أصبحوا قلّة في أغلب المدن العربية، ورغم أن الكثير من كبار المفكرين العرب الأفذاذ ورواد الثقافة التنويرية هم من أصول قروية أو بدوية، فإنه يكفي أن البعض من المهاجرين إلى المدن -وهم قطاعات اجتماعية ضخمة- رفض الاندماج في ثقافة المدينة، التي لم ير فيها سوى غربة روحانية وثقافية، وخراب اجتماعي واقتصادي وفقدان للحماية، فلجأ قسرا إلى خبرته السابقة في الانعزال (المناطقي أو القبلي أو الطائفي) والانغلاق والتعصب، لتتهيأ بيئة قد تكون خصبة لأفكار التطرف والعنف والانحراف؛ إذن لا بدّ من خلق توازن بين المدينة العربية وريفها، وهذا تحدّ كبير يحتاج وقفة أخرى ومراجعة متأنية.
أمّا على مستوى الموروث الثقافي، وبعيدا عن مسألة التطرف، فيقول الباحث التونسي محمد المدب “لا شك أننا خسرنا الكثير من تلك المواجهة «الساخرة» بين شخصيتي البدوي والحضري، فلقد أضعنا تراثا غنائيا كاملا، وفرّطنا في كثير من عاداتنا الغذائية السليمة، وقلبنا موازين بيئية واجتماعية واقتصادية، انتصرت المدينة على الريف لأنها كانت تمتلك أجهزة الراديو والتلفزيون، لكن الانتصار كان عابرا خادعا، إذ لم يلبث أن التحق الريف بالمدينة التي تضخّمت وتزيّفت، وافتقر الريف إلى أصالته.