أدب لا يكتبه العرب خوفا من القراء

يرسم المبدعون حدائق من البهجة والمتعة عبر كتاباتهم الروائية والقصصية، وقد يصنعون عوالم واسعة وسيرا مشوقة وحكايات مُتخيلة، تستمد بعض جوانبها من الواقع، يمدون خيوط استمتاع وتشويق بحبكات وموضوعات لافتة تجتذب عيون مُحبي القراءة شرقا وغربا، لكن تبقى سير الكتاب من أكثر الأعمال إثارة لفضول القراء، لكنها عربيا أدب منقوص وخائف.
الكثير من الكتاب يُقيمون جسورا من الألفة والصداقة الورقية والمودة مع قراء كثر لا يعرفونهم، متنوعي المآرب ومُختلفي الأذواق، ويتعايشون مع أبطالهم، ويفتشون بين ثنايا القصص عن لحظات بوح ذاتية يتعرفون منها على ملامح وسمات وصفات للكتاب أنفسهم.
يتمدد الفضول رويدا لدى جماهير القراء للتعرف على تجارب الكُتاب أنفسهم، ما شكل لغتهم، وعزّز مواهبهم، وفتح أمامهم نوافذ الإبداع، ما عانوه من أوجاع إنسانية، وما واجهوه من إحباطات في طريق الكتابة.
يتلهف القراء على أسرار وخبايا مَن يحبون. قصص عشقهم، ولحظات ضعفهم الإنساني، وتحولاتهم الفكرية والسياسية، وآراء الآخرين فيهم، وآراؤهم في معاصريهم من مبدعين ومثقفين وشخصيات عامة.
لذا أصبحت كل سيرة مدونة وكل كتاب مذكرات منشور لروائي أو قصاص أو شاعر محل اهتمام والتفات من جمهوره المُحب أو غير المحب على السواء.
لهفة القراء
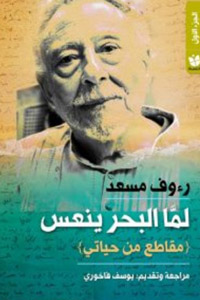
رغم قلة سير الروائيين، وندرة مذكراتهم، إلا أنها تبقى بمثابة رمية حجر في بحيرة راكدة، فما أن تصدر سيرة لأحدهم تحمل بوحا صريحا حتى تمتد جلسات النميمة ويتجدد القيل والقال، ويغضب البعض، ويمتعض آخرون، وتعلو الأصوات المنكرة تحت لافتة رفض البوح وترك العظام الراقدة في سلام ترقد في سلام، ويتكرر مصطلح “تصفية الحسابات” باعتباره سيفا مُرهبا لباقي الأدباء من السير في الطريق ذاته.
لم يكن غريبا أن تُثير سيرة الروائي المصري المهاجر إلى أوروبا رؤوف مسعد، والصادرة قبل أسابيع عن دار النسيم بالقاهرة، تحت عنوان “لما البحر ينعس”، عواصف من الجدل، وتُنشئ محاورات ساخنة نظرا إلى ما تضمنته من وقائع ومواقف وأسرار تعلقت بكثير من المبدعين المعروفين.
تحكي سيرة مسعد، والتي أضاف لعنوانها عبارة جذابة هي “مقاطع من حياتي” بداياته الإبداعية، وكيف توهجت موهبته خلال فترة سجنه بتهمة الشيوعية، وتعرضه للفقر المدقع الذي عاشه، والإحباطات المتكررة في الساسة والشخصيات العامة، وتبدلات وتحولات المثقفين وعلاقاتهم مع السلطة، ليطرح آراء قاسية وصادمة في مبدعين كبار، مثل محمود أمين العالم، ويوسف
إدريس، وصافيناز كاظم، وعبدالرحمن الأبنودي. وتحدث الرجل بصراحة تامة عندما يُشير إلى موقفه الديني وكيف تحول من ابن قسيس بروتستانتي إلى شخص لا ديني.
تثُير سير المبدعين في العالم ضجيجا مبالغا، نظرا إلى صلة الارتباط الوثيقة القائمة بين هؤلاء المبدعين وقرائهم، ولاشك أن ذلك كان واضحا في سيرة الروائي الكولومبي غارسيا غابريال ماركيز، والمعنونة بـ”عشت لأروي” وتميزت بالصراحة الشديدة واللاخجل، مستندة إلى أسلوب سردي يتشابه كثيرا مع كتاباته الروائية.
يرى البعض أن فتح خزائن الأسرار للمبدع هو ما ينتظره جمهوره منه. ماذا فعل، وماذا فكر في فعله، وما خاف من فعله، وما خجل منه، وما أخطأ فيه، وما ندم عليه، وما أشعره بالاشمئزاز من نفسه. بمعنى آخر ينتظر القراء من المبدع أن يتعرى تماما أمامهم لأنهم يتصورون أن كونهم قراء له، فإن من حقهم عليه أن يرونه بلا أقنعة ولا مساحيق تجميل.
يقول الناشر المصري محمد هاشم، صاحب ومدير دار ميريت للنشر بالقاهرة، إن السير الذاتية الصادقة هي التي تحظى برضاء وإعجاب جمهور القراءة، بغض النظر عما يؤدي إليه ذلك الصدق من نتائج وجدل.
ويؤكد لـ”العرب” أن سيرة ماركيز قدمت إجابات شافية لكل شخص لديه سؤال، لأنها مغرقة في التفاصيل، ومكتوبة دون حرج أو خوف، وتعرضت لأمور عديدة قد يعتبرها البعض شخصية، فهي تناولت حكايات عديدة عن الجد والعمة والأم دون حرج، وهذا ما يعد نموذجا مثاليا لسير المبدعين.
وقدم معظم الروائيين العالميين سيرا اتسمت جميعا بالصراحة والصدقية، لذا بدت سيرة الروائي اليوناني نيكوسكازانتزاكس التي حملت عنوان “تقرير إلى غريكو” ممتزجة بالذاتي إلى أقصى درجة وغارقة في الاعترافات والبوح الصادق الذي يُقدمه كرسالة إلى جده الأكبر غريكو.
وقدمت الروائية الصينية تنغ سنغ بي سيرتها بعنوان “ورقة الرياح القاسية” لتكشف للقراء بطريقة روائية حكايات حياتها، نشأتها، شبابها، ووقائع الثورة الصينية، وموقفها منها.
وتتنوع النماذج الأخرى لسير المبدعين الذين قلبوا العالم بكلماتهم مثل الشاعر التشيلي بابلو نيرودا وكتابه الشهير”أشهد أنني عشت”، أو الشاعر الداغستاني رسول حمزاتوف وسيرته المعروفة بـ”داغستان بلدي”، أو النمساوي شتيفانتسيفايغ في كتابه “عالم الأمس”، في تبويبها ولغتها وأسلوبها، لكنها تتفق جميعا في عنصر هام هو الصراحة الشديدة.
التحفظ عن الكتابة
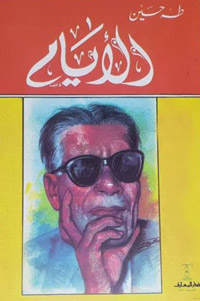
إذا كان العالم العربي دخل سير الأدباء مبكرا منذ بدايات القرن الماضي، لنقرأ كتاب “الأيام” للأديب المصري طه حسين، و”أشلاء سيرة ذاتية” لأحمد حسن الزيات، وكتاب “حياتي” لأحمد أمين، إلا أنه كان من الواضح نزوع كثير من السير إلى التورية والتجمل والوقوف على مسافة ما من الحقيقة تحت باب الحفاظ على الخصوصية أو احترام التقاليد والأعراف المجتمعية السائدة.
ومع تطور الحركة الإبداعية، وزحف الحداثة، فإن الموجات التالية لسير الأدباء حتى الألفية الثالثة مثل “السيرة الطائرة” للشاعر والروائي الفلسطيني إبراهيم نصرالله، أو “أثقل من رضوى” للروائية المصرية رضوى عاشور، أو “يوما أو بعض يوم” للكاتب محمد سلماوي لم تحمل اعترافات أو مكاشفات تخص الذات.
ويمكن ملاحظة أن السير التي حوت اعترافات خاصة أو بوحا حقيقيا كانت نادرة، لكنها بقيت كعلامات فارقة في تاريخ الأدب الحديث بدءا من كتاب “سبعون” للكاتب اللبناني ميخائيل نعيمة، والصادر في ثلاثة أجزاء، وحتى مذكرات لويس عوض المعروفة بـ”أوراق العمر” وكتاب “النميمة” لسليمان فياض، و”ماذا علمتني الحياة؟” لجلال أمين.
يوضح ميخائيل نعيمة مثلا في سيرته اعتزازه بالبوح التام والاعترافات الكاملة فيعبر في مقدمته عن شعوره باللذة إذا تعرى من أسراره وأوزاره وأصبح بيتا من زجاج مكشوف كل ما فيه للعابرين.
وفي تصور الكاتب المصري أحمد الخميسي، فإن سير الروائيين والمبدعين العرب قليلة إلى حد ما وستظل قليلة لفترة طويلة رغم الأهمية الكبرى التي تمثلها.
ويقول في تصريحات خاصة لـ”العرب” إن فن السيرة بشكل عام يمثل لحظات بوح مثالية تُحلق بالسارد في سماوات بلا حدود، وتمنحه بحبوحة من القدرة على التعبير عن مكنون الذات.
ويرى أن قلة السير والمذكرات، وتحفظ معظمها في العالم العربي يرجعان إلى أن وحش الخوف يبتلع الكتابة قبل أن تظهر حروفها الأولى، فهناك خوف من المجتمع وتقاليده، وهناك خوف من جرح الآخر، وخوف من تدمير العلاقات الاجتماعية مع الوسط الثقافي والصحافي.
ويشير الخميسي إلى أن ابن أخت الأديب نجيب محفوظ أقام دعوى قضائية لمجرد أن محفوظ صرح يوما ما بأنه كانت له مكتبة في بيت أخته وفقدت، لذلك فالخوف يحطم الكتابة قبل أن تتبلور وتجد طريقها للسكن فوق صفحات الكتب.
ويقول الكاتب المصري يوسف القعيد لـ”العرب”، إن المجتمع العربي لا يرحب بمن يتسلل إليه من ثقب الباب، ويكتب دون إشارات مرور، فأدب البوح في بلادنا موصوم دوما بالفضائحية والخروج على قيم المجتمع، ويُنظر إليه نظرة استهجان، فالمجتمعات العربية تضع ألف حاجز وحاجز أمام أدب البوح والاعترافات، تارة بالتسفيه والاستهجان، وتارة أخرى بالتجاهل والنسيان في ما بعد.
وشهدت السنوات الأخيرة اتساعا لتيارات السلفية في الشارع العربي، بما تحمله من رؤى انغلاقية، إلا أن يوسف القعيد يرى أنه حتى في حال عدم غلبة هذه التيارات فإن المجتمعات العربية نفسها بسمتها وخصوصيتها لا ترحب بأدب البوح.
قلة السير والمذكرات وتحفظ معظمها في العالم العربي يرجعان إلى أن وحش الخوف يبتلع الكتابة
مثل هذه القيود تدفع بعض الروائيين العرب إلى حيلة توزيع سيرهم الذاتية في ثنايا إبداعاتهم، فنجد مثلا حكايات لمثقفين معاصرين لنجيب محفوظ في بعض رواياته مثل “المرايا” و”قلب الليل” و”اللص والكلاب” وغيرها.
ويلفت الناقد خيري حسن، لـ”العرب” إلى أن القليل من الأدباء يتحملون جرأة القول والقدرة على الاعتراف والكشف عن الذات فيقدمون سيرهم، لكن الأغلبية منهم يكتبون سيرهم بشكل غير مباشر عبر الأدب نفسه، وتكاد تقرأ محيط كل أديب في رواياته، ويصل بك الأمر أحيانا لتخمين شخوص حقيقية تراها في المجتمع حولك.
وهناك لون آخر لسير الأدباء ظهر في الآونة الأخيرة، حيث يطرح فيها البعض تجاربهم الذاتية بطريقة مختلفة تُركز على تجاربهم الإبداعية وحدها دون التطرق إلى الشخصيات العامة، ومنها مثلا كتاب “ما وراء الكتابة” للروائي المصري إبراهيم عبدالمجيد، الذي قدم فيه حكايات رواياته، وأجواء ميلادها، وكيفية اختمار أفكارها في رأسه، ثُم انتقالها إلى الورق، وهو أسلوب جديد يحاول البوح بمقدار علاقة الكاتب مع النص وحده دون تداخل أو اشتباك مع الآخرين.
ويرى البعض من النقاد أن ذلك اللون يُشكل سُلما للأجيال الجديدة من المبدعين للاستفادة من تجارب الأدباء السابقة والبناء عليها في المستقبل، لكنه بالطبع لا يروي ظمأ الاعترافات الذاتية وكشف مكنونات معشر الكتاب.




























