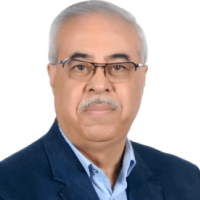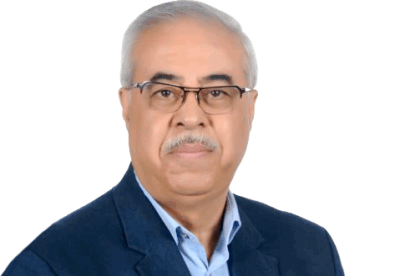تسعة أعوام على الانقسام الفلسطيني
مضت تسعة أعوام على انقسام النظام السياسي الفلسطيني (يونيو 2007)، وقيام سلطتين، واحدة لحركة “فتح” في الضفة والثانية لحركة “حماس” في غزة، وإضافة الفصل السياسي إلى الفصل الجغرافي بين هاتين المنطقتين، المفترض أن تشكلا الكيان السياسي الفلسطيني بموجب اتفاق أوسلو.
رغم الحصار الذي فرض على غزة ورغم تقييد حياة قرابة مليوني فلسطيني، مع ثلاث حروب (208 و2012 و2014) مدمرة، فإن اتفاقات المصالحة التي عقدت في مكة وصنعاء والدوحة والقاهرة، لم تفلح في دفع فتح وحماس إلى التوصل لإنهاء الانقسام.
مع الزمن يبدو أن الفصل بين الضفة وغزة، ووجود كيانين يتنازعان المكانة والتمثيل، بمثابة أمر عادي في المشهد الفلسطيني، كما بات يظهر أن ثمة على الجانبين قوى تجد مصلحتها في استمرار الانقسام، لأنها باتت تتعيّش عليه أو تستمد منه مكانتها وامتيازاتها. فوق كل ذلك فإن تحوّل “فتح” و“حماس” من حركتي تحرّر وطني إلى سلطة، كل في حيزه الجغرافي، أضعف من إدراكهما للمسؤولية الوطنية وللمخاطر التي يمكن أن تنجم عن استمرار الانقسام، في واقع يفتقر لعلاقات التمثيل والمراجعة والمساءلة والمحاسبة.
طبعاً لن نضيف شيئا إذا قلنا إن إسرائيل هي المستفيد الأول من هذا الانقسام، وأن الفلسطينيين، مع قضيتهم، هم المتضرر الأول منه، لكن المسألة أخطر من ذلك بكثير، إذ أن الانقسام الفلسطيني، على هذا النحو، بات أحد علامات تفكك الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة. فوق ذلك فإن هذا الانقسام له مضاعفات خطيرة، بالنظر لتشتت مجتمعات الفلسطينيين، ما ينعكس سلبا على إدراكهم لوحدتهم ورؤيتهم لمصيرهم، وهو الأمر الذي لا يبدو في مركز اهتمامات فتح وحماس، إلى الدرجة اللازمة.
في النصف الأول من القرن الماضي اتسم تاريخ الفلسطينيين، في صراعهم ضد الانتداب البريطاني والاستيطان الصهيوني، بالتنازع على النفوذ والمكانة بين أقطاب الأسرتين الحسينية والنشاشيبية، الأولى بزعامة الحاج أمين الحسيني، والثانية بزعامة راغب النشاشيبي، ما بدّد طاقات الفلسطينيين وأفاد اعداءهم. وكانت سلطة الانتداب آنذاك، قد استثمرت في هذا الانقسام بل اشتغلت على تغذيته، فقد عيّنت في ذلك الوقت زعيم الأسرة النشاشيبية رئيسا لبلدية القدس (1920)، وعينت الحاج أمين في منصب المفتي (1921-1937) للموازنة بين الطرفين. وبينما اتكأ الحسيني على موقعه كمفت وعلى المجلس الإسلامي الأعلى وعلى الحزب العربي الفلسطيني، فإن النشاشيبي اتكأ في صراعه مع غريمه، على رئاسته بلدية القدس (حتى 1934)، ثم على زعامته لحزب “الدفاع”. وعليه لم تنجح تجارب “اللجنة العربية العليا” (1936)، والهيئة العربية العليا (1946) في التخفيف من التنافس بين الجانبين، ما انعكس سلبا على الحركة الوطنية للفلسطينيين.
أسهم هذا الوضع في إضعاف استعداد الفلسطينيين لمواجهة العمليات التي تقوم بها الجماعة الاستيطانية اليهودية لإعلان دولتها (1948)، مع ملاحظة أن هذه الجماعة نجحت في إقامة مؤسساتها الكيانية الأولية في حضن الانتداب البريطاني، في حين أخفقت الحركة الوطنية الفلسطينية في ذلك، بسبب قيود دولة الانتداب عليها، لكن ذلك حصل أيضا بسبب انقساماتها.
عندما أزفت لحظة الحقيقة في إقامة دولة إسرائيل، كان الفلسطينيون في حالة ضعف، ولم يكونوا مهيئين لمواجهة هذه اللحظة، ما يفسر كل ما جرى في ما بعد، من سرعة انهيار مجتمعهم، إلى تشرد معظمهم، وصولا إلى إقامة إسرائيل، وضمنه خضوع الأراضي الفلسطينية التي ظلت خارج السيطرة الاسرائيلية للأردن (الضفة الغربية) ولمصر (قطاع غزة). أي أن ضعف الحركة السياسية الفلسطينية ليس فقط سهلت إقامة إسرائيل وإنما لم تستطع تخفيف آثار قيام إسرائيل، ولا إقامة كيان فلسطيني في الضفة والقطاع.
بإمكان “فتح” و“حماس” إنهاء الانقسام، فالفوارق السياسية باتت ضئيلة بعد أن بدا أنه ثمة توافق على هدف إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع، وبعد أن ذهب الطرفان، إلى التهدئة أو الهدنة، كل بمصطلحاته. علما أن العمل السياسي يفترض الاختلاف الذي يمكن تنظيمه بالوسائل السياسية، لا بالانقسام، لكن ذلك يتطلب نظاما سياسيا لا يتأسس على المحاصصة والهيمنة، وإنما نظاما سياسيا يتأسس على التمثيل والاحتكام للأطر التشريعية وعلى الديمقراطية.
كاتب سياسي فلسطيني