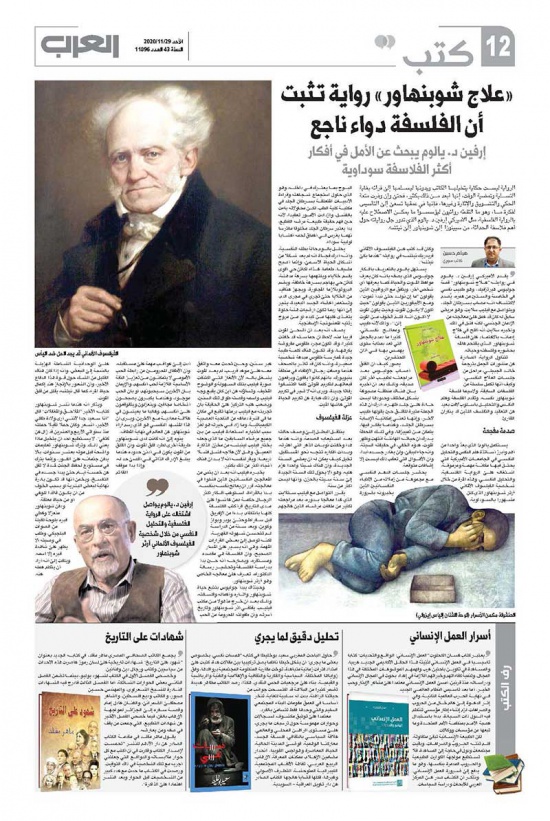الوصمة السلبيّة العالقة بشباب الأحياء الشعبيّة تعمق شعورهم بالإقصاء

يشعر الكثير من الشباب التونسي بالظلم على كافة الأصعدة وعدم الإنصاف خصوصا بالنسبة لسكان الأحياء الشعبية التي ارتبطت في الأذهان بتفشي الجريمة وعدم الانضباط وانتشار الفكر الإرهابي، إذ يتم تحديد طبيعة العلاقة بينهم وبين مؤسسات الدولة وعناصر الأمن على أساس مكان السكن، قبل سلوك الشخص.
تونس – يرى علي 26 عاما من سكان تونس العاصمة أنّه “إذا كان عنوان إقامتك في بطاقة التعريف الوطنية أنك من سكان أحد الأحياء الشعبية غرب العاصمة، فإن النظرة السلبية والإذلال سيلاحقانك حتى لو كان لديك مورد رزق وليست لديك أي سوابق في مخالفة القانون خصوصا عند التعامل مع الشرطة، فمكان السكن أحد التقييمات التي تحدد قيمتك كإنسان”.
علي واحد من آلاف الشباب التونسيين الذين يشعرون بانعدام المساواة والظلم الاجتماعي، لعدة أسباب يختلف حولها الكثيرون بين من يعتبرها أسبابا محقة نتيجة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وجعلت الجيل في مهب الرياح لا يملك الحاضر أو المستقبل، وبين من يعتبرها مبالغة وتهاونا من جيل لا يحب العمل ويريد أن يحصل على كل شيء بسهولة.
ويرفض والد أحمد هذه النظرة المتشائمة لشباب اليوم، ويعتبر أنهم يتحملون مسؤولية كبيرة في البطالة وسوء الأوضاع، وأن شريحة واسعة من الشباب الذين يشتكون من احتقار المجتمع لهم، يرفضون القيام بأعمال عادية مثل البناء أو الفلاحة أو المهن اليدوية بل يحتقرونها، حتى أصبح العمال الأجانب يقومون بها.
ويعتبر في انزعاج شديد، أن شباب اليوم يحبون رواتب جيدة ووظيفة مريحة. شباب يرفضون تحمل أدنى قدر من المسؤولية ويرمون باللوم على الدولة، المجتمع، العائلة، الحظ، البلاد، وينقمون على الجميع ويرمون أنفسهم للمهالك في إدمان الحشيش والكحول والحبوب المخدرة.
ورغم اختلاف الآراء حول أن الشريحة الواسعة من الشباب يشعرون بالإحباط وانعدام المساواة على مختلف الأصعدة، ويلاحظ خبراء الاجتماع أن الشعور بالتهميش واليأس والظلم يبلغ أعلى مستوى في المناطق الشعبية في السنوات الأخيرة، باعتبارها الأكثر تأثرا بتدهور الأوضاع، فقد تشكلت هذه الأحياء منذ بداية السبعينات في محيط العاصمة وغذتها هجرة أبناء الريف بصورة كبيرة.
ومع تعطّل قطاعات اقتصادية مثل التصنيع وانحصاره في قطاعات محدودة، كالصّناعات التحويليّة وصناعة الملابس والنسيج، دون توفّر شروط اندماج الوافدين في النسيج المديني بالكامل، وهو ما أدّى إلى تحوّل التجمّعات السكنيّة الشعبية الطارئة حول المدن إلى “مناطق هامشيّة” مكتظة بالسكان تعاني من الهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وتنتشر فيها بشدّة مظاهر الانحراف والجريمة والاقتصاد غير المنظم وغير المرخص.

كما حوّلها كذلك إلى “مجالات احتجاجيّة” تنتج الهويّات الرّافضة، مثل مجموعات موسيقى الرّاب ومشجّعي كرة القدم، والهبّات الشعبيّة المناهضة والثوريّة، ورسخ ذلك صورة سلبية عن الأحياء الشعبية.
وتؤثر الوصمة السلبيّة العالقة بشباب الأحياء الشعبيّة على علاقتهم بأنفسهم والمحيط وتشكيل الهويّة الجماعيّة والقدرة على الحراك والصعود في المجتمع. وهو ما أشار إليه عالم الاجتماع الفرنسي ديدييه لابيروني، بأنّه “لا وجود لأحياء شعبيّة دون صورة الأحياء الشعبيّة”، و”لا وجود لتفاوتات دون تأويل لهذه التفاوتات”.
وهذا ما يفسر نزوع شباب الأحياء الشعبيّة إلى التعبير عن وضعيّات الإقصاء الاجتماعي التي يختبرونها، رغم اختلاف مساراتهم الاجتماعيّة وتعدّدها، انطلاقا من لغة يغلب عليها الطابع المعياري والأخلاقي بما هي “تجربة احتقار” و”شعور باللامساواة” والإقصاء، وعدم القدرة على عيش “الحياة” والانخراط بشكل كامل في المجتمع.
وتركز الدراسات والأبحاث في الآونة الأخيرة على الشباب من سكان الأحياء الشعبية سواء في العاصمة تونس أو المناطق الأخرى، حيث تثير المخاوف بسبب ازدياد نسبة الجريمة وانتشار الفكر الجهادي الإرهابي وسهولة استقطاب الشباب إلى هذه الأفكار بسبب نقمته وغضبه من الواقع والدولة والمجتمع.
ووجدت دراسة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود شملت 4 أحياء شعبية: أكثر من 51 في المئة من المستجوبين يعتقدون أنهم مضطهدون في بلادهم، وحوالي 70 في المئة من الشباب يعتبرون أن صوتهم غير مسموع، وأكثر من 54 في المئة منهم يعتقدون أنهم معرضون للتمييز في بلادهم.
وتهدف هذه الدراسة إلى معاينة وتحليل العوامل والأسباب الملائمة أو التي تدفع إلى تبني أفكار التطرف العنيف في السياق التونسي خلال السنوات التسع الماضية، وانطلاق تونس في تحقيق الانتقال الديمقراطي عبر إعادة تشكيل مؤسسات الدولة وإرساء دولة القانون بعد الثورة التونسية.
وأفادت الدراسة أنه بالنسبة لهؤلاء الشبان لا يحيل عدم المساواة إلى البعد الاقتصادي والاجتماعي فحسب بل بالنظر إليه كمظلمة سياسية ورمزية ومعنوية حيث يعتقد قرابة 55 في المئة أنهم لا يحظون بالاحترام علاوة على العنف الاقتصادي والتمييز الاجتماعي المقترنين بالاحتقار الطبقي أو الفئوي الاجتماعي، وأثار الشبان مسألة الجرح المعنوي الذي يمثل واقعا أكثر وجعا.
82.4 في المئة من الشباب يعتقدون أن القوانين لا تطبق بنفس الطريقة على كافة شرائح المجتمع
وبقدر ما يعتبر الإقصاء الاجتماعي تجربة لامساواة اقتصادية وتجريدا من دعائم الحماية الاجتماعيّة ونبذا خارج دوائر الإدماج المؤسّساتيّة بحسب خبراء الاجتماع، فهو أيضا تجربة احتقار وتجريد من الاعتبار المعنوي ونفي الاعتراف.
ويتجلى التعبير الآخر عن غياب العدل في مقياس أكثر تسيسا، إذ يعتقد 82.4 في المئة من المستجوبين اعتقادا راسخا في عدم المساواة أمام القانون حيث تسود المحاباة وسلطة الأقوى وتقديم المعارف على البقية، ويعتقد 82.6 في المئة من الشبان أنهم يعيشون في مجتمع غير منصف لا تطبق فيه القوانين على الجميع على نحو عادل، وأن الديمقراطية الناشئة ليست سوى ديمقراطية واجهة.
وحتى عند التطرق إلى “الانتقال السياسي” فهو في طريق مسدود في نظر هؤلاء الشبان لأن الدولة الجديدة المفترض أن تنبثق من روح الثورة أصبحت محل تساؤل أمام عدم فاعليتها في ردم الهوة.
ولفتت الدراسة الانتباه إلى عامل مهم وهو عزوف الشباب عن المجتمع والدولة الوطنية فقد أصبح الشبان يميلون نحو نموذج آخر يتمثل في الأمة “الإسلامية بنسبة 67.5 في المئة أو العربية بنسبة 39.4 في المئة”.
والملاحظ في العنف المجتمعي أن 70 في المئة من الشبان يعتقدون أن هناك عنفا في المجتمع و77 في المئة يعتقدون أن التونسيين عنيفون في ما بينهم وبالنسبة للعنف المسلط عليهم لوحظ أن 57.7 في المئة من المستجوبين يعتبرون أنفسهم ضحية عنف دولة و56.8 في المئة ضحية عنف في بلادهم.
ويكتسب التعامل مع رجال الأمن إشكالية بالنسبة لهؤلاء الشباب، إذ يعتبرونها تجارب يوميّة من الإخضاع والنبذ والاحتقار.
فبالنسبة لأجهزة الأمن، يتمّ تصنيف الأحياء الشعبيّة ومراقبتها وضبط سلوكيّات سكانها بوصفها “مناطق خطرة” تمثّل تهديدا للنّظام العامّ. وبهذا، يكتسب الحيّ لدى قاطنيه من الشباب معنى مزدوجا: فالحي يمثّل نوعا من الحماية باعتباره مجال انتماء وحماية، كما يمثّل أيضا مجال إخضاع ونبذ.

وتشير حادثة وفاة مواطن تونسي تحت أنقاض كشك هدمته شرطة البلدية في أحد أحياء محافظة القصرين التونسية، إلى حجم الحساسية والعداء بين الطرفين وتراكمات قديمة فجرتها هذه الحادثة، حيث أثارت غضبا واسعا بين سكان المنطقة الذين أغلقوا الطرقات، وأشعلوا العجلات المطاطية، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة.
وتبين الأرقام أن 55.2 في المئة يعتبرون أن ليس لهم اعتبار، في حين يرى 60.5 في المئة أنهم مهمشون، و51.6 في المئة أنهم مضطهدون وقرابة 54 في المئة عرضة للتميز ووفق نفس الدراسة 62 في المئة عرضة للحرمان، في حين تتجاوز النسبة 70.49 في المئة بالنسبة للذين يرون أنهم لا يتمتعون بنصيبهم، وأكثر من 60.15 في المئة يتعرضون إلى مظلمة.. وتضيف الدراسة أن 56.76 في المئة يقولون إنهم يتعرضون إلى عدم المساواة.
وعموما فإن 82.4 في المئة يعتقدون أن القوانين لا تطبق بنفس الطريقة على كافة شرائح المجتمع وأن أكثر المستجوبين ينظرون إلى الدولة والمجتمع كبيئة معادية، وأن الدولة لا تؤدى وظيفتها فحسب بل تعمل في الاتجاه المعاكس، أما عن المجتمع فينظر إليه في حد ذاته كمصدر عنف وانقسامات.
وتشير هذه النتائج إلى وجود حالة شعور عامة بالضيق والقلق وتبرز أيضا الشرخ بين الطبقات الاجتماعية وبين أصحاب القرار والمواطنين والمحكومين..
وتخلص الدراسة إلى تفوق الإطار المرجعي الديني على الإطار المدني كلما تعلق الأمر بالحكم على النظام الاجتماعي وفي الوقت نفسه تسلط هذه النتائج الضوء على نقطة هامة مخالفة لما يعتبر من المسلمات أو يدخل في باب البديهيات وهي الإطاران المرجعيان الديمقراطي والديني ليس في تناقض مع بعضهما البعض.
وتشير الدراسة إلى أن هذه الثورة غير المسبوقة في العالم العربي بمحورين من المطالب، وهما إرساء سيادة القانون والتقاسم العادل للثروة. خلال هذه المرحلة الانتقالية التي لم تكتمل بعد، واجهت تونس العديد من التحديات الأمنية نظرا لاختلال الاستقرار السياسي والأمني في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ووقوع العديد من الهجمات الإرهابية بتونس مما شكل خطرا على تنفيذ الإصلاحات المؤسساتية والدستورية الضرورية وتلبية المطالب الشعبية. في هذا الإطار أصبح جليا أنه وجب العمل على مكافحة هذا التهديد وتحييده لاستكمال. الانتقال الديمقراطي، وبالتالي فهم الظاهرة التي تسفر عن هذا النوع من العنف والخسائر وكذلك أسبابها الجذرية التي يتردد صداها في أفكار العديد من أفراد المجتمع.