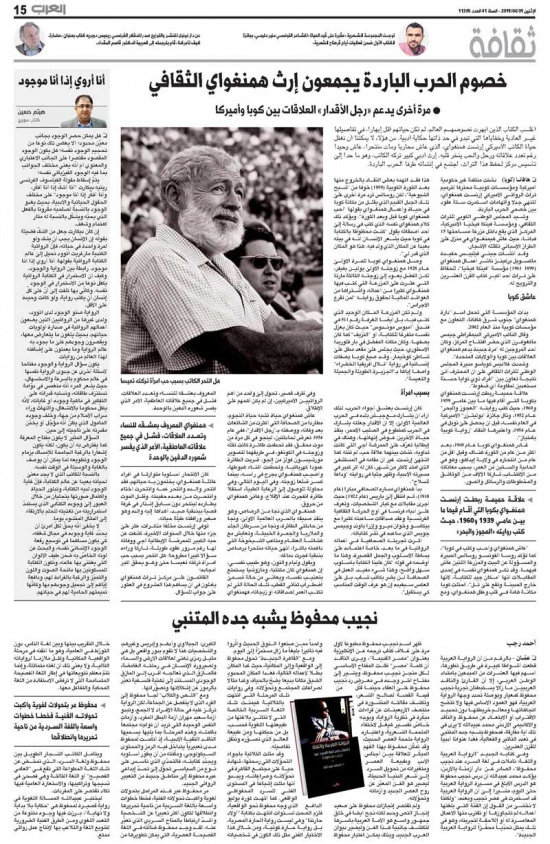المقاطعة السياسية أم التغيير من الداخل.. النخبة والدول العربية

يفرض اشتداد الأزمات الناجمة عن تصرفات فوقية تظهر فيها معالم الدكتاتورية، مقاطعة الشخص والحزب والجماعة الحاكمة المسؤولة عنها والدخول في مواجهة مفتوحة، تحاول من خلالها المعارضة والنخبة المؤيدة لها تغيير الواقع السياسي الأليم، وربما تدعو البعض إلى الانخراط في صفوف الطبقة الحاكمة على أمل إحداث تحول من الداخل، وثمة طريق ثالث يقوم على الانزواء لفقدان الثقة في الأنظمة الحاكمة والمعارضين.
يحضرني هنا جدل طويل دار أواخر فترة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، بين قيادات من الحزب الوطني الحاكم، آنذاك، وبعض المثقفين المحسوبين على المعارضة، عندما حاول الحزب استقطاب عدد من الرموز، مشهود لهم بالاحترام والتقدير والتأثير، لتحسين صورته في الشارع، والترويج لعهد جديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الحقيقية.
انقسم فريق النخبة إلى قسمين، أحدهما رأى عدم وجود جدوى من التعاون مع حزب على وشك التآكل، وقياداته لا تعتزم الموافقة على تعديلات جوهرية، وانفتاحها على بعض المعارضين مؤقت وليس إستراتيجيا، والهدف إضفاء صورة إيجابية على الحزب لتمرير سيناريو تولي جمال، نجل الرئيس مبارك، السلطة في مصر.
ورأت مجموعة محدودة في الفريق الثاني ضرورة التجاوب مع الطرح المعلن، والانحياز لما أطلق عليه الفكر الجديد، والتفاؤل بإمكانية إجبار قيادة الحزب الوطني (المنحل) على تبني تعديلات في الداخل تقود إلى أمر واقع يستوعب الأطياف السياسية المختلفة.
بالفعل قام البعض بهذه المغامرة، لكن نتيجتها كانت مخيبة للآمال، ولم تفض إلى تغيير في المضمون، وعلى العكس استثمرتها القيادة السياسية في المتاجرة، وزعمت أن العديد من النخب الثقافية تدعم منطلقات الحزب الوطني في الهيمنة المعلنة والمستترة.
استمرت حالة التكلس في المشهد إلى أن حدث انفجار 25 يناير 2011، وأدى إلى إزاحة الحزب الوطني من على قمة السلطة. يومها سقطت قناعات من راهنوا على نظرية التغيير من الداخل، ومن فضلوا المعارضة الصامتة، ونجح من عملوا على تكسير العظام السياسية لنظام دشن سياسات أعلت من شأن السلطة المطلقة ورفضت توفير الحرية المناسبة للمعارضين والنخب الثقافية.
هدمت تطورات التجربة فكرة التغيير من الداخل، وهذا لا يعني عدم الاعتداد بها، فقد أحدثت أثرها في دول أخرى، وأثمرت تحولات جذرية لاحقا في دولة مثل الصين، سيطر فيها الحزب الشيوعي على جميع مفاصل الحكم لعقود طويلة، ولم يتسنَّ التغيير إلا عبر الاستعانة بآليات نشطة، استغلت بعض الفراغات السياسية وقامت بتغيير واضح من الداخل، وساهمت في أن تصبح الصين واحدة من القوى العظمى الاقتصادية في العالم.
ظلت بكين مع تنحي الزعيم ماو تسي تونغ، نهاية الخمسينات من القرن الماضي، مشتتة بين الشكل الصناعي والتجاري العالمي، الذي وقف عقبة أمام مراحل التنمية المقترحة، نتيجة الصراع بين الرأسمالية والشيوعية في البلاد، والذي تسبب في انسداد ألحق أذى عميقا بالدولة، لم تفلت منه إلا مع تفاعل نخبة رأت أهمية قصوى في التخلص من الروافد الداخلية المعطوبة.
في تلك الفترة انضم الكثير من الإصلاحيين الشباب إلى الحزب الأوحد، في محاولة للتخلص من المبادئ القديمة بالحزب، وكان في مقدمة من عملوا على ذلك الرئيس الصيني السابق هو جينتاو، والرئيس الحالي شي جين بينغ، وصنعا تغيرا في فلسفة الدولة، أدى إلى تعديل ميثاق الحزب العتيد، وبذلك ظهرت الصين الحديثة العملاقة التي تحكمها قيادات شابة أكثر انفتاحا على العالم.
مع الفارق الشاسع بين التجربتين المصرية والصينية، خاصة من ناحية الأهداف السياسية والاقتصادية، إلا أن ما يجمعهما أن فكرة التغيير من الداخل مقبولة، وقد تكون لها حظوظ في التطبيق وتصبح صائبة في مكان، وفاشلة في آخر.
يتوقف النجاح أو الإخفاق على البيئة نفسها والأجواء التي تصاحبها، وهل هي مواتية للإصلاح أم يوجد إصرار على استمرار نهج المراوغة السياسية، وهو ما يجعل للفكرة بريقا لامعا هنا وإحباطا هناك.
تبدو مواقف النخب مع أنظمتها قريبة الشبه من مواقف الدول المنغلقة والمنفتحة مع القوى الكبرى التي تتخذ قرارات مفاجئة صادمة تؤثر على بعض التوازنات الإقليمية والدولية وتخلف وراءها تداعيات سلبية على المستهدفين منها.
توجد دول تتفاعل معها لتغيير مسارها نحو وجهة إيجابية، أو على الأقل تخفض سقف الخسائر السياسية، وأخرى ترفض وتدين وتشجب وتلعن وتستمر في المعارضة من دون اهتزاز شعرة واحدة لدى من اتخذوا القرارات الجامدة، ولا تعلم مدى ما تتحصل عليه جراء تبني منهج الضغوط، وبالطبع توجد الفئة الثالثة المنزوية قبولا أو رفضا.
يصلح هذا الاستنتاج لتطبيقه على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي منح إسرائيل مؤخرا اعترافا بسيادتها على هضبة الجولان السورية المحتلة، وقبله أعلنت إدارته عن نيتها إطلاق ما يسمى بـ”صفقة القرن” السياسية لتسوية القضية الفلسطينية، وبينهما جرت مياه كثيرة كشفت اتساع نطاق الانحياز الأميركي لصالح إسرائيل.
احتار الكثير من الدول العربية في التعامل مع المواقف والقرارات الأميركية، ودون دخول في تفاصيل من مع، ومن ضد، وطبيعة الحسابات التي تتحكم في تقديرات كل طرف، انقسمت التوجهات العربية إلى فريقين أساسيين؛ أحدهما مع فكرة الإصلاح من المصدر أو الداخل هنا والتمسك بمنهج خذ وطالب، والآخر مال ناحية الرفض التام على طريقة تيار الممانعة والمقاومة.
اختيار السبيل المناسب لتقدير الموقف بشكل سليم يتوقف على جملة من المحددات، أبرزها القدرات المملوكة لدى الدول العربية المهمومة بالأزمة، والتي تدفعها إلى تبني خيار التغيير من الداخل أم المضي في طريق المعارضة، والأفق الذي يسمح بتحقيق أعلى المكاسب الممكنة.
يكشف الاختيار حدود القوة، المادية والمعنوية، التي يملكها صانع القرار السياسي، وقدرته على تحقيق الأهداف القومية من خلال الوسيلة التي يحددها، وهذا لا يعني أن تبني التغيير من الداخل ضعف، أو رفع شعار الرفض التام قوة.
في ملفات كثيرة تتشابك التقديرات، وقد يصبح من الصّعب تحديد الفواصل السياسية بينها، وهي سمة طاغية على المشكلات الحالية في العالم، والتي تجعل من اتخاذ موقف معين يبدو صائبا وخاطئا في آن واحد، وهذا يتوقف على زاوية الرؤية، والهدف المطلوب تحقيقه، والأفق المناسب له، شريطة أن تكون طريقة الاختيار تتمتع بقدر جيد من النزاهة وتعلي من القيمة الإستراتيجية، ولا تمنح وزنا لأي حسابات قصيرة النظر.
تؤكد تصرفات دونالد ترامب بشأن القدس والجولان عدم استبعاد حدوث المزيد من الأزمات، ما يستوجب الاستعداد لتحديد المنهج الذي يمكن اتباعه في الحد من زخمها، ومنع إنزالها على الأرض.
وسواء كانت المقاطعة حلا ناجحا أو الإعلاء من قيمة الوسائل التي ترمي إلى التغيير من الداخل تعبر عن جوهر الموقف السياسي المرجو تبنيه، ففي الحالتين لن تتحقق نتيجة جيدة، إلا في حالة إزالة كل غمام أمام الرؤية المطلوب تنفيذها، ووضع خطة محكمة للتعاطي مع الأزمة.