هل تنجح الدول في فرض سيادتها التكنولوجية ضمن مجالها السيبراني
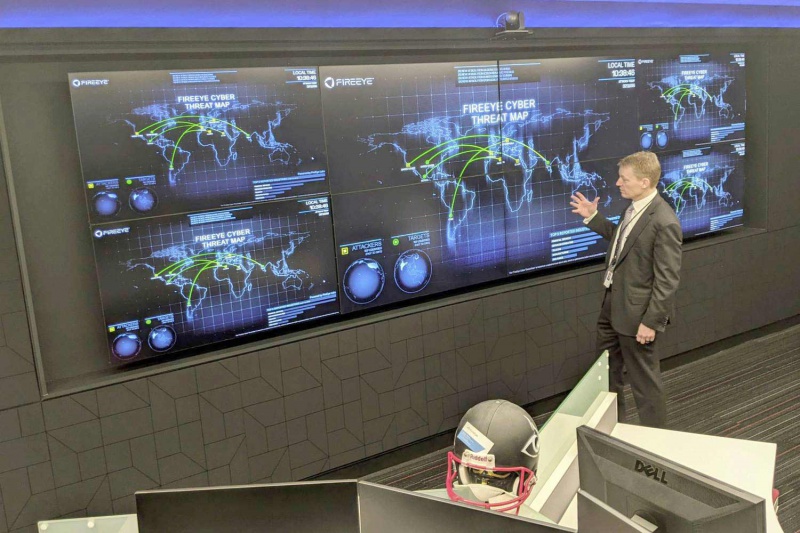
مع تصاعد الهجمات السيبرانية وغيرها تُطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة الدول على فرض سيادتها التكنولوجية في مواجهة الفاعلين ضمن المجال السيبراني الخاص بها، وهي سيادة تتصادم بشأنها رؤى تلك الدول على غرار ما يحدث بين الصين والولايات المتحدة.
لعقود ممتدة ظل المجال السيبراني ساحة مفتوحة من دون ضوابط تنظم التفاعلات بين الفاعلين المنخرطين فيها، حيث تعدد هؤلاء بداية من المستخدمين الأفراد مروراً بمجموعات القرصنة والتيارات الراديكالية على امتداد اليمين واليسار، وانتهاءً بالشركات التكنولوجية الضخمة، إلا أن الفترة الأخيرة التي أعقبت تفشي جائحة كورونا قد شهدت صعوداً في تركيز دول العالم على فرض السيادة التكنولوجية على مختلف الفاعلين ضمن المجال السيبراني الخاص بها، وهو ما يواجه العديد من المعوقات التي ترتبط بطبيعة النطاقات الافتراضية ذاتها، وترسخ هيمنة الفاعلين من غير الدول على المجال السيبراني، وامتلاكهم لقدرات عالية على التكيف وتحجيم الضغوط التي قد يتم فرضها عليهم، وفقدان الدول للأدوات التقنية المناسبة لفرض سيادتها بصورة كاملة.
في ضوء هذه الرؤية سعت رغدة البهي رئيسة وحدة الأمن السيبراني بالمركز المصري للفكر لإلقاء الضوء وتحليل مفهوم السيادة التكنولوجية، حيث رأت أن مفهوم السيادة يعد جدلياً في حد ذاته، على الرغم من اعتباره من الأركان الرئيسية للدول المُسلم بها، إذ يثور الجدل حول تطبيقاته خاصة في حالات التدخل الدولي وفرض المسؤولية الدولية للحماية.
جدل حول السيادة

أوضحت البهي في دراستها الصادرة عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة بأبوظبي أن أبرز اتجاهات الجدل حول السيادة في المجال الافتراضي تتمثل في: أولا، التباين بين السيادة التكنولوجية والسيبرانية، ثانيا تصاعد المبادرات لتحصين البيانات الوطنية، ثالثا تمسك بعض الدول بالسيادة السيبرانية الشاملة، ورابعا ضغوط أميركية للحفاظ على الهيمنة السيبرانية.
الممارسات الدولية تتباين في التعامل مع مفهوم السيادة التكنولوجية الذي يختلف عن مفهوم السيادة على الفضاء السيبراني
وفي ما يخص الاتجاه الأول تتباين الممارسات الدولية في التعامل مع مفهوم السيادة التكنولوجية الذي يختلف عن مفهوم السيادة على الفضاء السيبراني، وهو ما يعد ضمن تجليات الطفرة الهائلة في الاتصالات والمعلومات والثورة الصناعية الرابعة.
ويُقصد بالسيادة التكنولوجية سيطرة الدول على البنية التحتية التكنولوجية على أراضيها، شاملة الكابلات والسيرفرات وغيرها من التجهيزات الرئيسية، بالإضافة إلى فرض القواعد على الفاعلين المنخرطين في التفاعلات التكنولوجية، بينما يقصد بالسيادة السيبرانية السيطرة على الفضاء الافتراضي، شاملا التفاعلات وتدفقات البيانات والاتصالات وهنا تربط بعض الدول بين السيادة التكنولوجية والسيادة السيبرانية، حيث تؤكد تلك الدول أن الفضاء السيبراني ليس محصناً في مواجهة السيادة الإقليمية أو الولاية القضائية للدول، فقد مارست الدول ولايتها القضائية الجنائية على الجرائم السيبرانية، وأنشأت البنية التحتية السيبرانية المادية التي تتصل بدورها بشبكة الكهرباء الوطنية، وشبكات الاتصالات السلكية، ومن ثم، أكدت الدول باستمرار على حقها في السيطرة على تلك البنى التحتية، واختصاصها بالأنشطة السيبرانية على أراضيها، وحامية بنيتها السيبرانية التحتية من تدخل الدول الأخرى أو الأفراد عبر الحدود.
تصادم صيني - أميركي

أكدت البهي أنه في الاتجاه الثالث وفي إطار تباين رؤى الدول للسيادة السيبرانية وتعدد نماذجها تتصادم الرؤية الصينية على سبيل المثال مع الرؤية الأميركية.
وتنهض الرؤية الصينية للسيادة السيبرانية على ثلاثة أبعاد هي إدارة الإنترنت "أي إدارة الإنترنت من قبل الدول على قدم المساواة"، والدفاع الوطني "فلا يجوز للدول الانخراط أو التغاضي أو دعم الأنشطة السيبرانية التي تقوض الأمن القومي للدول الأخرى"، والنفوذ الداخلي "أي حق الدول في اختيار مساراتها الخاصة للإنترنت، ونماذج تنظيمها، وسياساتها العامة تجاهها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".
الصحافة الصينية نظرت إلى الاستراتيجية الدولية للفضاء السيبراني في مايو 2011 كغطاء لتطوير القدرات الهجومية، وعسكرة الفضاء السيبراني
من هنا قررت الصين دعم السيادة السيبرانية، مؤكدة حق كل دولة في اختيار نموذجها الخاص لتنظيم الإنترنت وضرورة خضوعها للقوانين الوطنية. وغالبا ما تنتقد الرقابة على الإنترنت والتدابير الحكومية الصينية الصارمة على الإنترنت من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون التجاري الدولي. فمثلا تحذر منظمة العفو الدولية من أن السيادة السيبرانية الصينية قد تتسبب في انتهاك حرية التعبير، وبالتالي تدعو الشركات التكنولوجية مثل آبل وغوغل إلى رفض نظام الإنترنت القمعي الصيني على حد زعمها.
أما في الاتجاه الرابع والمتمثل في الضغوط الأميركية للحفاظ على الهيمنة السيبرانية، فقالت البهي إنه في الوقت الذي تنادي فيه بكين بالسيادة السيبرانية، ترى واشنطن أن تلك السيادة لا تعدو كونها آلية لإضفاء الشرعية على الرقابة، وتوسيع نطاق سيطرة الحكومة على المجال الحر.
لذا، في اتجاه مضاد، سعت الولايات المتحدة لصياغة وإدارة معايير الإنترنت للمنظمات والصناعات الأساسية، ورفضت تدويل الوظائف ذات الصلة، أو التنازل عن السلطة لوكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة. وقد أدركت الصين أن ذلك موجه بالأساس إلى نظامها السياسي، ودأبت على التأكيد على المعايير المزدوجة التي تطبقها الولايات المتحدة على صعيد حرية المعلومات.
ونظرت الصحافة الصينية إلى الاستراتيجية الدولية للفضاء السيبراني في مايو 2011 كغطاء لتطوير القدرات الهجومية، وعسكرة الفضاء السيبراني، واستمرار سيطرة شركات التكنولوجيا الأميركية.
تحدي الخروج عن السيطرة

في إطار تحليلها لقيود فاعلية الاستراتيجيات الحكومية لفرض السيادة الإلكترونية، طرحت البهي قضية خروج الكيانات الكبرى عن سيطرة الدول، وقالت إن الشركات التكنولوجية الكبرى تنخرط في قطاعات مثل الهواتف المحمولة وأنظمة التشغيل والإعلانات والبحث والتجارة وغيرها.
وتمثل آبل وأمازون وفيسبوك وألفابت نحو 20 في المئة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم الأميركية، كما قامت مجتمعة بنحو 730 عملية استحواذ على شركات في السنوات الخمس الأخيرة.
وتتحكم غوغل وفيسبوك معاً في 60 في المئة تقريباً من إيرادات الإعلانات الرقمية في الولايات المتحدة و64 في المئة من إيرادات الإعلانات للهواتف النقالة، ويمر نحو 47 في المئة من جميع مبيعات التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة عبر أمازون.
 رغدة البهي: رؤية بكين للسيادة السيبرانية تتصادم مع رؤية واشنطن
رغدة البهي: رؤية بكين للسيادة السيبرانية تتصادم مع رؤية واشنطنويعني ذلك أن تلك الشركات في حقيقة الأمر ليست هياكل سيبرانية محلية فحسب، بل هي مؤسسات وطنية ذات صبغة عالمية لا يمكن محاربتها حرباً شعواء لأنها جزء من النسيج الوطني، وهو ما يفسر حقيقة تراجع جدوى السياسات الحكومية الرامية إلى مكافحة الإضرار بالسيادة التكنولوجية.
ورأت أن الفاعلين من غير الدول في المجال السيبراني يمتلكون مرونة فائقة في التعامل مع القيود الحكومية، سواء القانونية أو الاقتصادية أو حتى السياسية منها، بشكل يمكنها في الأخير من الخروج بشكل أو بآخر من إشكالية السيادة التكنولوجية التي تسعى الحكومات لفرض وجهة نظهرها بشأنها على تلك الشركات العاملة في الفضاء السيبراني الواسع. فعلى الرغم من أن شركة غوغل مثلا تستطيع فصل أعمالها عن يوتيوب.
كما قد تقوم فيسبوك بأمر مماثل على صعيد منصتي إنستغرام وواتساب، وهو ما يمكن وضعه في إطار “التفكيك القسري” الذي يصب في مصلحة الشركات الناشئة لمواجهة الاتهامات الحكومية المتكررة بالإضرار بالسيادة التكنولوجية، إلا أن ثمة شكوكاً كبيرة تحيط بإمكانية حدوث هذا بالنظر إلى جملة من الأسباب.
وأول هذه الأسباب أن فيسبوك وإنستغرام يمكنهما البقاء كشبكتين اجتماعيتين منفصلتين لفترة من الوقت، ولكن في النهاية سيرغب الجميع بالتواصل مع الآخرين عبر منصة واحدة، وثانيها أن الشركات التكنولوجية الكبرى لا تزال تتصدر المشهد بفروقات شاسعة عن غيرها من المنافسين، وثالثها أن التفكيك لن يمثل حلاً سحرياً لقضايا الخصوصية وجمع بيانات المستخدمين، فشركات التكنولوجيا الكبرى أضحت أكثر تعقيدا من أن يتم تقسيمها، فعلى الرغم من مواجهة دعوات الإضرار بالسيادة التكنولوجية بشكل متكرر في السنوات الماضية، فإن تلك الدعوات لم تشكل تهديدا ملحوظا لأعمال تلك الشركات أو مكانتها.
كما لم تتحقق بعد وعود أي من الرؤساء الأميركيين ممن وعدوا بالتصدي لعمالقة التكنولوجيا وآخرهم جو بايدن.
وفي المقابل ازدادت عمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركات التكنولوجية الكبرى عدديا، ولن تفلح الدعاوى القضائية في مجابهة ممارسات تلك الشركات بالنظر إلى طول أمد تلك الدعاوى من ناحية، وامتلاك الشركات التكنولوجية من الموارد والإمكانات ما يمكنها من تعيين فرق كبيرة من المحامين وصولا إلى نهايات غير مؤكدة من ناحية ثانية.
وتابعت البهي أن تلك الشركات تعول على إحساس المستخدمين باستحالة استبدالها بأي بنية أخرى بفضل موقعها المتميز الذي رسخته في الفضاء السيبراني، ولن تجدي العقوبات نفعاً في تقويض مساعي النفوذ التكنولوجي بالنظر إلى مراكز تلك الشركات المالية وأرباحها الضخمة حول العالم.

























