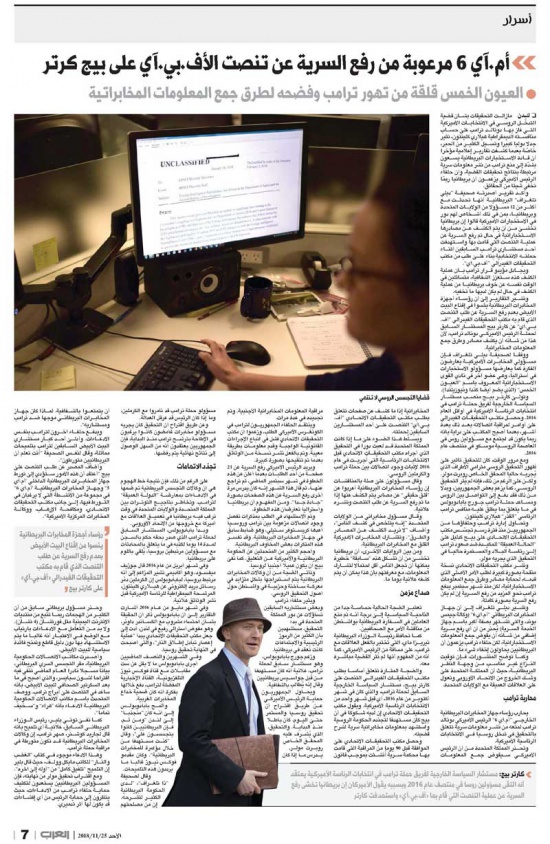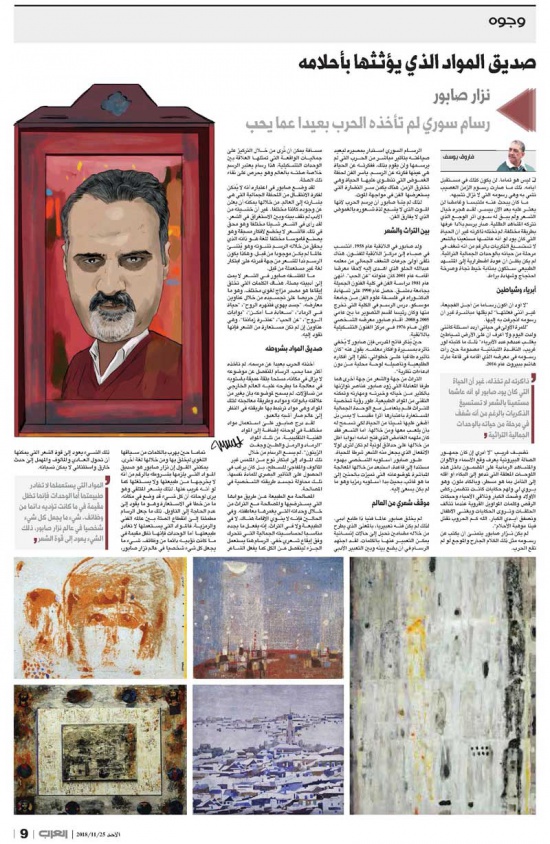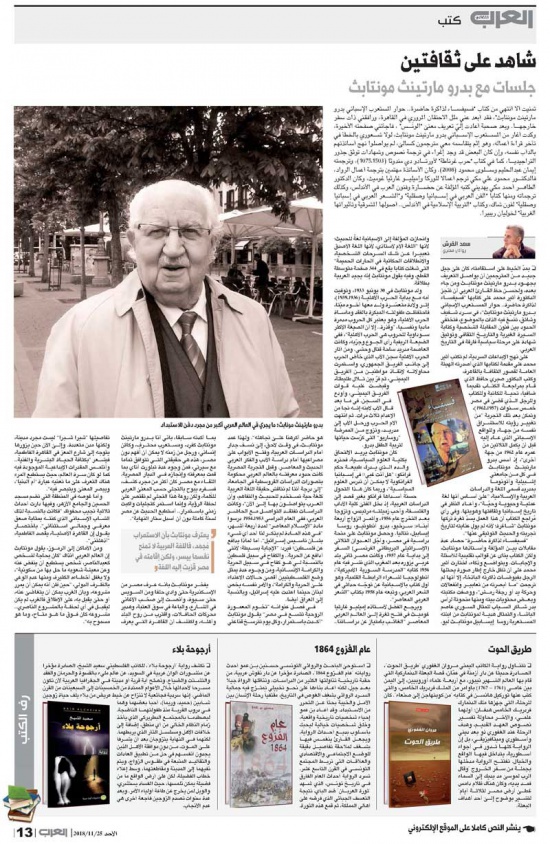فتنة الاستهلاك ودكتاتورية الإنتاج

يبدو أن الأديب والكاتب التشيكي فرانز كافكا أدرك مبكرا جوهر النزعة الاستهلاكية التي خلفتها التطورات المتلاحقة للرأسمالية حين قال «لا أقرأ الإعلانات، فأنا إن فعلت سوف أقضي جُل وقتي أرغب في الحصول على أشياء». يتضح هذا المنطق بالرقي في مدارج التقدم والابتكار، إلى درجة التأسيس لقاعدة مفادها ربط الوجود بالاستهلاك تحت شعار “أنا أستهلك إذن أنا موجود”، فصارت بذلك كماليات الحياة ورفاهيتها ضمن الضروريات، واقترنت “السعادة” اقترانا شرطيا بلزوم توفر كل تلك الأشياء.
ذات الفكرة عبّر عنها الفيلسوف الألماني الأميركي إريك فروم، في كتابه “الإنسان بين الجوهر والمظهر” (1978) بتشبيه بليغ ومعبر، أكد فيه أن النزعة الاستهلاكية لدى الإنسان صيّرته ذلك الرضيع الأبدي الذي لا يكفُ عن الصياح في طلب زجاجة الرضاعة.
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وربما حتى قبلها، أفلحت الولايات المتحدة الأميركية في تسويق صورتها من خلال تصدير نظامها المزدهر، ونمط العيش والحياة الأميركية، وديناميكية تاريخها الخاص كنموذج للآخرين. وهكذا بلغ الأمر لدى البعض حد المرض أو الهوس باتباع النموذج (الحلم الأميركي) خصوصا في الشراء والتبضع.
قد يختزل بعض القراء الأمر في مجرد موقف ذاتي من نمط العيش في دولة صار نموذجا، يطمح كل فرد على وجه الأرض بالعيش فيه. لكن المسألة أكبر من ذلك، وتتجاوز الآراء الذاتية إلى قضية ترتبط بمصير الأرض ومستقبل الأجيال القادمة إليه. لكن كيف ذلك والناس يسعون وراء هذا النموذج؟
توصلت ثلة من الباحثين مؤخرا، وباعتماد دراسات مقارنة، إلى أن عيش سكان جمهورية الصين الشعبية لوحدهم على النمط الأميركي، يفترض من الأرض أن توفر ثلاث مرات ما هي عليه الآن من الموارد الطبيعية. وعليه، أصبحت متوالية الزيادة في الإنتاج بهدف تحقيق المزيد من الاستهلاك، وبالتالي المزيد من الرفاهية والسعادة التي يقوم عليها الاقتصاد الحالي محط شك وارتياب، نتيجة المحدودية الحاصلة في الموارد الطبيعة.
تاريخيا، يُشير الكاتب الأميركي روجر روزنبلات في كتاب “ثقافة الاستهلاك: الاستهلاك والحضارة والسعي وراء السعادة” (1999) إلى أن دور الإنفاق في إحداث بعض التفاوت بين الطبقات داخل المجتمع دور حديث للغاية. ففي العصور السابقة عندما كان يتحدد الوضع الاجتماعي بالميلاد والتاريخ والطبقات لعب الإنفاق دورا ثانويا في الحفاظ على الوضع الاجتماعي. وكان الاستهلاك مقيدا أكثر بالمكانة الاجتماعية التي ينتمي إليها الفرد لا إلى الجنون والمرض الذي هو عليه الحال اليوم.
رأي ليس بجديد، حيث نجده عند السوسيولوجي الفرنسي بيير بورديو في كتابه “التمييز: النقد الاجتماعي لحكم الذوق” (1979)، الذي أكد أن الحياة اليومية مملوءة بأعمال “مصغرة”، لأوضاع اجتماعية تؤدي إلى الإدراج في، أو الاستبعاد من، الجماعات الاجتماعية المفضلة. ويستخدم أفراد الطبقة المميزة عاداتهم الاستهلاكية للحفاظ على هوية طبقتهم، واستبعاد الطبقة الأقل مقاما.
على هذا الأساس، يظهر أن فتنة الاستهلاك الآخذة في الانتشار عبر سياسة الإشهار واستثارة الغرائز لدى الإنسان المعاصر، قد غدت الرياضة المفضلة لكل الشركات المنتجة التي تسعى للربح السريع لأجل مراكمة الثروات. لذلك أصبحت الوفرة في المقتنيات غاية بذاتها، بعدما كانت الحاجة هي الدافع الأساسي عند الناس للشراء. وهكذا أيضا أضحى الاستهلاك شكلا جديدا من أشكال التملك، بل صار أكثرها أهمية في مجتمعات الوفرة المعاصرة، حيث تقوم لذة الشراء مقام الحاجة إلى الشيء المقتنى ذاته.
بذلك تكون القواعد المؤطرة للعملية الاستهلاكية لدى الإنسان المعاصر قد شهدت انقلابا جوهريا من أساسها. ففي السابق كان موضوع الشراء يحظى بالعناية والرعاية والحفظ، والاستخدام حتى آخر الحدود الممكن للاستعمال. أما في الوقت الراهن؛ وفي ظل ميوعة الثقافة الاستهلاكية، فالاقتناء لا يتم من منطلق الحفاظ واستعمال ما اشتريناه مدة أطول، وإنما من أجل رميه في الحين، ثم نسعى إلى شراء جديد في عملية غريزية لا منتهية.
هكذا أصبح الإنسان أسير حلقة لا متناهية من الشراء؛ أو بالأحرى فريسة سهلة لاستلاب النزعة الاستهلاكية المعاصرة التي لا ترحم. وذلك بتركيز خبراء الإشهار في منطق الاستهلاك؛ وبالتحديد في الخطاب التواصلي الإشهاري، على قلق وضجر الإنسان المستهلك الحالي الذي يملّ بسرعة قياسية من مقتنياته، فتراه يُقبل باستمرار على شراء الطراز الجديد، ومتابعة آخر نسخ المنتوج، بما تتضمنه من تحسينات وعروض. فيدخل في مسلسل لا متناه قوامه رمي القديم من الأشياء، والحرص على شراء الجديد بشكل دائم. وهكذا دواليك؛ فالمنتوج يبقى هو ذاته في جوهره (سيارة، هاتف، ساعة)، لا تلحق التغييرات سوى بعض الإكسسوارات الخارجية، تبعا لأسباب واهية يبتكرها المنتج للمزيد من الاستهلاك (الفصول، الألوان، الموضة…).
في العقود الأخيرة، وبالتزامن مع الانتشار الواسع لمنظري الفلسفة البيئية، حظيت المسألة الاستهلاكية بنصيبها في الكتابة والبحث لدى بعض رموز الفكر المعاصر، ممن أعادوا النظر في فكرة أن الرفاه مسألة اقتصادية محضة، أي مجرّد زيادة في النمو وتشجيع للاستهلاك. فهذا الاقتصادي الأميركي، الحاصل على جائزة نوبل عام 2002، فرنون سميث يثور على دكتاتورية الإنتاج والاستهلاك، داعيا البشرية إلى أن تأخذ في الاعتبار البيئة والصحة عن طريق توجيه الإنتاج وترشيد الاستهلاك، وذلك عبر تشجيع التقنيات الرفيقة بالبيئة واقتصاد التنمية المستدامة. في حين لا يتردد إريك فروم في الدعوة جهارا إلى تبني مذهب “الاستهلاك الرشيد” بدلا من “الاستهلاك المرضي”؛ أي الاستهلاك العقلاني المصاحب بنوع من الغائية الأخلاقية.
أما المعارض الأميركي الشهير نعوم تشومسكي فلا ينفكك في الصدح عاليا بالويلات التي تتهدد البشرية، إن لم تضع قطيعة مع نمط العيش الأميركي «أعتقد أنه لا أمل على الإطلاق في مستقبل أفضل للبشرية، وخاصة مع ازدياد اكتساح النموذج الأميركي المادي الاستهلاكي على مستوى العالم».