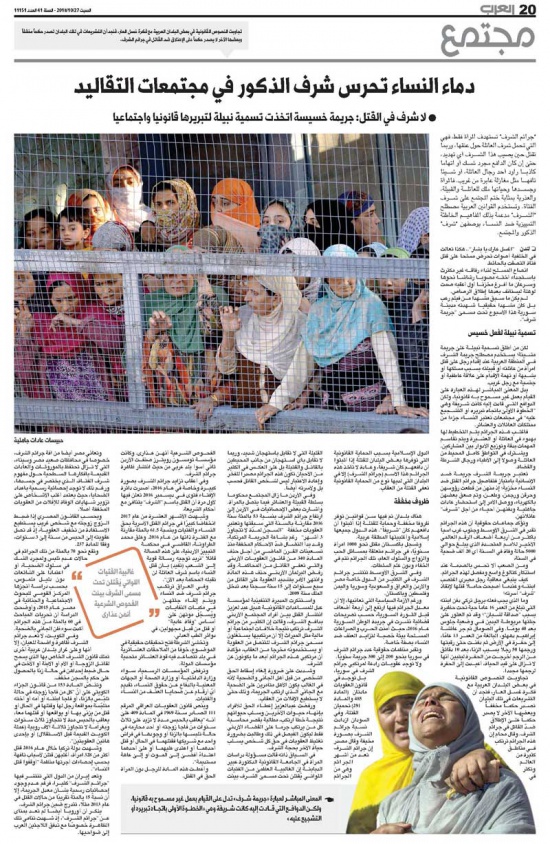صناعة السفن في البحرين تغوص في بحر النسيان

التطور الصناعي يساهم في اندثار بعض الحرف التي عرفتها الشعوب واشتهرت بها، فصناعة السفن بالطرق التقليدية التي اشتهرت بها البحرين، تعاني اليوم من تراجع عدد العاملين بها، كما تعاني من تراجع الطلب عليها، لكنها حرفة تستحق الإنعاش كما يقول بعض من يتشبثون بها.
المنامة – درج مسؤولو الصفحات والمصححون في الصحف على حذف الألقاب المهنية، مثل الدكتور والبروفيسور والأستاذ، ولكن لا أظنهم سيفعلون ذلك مع هذا التحقيق، لأن صفة الأستاذ، هنا، تطلق على مصمم السفينة والقارب والزورق وبانيها والمشرف على أعمال بناء السفن، وأقل مرتبة منه القلاف، الذي يصلح السفن ويعاون الأستاذ على بنائها، كما قال الأستاذ عبدالله محمد.
وصناعة السفن من الصناعات التقليدية التي اشتهر بها البحرينيون منذ القدم وارتبطت بهم كشعب يعيش في جزيرة وسط البحر، وقد برعوا فيها وكانت لهم بصماتهم الواضحة عليها أيا كان نوعها، فمنها البانوش والشوعي والبوم والبغلة والبتيلة، والجالبوت، والبقارة، وغيرها من الأنواع المستخدمة في صيد الأسماك والغوص لصيد اللؤلؤ ونقل الركاب والبضائع.
“البانوش” سفينة متوسطة الحجم، و”الشوعي” السفينة المخصصة للصيد فقط، و”البتيلة” هي السفينة الكبيرة بمقدمة منحنية، وقد كانت تستخدم للغوص والسفر، و”البوم” وهو النوع الأكبر حجما والأكثر تنوعا في الاستخدام سواء للصيد أم الغوص أم السفر البعيد وكذلك نقل البضائع، و”الجالبوت” هي المخصصة لاستخراج اللؤلؤ، و”البقارة” هي من السفن الكبيرة التي توقفت صناعتها اليوم.
يشرح الأستاذ محمد علي إسماعيل الرحيمي لـ”العرب” صناعة السفن قائلا، “إنها تقوم على الأخشاب المستوردة من الهند وهي أنواع خاصة من خشب الساج والصنوبر المقاوم للرطوبة ويعتمد في صناعتها على أدوات النجارة مثل المجدح والقدوم والمنشار وغيرها. وتبدأ صناعة السفينة في المحطة المخصصة لها على شاطئ البحر، فيحدد الأستاذ حجمها من حيث الطول والعرض والارتفاع بحسب نوعها والغاية المستخدمة لها وفق قياسات متناهية الدقة كي تحفظ توازن السفينة عند إبحارها مما يعكس مهارة الأستاذ البحريني”.
لم يبق من الأساتذة في البحرين سوى عدد لا يتجاوز عدد أصابع اليد، بعد أن كانت تعج بهم سواحل مدينتي المنامة والمحرق اللتين تركزت فيهما صناعة السفن.
يواصل الرحيمي حديثه، «بعد تحديد الحجم يتم مباشرة العمل على تركيب الهيكل الرئيسي بتثبيت البيص وهو العمود الفقري للسفينة، مرورا بتركيب أضلاع الهيكل حينها، يبدأ القلافون بتثبيت الألواح الخارجية بمسامير من حديد وبعدها يتم تركيب “الفنه” وهي سطح السفينة، ومن ثم يثبت “الدقل” وهو الصاري وتختتم عملية الصناعة باستخدام القطن “الفتيل” لسد الفراغات وتدهن بزيت الصل والأسماك وأنواع أخرى من الدهون».

ولا تنتهي العملية بانتهاء صناعة السفينة، إذ تعقبها عملية إنزالها إلى البحر بطريقة يدوية وبالاعتماد على أخشاب توضع كالسكة لإيصالها من مكان تهيئتها على الشاطئ إلى مياه البحر بمشاركة عدد كبير من الرجال حتى يتمكنوا مـن تحريكها ودفعها نحـو الماء، وكانت هذه العملية تتم في احتفالية كبرى يعم فيها الفرح باستكمال القلاف للقطعة التي بذل أياما من عمره وهو ينتظر رؤيتها مكتملة تبحر بوقار واتزان مع ترديد الأهازيج الشعبية المعبرة عن الابتهاج.
كانت البحرين من خلال حي النعيم في المنامة وباقي المناطق، تصنع جميع أنواع السفن، وكان حي النعيم المصنع الأول للسفن، قبل أن تنسحب هذه الصناعة وتقيم في محافظة المحرق، وكانت لأهالي حي النعيم مهن أخرى مثل صيد الأسماك والنجارة والغوص والطواشة، لكن القلافة كانت الأبرز، وقد انتهت بسبب ظهور النفط أولا ومن ثم ظهور صناعة السفن من مادتي البلاستيك والفيبر بدلا من الخشب.
وسافرت عائلات عديدة لـ”قلاليف” حي النعيم إلى دول خليجية أخرى مثل الكويت وعمان وقطر للعمل بالمهنة نفسها، ناقلة معها تراث البحرين وعاداتها وسلوكياتها.
ورغم صغر حي النعيم، إلّا أن عدد قلاليفه الممارسين للمهنة أيام ازدهارها كان أكثر من 200 قلاف وهو عدد كبير مقارنة بعدد سكان البحرين، ويذكر باحثون أن البحرين صنعت بين سنتي 1903 و1904 أكثر من مئة سفينة بأحجام ونوعيات عديدة، وكانت تصدر تلك السفن إلى سواحل إيران ودارين والقطيف.
يقول الباحث يوسف أحمد النشابة، إن البحرينيين عرفوا المسمار في صناعة السفن عند دخول البرتغاليين إلى البحرين بعد العام 1521، وقبل ذلك كانوا يستخدمون الخشب ويسمونه “اصكاكة”، بدلا من المسمار.
ويتحدث عن عادات القلاليف، فيذكر أن مالك السفينة كان يذبح ماعزا ويعدّ وجبة غداء دسمة عند بدء العمل بالسفينة لتحفيز العاملين، وأخرى عند تدشينها، مشيرا إلى أن من الموروثات الاجتماعية أن تتم حراسة السفينة عند وضع “البيص” تفاديا لاختراق أي من النساء ورشة العمل “الحوطة”، إذ أن الاعتقاد الذي كان سائدا لديهم أن أي امرأة عاقر إذا ما تخطّت هذا “البيص” عند صناعة السفينة تحمل في العام نفسه، وإذا حدث ذلك فهو الشؤم بعينه على السفينة ولربما تغرق، كما أن القلاف يعتبر السفينة أثناء صنعها مكانا مقدسا، ويجب نزع النعال أثناء اعتلائها.
ومنذ ظهور النفط في المنطقة بدأت أعداد الأيدي الماهرة تقل في هذه الصناعة وهو ما أدى إلى تقلص حرفة صناعة السفن الخشبية بالطريقة اليدوية وبدأت تلك المهنة في الاندثار، وليس في البحرين كلها اليوم إلا مكان واحد على ساحل المحرق يمارس فيه ثلاثة من الأساتذة هذه المهنة.
يقول عبدالله محمد، وهو واحد من الأساتذة القليلين الموجودين حاليا في البحرين، والذي أمضى إلى الآن 35 سنة في هذه الصنعة، “إن طريقة صنعنا للسفن تختلف عن أي مكان في العالم، فنحن نبني الهيكل الخارجي للسفينة أولا ثم ننتقل لبناء الداخل، وقد زارنا أجانب كثيرون واندهشوا عندما رأوا أننا نعمل دون تصميم مسبق ولا خارطة”، مشيرا إلى أنهم يعدّون بناء السفينة امتحانا نهايته نجاحها أو فشلها في البحر.