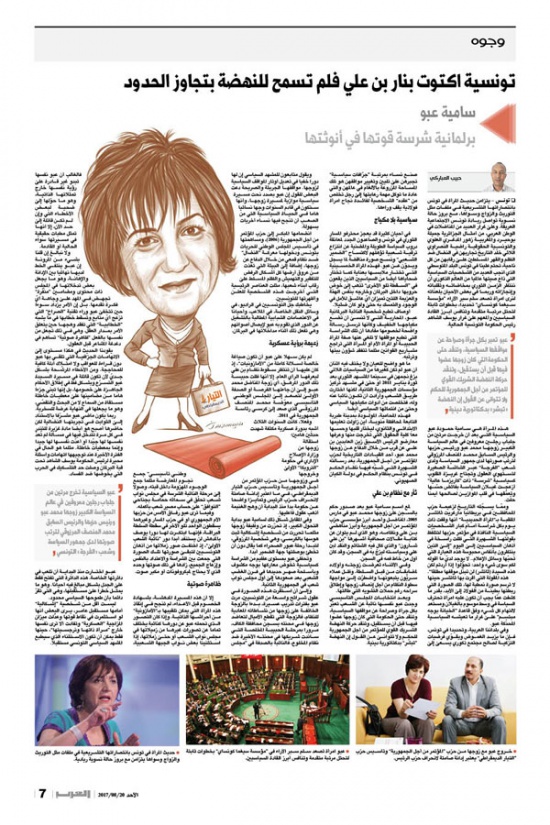سرد حصيف يحتفي بالحكاية: "عشبة ضارة في الفردوس" لهيثم حسين

شَهِدَ النتاج السردي السوريّ زخَماً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وتزامن ذلك مع الحربٍ الطاحنة الدائرة في البلاد التي عُرِفَت حتى وقتٍ قريب "بمملكة الصمت"، فإلى جانب ألوفِ السوريين الذين كسروا حاجز الخوف والصمت منتفضين على ما يقرب من نصفِ قرنٍ من حُكمِ الحديد والنار وإدارة البلاد عبر تكريس تناقضاتها ومفاقمتها، كذلك تدفّق "الكلامُ السوري" كنهرٍ احتُجِزَ طويلاً وراء سدّ، فجادت القرائح المكبوتة وكأنّها تسابق الزّمنَ لتحريرِ مدوّنتها السردية المغيّبة وإحلالها محلّ سرديّة السّلطة الموحّدة.
وإذا كانَ المشهدُ يتّسعُ للسّمين والغثّ من الأعمال الروائية، وهو أمرٌ يُترَكُ للقارئ أن يبتّ في مسألة تصنيفه وفرزه، لا سيما في ظلّ غياب إطارٍ نقديّ يواكب هذا الزخم، فإنَّ فِعلَ الكتابةِ بحدّ ذاته يكتسب معنىً خاصّاً في سياقٍ مثل السياق السوري بحكايته الطويلة التي ربّما يستغرق سردها أجيالاً.
يرى الناقد الفرنسي المعروف جيرار جنيت أن الحكاية بصفة عامة، ليست في حدّ ذاتها سوى صيغة، ولكنّها الصيغة المفضلة لتمثيل فِعل أو حدث، وتُعدّ هذه الخاصية الجوهرية التي تتصف بها الحكاية -أي القُدرةُ على تمثيلِ الفِعلِ أو الحدَث- واحدةً من أهم مقومات الخطاب السردي. وبالتالي، وكما يرى جنيت، فإن ما يهم في الحكاية، ليست الأحداث التي ترويها فحسب، بل طريقة سرد تلك الأحداث أيضا، أي براعة الوظيفة الحكائية (السردية)، وتبعاً لهذا الفهم يرى جنيت أنه لا يمكن للحكاية -مهما أوتيت من قوة وبراعة- أن تحاكي الواقع على نحوٍ تام، ناهيك على أن تستنسخه بحذافيره. فـ”الحكاية لا تُمثِّلُ قصة ما -واقعية أم خيالية- إنما تكتفي بروايتها، أي أنها تدل عليها بواسطة اللغة، “إذ ليست هناك مكانة للمحاكاة في الحكاية”.
لا يمكنك سوى أن تتفاعل بشعف إنساني شديد مع هذه الشخصيات بمستوياتها المتعددة، البسيطة والمركبة، الحكمة الغرائبية لموروي الأعمى الذي "يشعر بنفسه حكيم زمانه"
إذن، إنّها الحكاية في حدِّ ذاتها، ما يجذُبُنا نحو المُضيّ خلفَ مغامرةٍ سردية، فنحنُ حينما نشرعُ بقراءة كتاب، وبعيداً عن المقترحات الدلالية للعناوين، لا نعرف الكثير عمّا ينتظرنا في ثناياه، لذا فإننا نحتاجُ إلى ما يُحفّزُنا على مواصلة رحلة استكشافنا.
فنحن كقراء محايدين على أبواب الكُتُب، نحتاج إلى ما يثيرُ شغَفَنا ويبقينا على اتّصالٍ بما نقرأ، خصوصاً وأنَّ عناصر الجذب “اللانصِّيّة” تواصِلُ استحواذها على ميولِنا في الآونة الأخيرة متربّصةً بجوارحنا لتغوينا بما هو بصريٌ وسمْعيّ ومكثّف، وأمام حواجز كهذه، ربما بالإمكان القول إنَّ الحكاية تأتي في مقدّمةِ العناصر التي يمكِنُ أن تضمنَ لنصٍّ ما فُرصةَ أن يظفَر باختيار القارئ وصولاً إلى إدخاله في غابةِ تجربته السردية وشبكته الحكائية.
ذلك ما وُفِّقَ فيه الروائي والناقد السوري هيثم حسين في روايته “عشبة ضارّة في الفردوس” والصادرة مؤخّراً عن دار “مسكيلياني” و”دار ميارة” للنشر، إذ يمضي بنا في رحلةٍ سرديّةٍ شيِّقة قوامُها بِضع وثلاثون حكاية يجمعها مدارٌ سرديّ واحد ومصائر تجعلها أشبه بحكايةٍ واحدة لشخوصٍ عديدة.
إذ أنَّ براعةَ السبكِ الحكائي، المهارةُ في القصّ، كما يصفها جنيت، فضلاً عن نصاعةِ القالب اللغوي واحترافيته، سرعانَ ما تستحوِذ على شغف القارئ وتُحفِّز لهفَته للانخراط في الواقعِ الذي يبتكره الكاتب مستعيناً بشخوصه الملوّنة وحكاياتها المتنوعة.
اختار الكاتب نمطاً يجمع ما بين أسلوب الرواية وأسلوب القصة القصيرة، فالحكايات الفردية للشخصيات تبدو مثل أرخبيلاتٍ سرديةٍ في محيطِ الرواية الأكبر، هي حكاياتٌ ومصائر مختلفة يمسك بزمامها راوٍ واحد، وهو ما منح العمل رشاقةً إضافيةً أبعَدَتهُ عن فخِّ الترهّلِ والاستطراد الذي عادةً ما تسقُط فيه كثير من الأعمال السردية.
تنفَرِدُ شخصيةٌ أنثى (منجونة ابنة الأعمى موروي) بموقع الراوي وتمضي في تأليف وبناء حكاياتها عن المكان وبشَرِه موزّعةً الأدوار والمصائر، إلاَّ أنَّ بعضاً من شخوص الرواية الأخرى تتناوبُ مع منجونة في قَصِّ حكاياتها الذاتية من خلالِ مونولوجاتٍ مسبوكةٍ بخبرةٍ روائيةٍ واضحة تصل إلى أعماق الشخصيات لتُطلِقَ أصواتها إلى العالم الخارجي.
|
نقرأ في بداية الرواية “ستمضي ذواتي المتعدّدة بحكاياتي في متاهات الواقع وأنفاق الخيال. سأسند لأبطالي وشياطيني أدوارًا معيّنة وأسلبها منهم في الوقت الذي أريد. هنا فقط أمارس ترويضي لجنوني وأهدّئ من براكيني. هنا أمنح نفسي سلطة القرار وأكون حرّة في اللعب بالحيوات والمصائر. أضع نفسي مع الشخصيات التي أحكي عنها، يحضر أبي بصورته في عيون الآخرين، وسيرته الواردة على ألسنتهم. هم أيضًا أحرار في رسم مصائرنا. يبدو أنّ الحكايات هي وحدها ميادين الحرّيّة في هذا العالم المعتم”.
ومع أنّ فضاء الرواية المُعلَن هو بلدةٌ سورية كُردية ترزحُ تحتَ وطأةِ القمعِ والتهميش الذي مارستهُ السلطة الحاكمة طيلةَ عقودٍ متواصلة، إلاَّ أنَّ الحكايات والمصائر التي تداوِلتها الرواية إنّما تشبه مثيلاتها في أيّ بلدةٍ سوريةٍ أخرى في زمنٍ كانت مفارَقَتَه الأدهى أنّه ساوى بين السوريين -غير المغضوب عليهم، وهؤلاء صفوةٌ قليلة- أمامَ الخوف والقمع والبطش، على أنّنا نكتشف من خلال حكايات منجونة كيف كانت عُزلةُ الكردي السوريّ مضاعفةً في السجن السوريّ الكبير، ثمّةَ مشهدٌ لا يغيب عن الذهن تتحدّث فيه منجونة عن مرارة التجربة التي كان يواجهها الكردي البسيط الذي لا يُتقِنُ التحدث بالعربية لدى مراجعة دوائر السّلطة التي كانت تُمعِنُ في إذلاله وتمارس شوفينيّتها إزاءه بساديّةٍ مقيتة.
وإذ نمضي قُدُماً في متنِ العمل، يتأكد دورُ الرواية/الحكاية في مقاومة النسيان، تتداخل الحكايات مع تفاصيل الواقع المحيط في ما يشبه تصويراً سينمائياً بديعاً يتناوب فيه الذاتي والموضوعي، يبدو المشهد أقرب إلى العبثية على الرغم من واقعيته التي لا لَبسَ فيها، مشهدٌ لا يخلو من الطرافةِ التي يبرع فيها هيثم حسين في ما يشبه سخريةً مريرةً من واقعٍ مأساوي، ثمّة ما يُذكّر بشخصيات عزيز نيسن.
فمن حكاية “بيت الشعب” وهو بيتُ عاهرة البلدة التي يعمل زوجها محجوب مخبراً لصالح “المساعد أول” المكنّى بزوجِ برازق، إلى حكاية قطعة الـ25 ليرة النقدية التي سكَّتها السلطةُ ووضعت عليها صورة الرئيس الأب بدلاً من الورقية التي كانت تحمل صورة صلاح الدين، إلى “بزّق ولَزِّق” و”أبو فطيسة”، إلى بريندار، نموذج الكرديّ العنيد الذي لا يعرف الخوف، إلى توفيقو ونُكاته وجميلة التي تخترق الوسط الفني في العاصمة لِتُعرّي فساده هو الآخر أسوةً بباقي الأوساط المجتمعية والرسمية التي حَرصت “دولة المساعد أول” على أن يطالها ما يكفي من الخراب لتسهُلَ إدارتها.
لا يمكنك سوى أن تتفاعل بشعفٍ إنسانيّ شديد مع هذه الشخصيات بمستوياتها المتعددة، البسيطةُ والمركّبة، الحِكمةُ الغرائبية لموروي الأعمى الذي “يشعر بنفسه حكيم زمانه، يظنّ أنّه يطلق العبر والحكم في كلّ الاتجاهات، يتنقّل بين البيوت، يدقّ بعكّازه الجدران، يرفس الأبواب المشرعة على الفراغ والفوضى، يصرخ مطلقًا شتائمه على الجميع، يجتاحه شعور بالخيانة، ويبحث لذلك الشعور عن لون مبتكر جديد، فلا يجد غير لون العمى”.
لا تقتصر رواية منجونة على رؤيتها الحكاية من منظور الضحية، بل تقودها أقدارها إلى مدوّنةِ الجلاد حينما تظفَرُ بدفاتر يوميّات “المُساعد أوّل” الذي أوكلت له السلطة مهمةَ إدارة البلدة، وهنا يستعرِضُ الراوي من خلال منجونة ما يمكِنُ تسميته بهندسة الخراب، النهجُ الذي أدارت بموجبه سُلطةُ الاستبداد البلاد التي لا تشبيه أبلغ من الوصف الذي تَصُفها فيه الرواية بـ”دولةِ المساعد أول”. البلاد التي يكتشف القارئ أنه يعرفها جيداً، غير أنه مع ذلك سيظلّ مذهولاً على امتداد الحكايات/الحكاية التي يقول الراوي في ختامها إنها “لن تنتهي”.
قرأتُ الرواية على مدار أسبوع تقريباً في طريق ذهابي إلى العمل وإيّابي منه في قطارات الأنفاق، كنتُ مستغرِقاً في حكاياتها وشخوصها إلى درجةٍ جعَلَتني في إحدى المرات أفوِّتُ المحطّة التي يجب أن أغادر القطار فيها، وكثيراً ما كان فمي يفتَرُّ عن ابتسامةٍ عريضةٍ وأنا أقرأ إحدى الطُّرَف التي حرص هيثم حسين على وضعها كلّما استشعَرَ بأنَّ الأسى الذي يستفرِدُ بالقارئ قد باتَ على درجةٍ من الخطورةِ تستدعي تنفيساً لا بُدَّ منه.
تستحق الرواية أن تُضاف إلى الثمين في قائمة الرواية السورية. فإلى جانب براعةِ السرد وشِعريةِ اللغة ونصاعتِها (وهو ما نفتقده في الآونة الأخيرة)، فإنَّها أيضاً تأتي كوثيقةٍ حكائية أخرى ضدّ النسيان، تُوَثِّقُ لزمنٍ نتضرّعُ إلى السماء راجينَ ألا يُعاد.
كاتب من سوريا