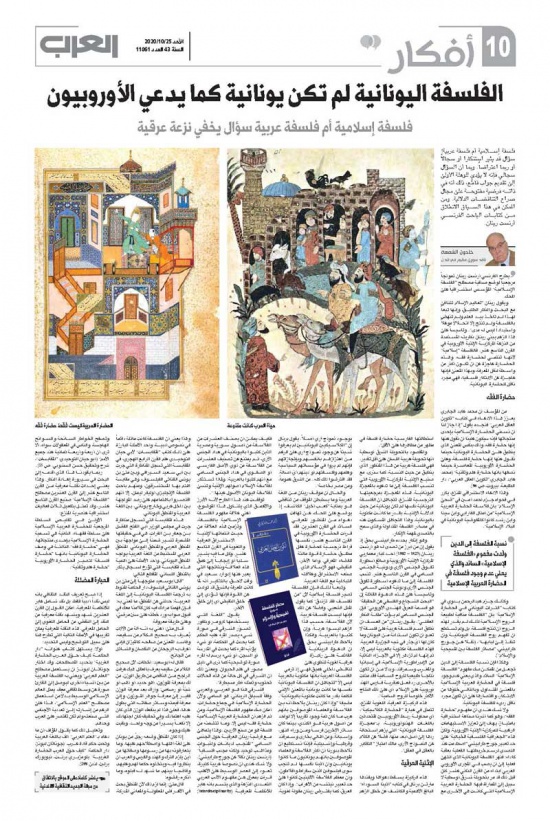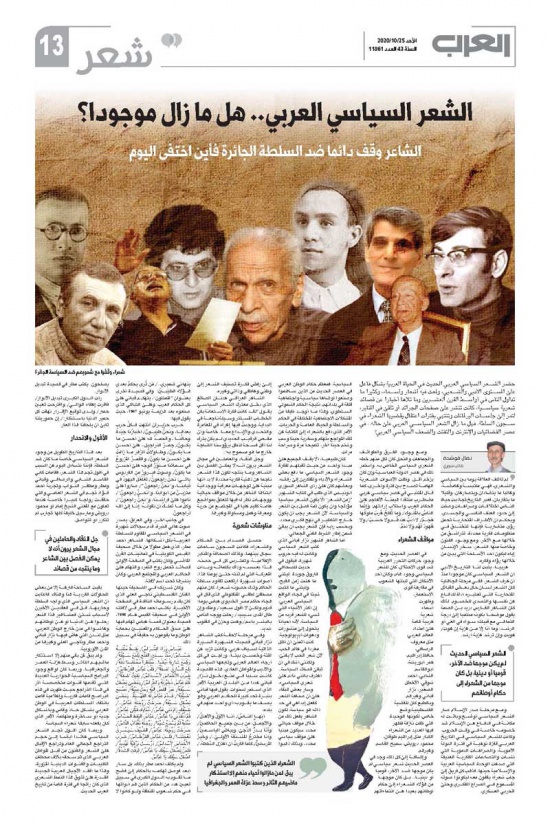اللامركزية في تونس: من رهان سياسي إلى "انتكاسة" ميدانية

وضع مشروع اللامركزية وفاعليته في تونس مجموعة واسعة من الأسئلة بشأن الحاجة إلى تحويل نظام الحكم من المركز إلى الأطراف، والقدرة على تطبيق حكم لامركزي ناجح يقطع نهائيا مع عقود طويلة من التهميش واللامبالاة والمعاناة التي عايشتها مناطق داخلية تونسية.
تونس - بدا مشروع تطبيق اللامركزية في تونس معلقا بين الترتيبات الإدارية “المزاجية” للسلطة المركزية والواقع الميداني المتشظي والمفتوح على أكثر من أزمة، منذ تنظيم أول انتخابات بلدية في أعقاب ثورة يناير 2011.
وتعيش تونس على وقع مخاوف من ضبابية المشهد السياسي المتأزم والصراع العلني بين رؤوس الحكم والمعارك الحزبية وسط تعالي المطالب الاجتماعية التي تنذر بدخول البلاد مرحلة حرجة، خصوصا مع تفاقم المشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد وتعطل حركة الإنتاج على أكثر من صعيد.
كان الحديث عن اللامركزية قبل عامين تقريبا، وفي مثل هذا التوقيت بالذات، وغزا جل المنصات الإعلامية في تونس بوسائلها المتعددة، حيث تداول خبراء وساسة وإعلاميون هذا المشروع بالنقاش والتحليل، محاولين الوصول إلى أبعاده المختلفة ومآلاته والحدود القصوى التي يمكن أن يلامسها على أرض الواقع.

وينظر إلى مشروع اللامركزية، الذي خصصت له موارد مالية هامة، وباركه فاعلون سياسيون والمجتمع المدني على أنه يمكن أن يكون أداة تنفيس للضغط المسلط على كاهل الدولة.
وتعاني مناطق داخلية في تونس من الفقر والأزمات التنموية والاجتماعية المتفاقمة، حيث علت الأصوات المطالبة بالقطع مع سلطة المركز وما خلفته طيلة عقود طويلة من التهميش والتمييز الجهوي.
ويرى مراقبون أنه رغم هالة التهليل ورهانات الدولة الكبيرة على المشروع، إضافة إلى حزمة التشريعات القانونية التي وضعت له والتمويلات المالية التي رصدت، إلا أن مشروع اللامركزية في تونس بدا منتكسا بعد مرور سنتين على انطلاقه.
ويرجع السياسي التونسي أحمد نجيب الشابي تعطل اللامركزية في تونس إلى إرادة النخب السياسية والفاعلين عموما لعدم تقبلهم فكرة أن الحكم المحلي هو السبيل الوحيد للنهوض بالواقع المتأزم الذي تعيشه البلاد، إضافة إلى آفة البيروقراطية التي تمثل أزمة في حد ذاتها.
ويقول الشابي في تصريح لـ“العرب” إن تطبيق اللامركزية في تونس يصطدم بعقلية متحجّرة لدى النخب السياسية التي بقيت مشدودة إلى أفكار الماضي ومتأثرة بممارسات قديمة ونسيت أن العالم تغير ولا بد من ركوب قطار التغيير.
ويؤكد السياسي المخضرم، الذي عايش حقبات واسعة من تاريخ تونس، أن ما يعوز تطبيق اللامركزية في بلاده هو نمط التفكير الذي يحرك الطبقة السياسية التي تخشي اللامركزية وتعتبرها مدخلا لتفكك الدولة وبالتالي هم (السياسيون) لا يريدون أن يدفعوا باتجاه إنجاح هذه التجربة.
خيار الضرورة

جاء مشروع اللامركزية كخيار ضرورة وليكون بديلا لمعالجة الارتدادات السلبية لمركزة القرار والثروة طيلة عقود في تونس. تلك السياسة دفعت إلى تواتر الاحتجاجات ذات الطابع المطلبي المتزايد، اقتصاديا واجتماعيا، وكان مأتاها الأساسي من المناطق الداخلية.
وحمّل كثيرون مشروع اللامركزية وعود الرخاء ومفاتيح حلّ معضلة عدم التوازن الجهوي على مستوى التنمية وتوفير الخدمات والبنى التحتية الأساسية، لكنه بدا مثقلا مع واقع السياسة التنموية للبلاد.
وأمام تعاظم الرهان السياسي على هذا المشروع الذي أضفى عليه المهلّلون صبغة العدل وفرض التوازن بين الجهات في منطلقه ولقيَ من الإشادة والترحيب الشيء الكثير من الأوساط الداخلية والعالمية، كان لا بد من وضع سيناريوهات عديدة تتوقع إمكانية النجاح كما الفشل على حد سواء.

وتطرح أسئلة تفتح الباب أمام تأويلات عديدة تبحث عن إجابات في خضم السيرورة الحاصلة داخل المجال الجغرافي التونسي بمختلف أبعاده المترابطة والمتشابكة، بدءا من المجال المحلي الضيق الباحث عن التنشيط، مرورا بذلك الجهوي الواسع النطاق المراد تحريكه، ووصولا إلى الوطني الأوسع نطاقا والذي بلغ منتهاه من التشبّع المطلبي ويراهن على التغيير هو الآخر في استراتيجيات التنمية والتطوير لديه.
ويرى عمر بالهادي، الأستاذ المتخصص في الجغرافيا البشرية بكلية العلوم الإنسانية في تونس أن المشروع ليس خطأ وهو ممكن شرط اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لذلك.
ويعتبر بالهادي في تصريح لـ“العرب” أن مشروع اللامركزية تعترضه عدة معوقات وعراقيل نظرا لتعّود الجميع على المركزية المشطة طوال 60 سنة، سواء السلطة المركزية التي تتشبث بسلطتها الواسعة نتيجة القوانين والعقلية والاعتمادات المركزة في أيدي المركز من وزارات وشركات ووكالات وطنية، أو كذلك السلطة المحلية التي لا تزال بصدد التأسيس وتفتقر إلى الإمكانيات والموارد وتحتاج إلى التمكين ووضع القوانين.
ويتساءل محللون ومهتمون بتجربة اللامركزية بشأن حاجة تونس إلى تحويل نظام الحكم من المركز إلى الأطراف، وهل أنها كانت مهيأة لنموذج الحوكمة وتفعيل التشريعات والقوانين التي سنّت بغاية تطبيق الحكم اللامركزي.
كما تطرح أسئلة حول إلى أي مدى يمكن أن تكون الأزمات التي تعيشها تونس على غرار تعطل إنتاج الفوسفات في قفصة أو أزمة “الكامور” في تطاوين وغيرها من الأزمات المتشابكة التي تظهر كل يوم (مؤخرا سبيطلة)، انعكاسا للتجارب الفاشلة للحكم المحلي.
أزمة موروثة
يعتبر عمر بالهادي، الأستاذ والباحث في جغرافية المدن والأقاليم، أن “المجتمع لا يكون دائما مهيأ للإصلاحات الهيكلية الكبرى مهما كان نوعها وشكلها”.
ويقول إن “تونس كانت بحاجة إلى التغيير منذ الثمانينات عندما بدأت مسألة الجهوية (المناطقية) تطرح بقوة، حيث برزت مظاهر التفاوت الجهوي على عدة أصعدة، والثورة كانت المناسبة التي سمحت بهذه التشريعات من خلال المطالب التي رفعت خلال الفترة 2014-2011”.
ويقف المراقبون لمسار الحكم اللامركزي على حصيلة هزيلة لنشاط المجالس البلدية بعد سنتين من التجربة التي ينظر لها بعين الريبة والتحسر وتترجمها التقارير السنوية للجان المكلفة بمراقبة نشاط هذه المجالس.
وأظهر تقرير الهيئة العليا للمالية المحلية الأسبوع الماضي حول مساهمة البلديات في الاستثمار، أن جلّ هذه البلديات تقريبا غارقة في المديونية، ما يثير الشكوك حول أدائها رغم ترسانة القوانين والتشريعات التي خصصت لها.
وأكد التقرير، الذي رصد أداء البلديات في العام 2019، على ضعف المساهمة الجملية لها في نفقات الاستثمار بنسبة 4 في المئة مقارنة مع مواردها الاعتيادية المنجزة والتي بلغت 47.2 مليون دينار سنة 2017 لتصل إلى 1168.9 مليون دينار سنة 2019.

وليس هذا فحسب بل إن العديد من المراقبين يرجعون البداية المنتكسة لتجربة الحكم المحلي إلى الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها تونس، والصراع المعلن مع السلطة المركزية التي تهتم أكثر بما هو مركزي ويضمن الاستقرار والاستمرار، مما يفسر تغيير الأولويات وخاصة تلك التي تتطلب موارد هامة أو تشتيت المجهودات.
وفي بلد مثل تونس كغيره من دول العالم ينصبّ التركيز فيه حاليا على محاربة جائحة كورونا، فإن الأولوية تضع إدارة الأزمة الصحية قبل كل شيء. هذا بالإضافة إلى الأزمة السياسية التي تجعل السلطة الجهوية في آخر اهتمامات الأحزاب النافذة التي ربما ترى فيها خطرا على موقعها ومصيرها. وهو ما يفسّره الباحث عمر بالهادي بقوله إن “كل هذه العوامل تتضافر وتفسّر التباطؤ الملحوظ في تمكين السلطة الجهوية والإقليمية”.
ويضيف أن “البرامج مفقودة حتى على المستوى الوطني، فكيف تكون موجودة على المستوى المحلي؟ فالأزمة الاقتصادية خانقة والدولة أصبحت غير قادرة حتى على تخصيص مبالغ مقبولة للتنمية، إذ النسبة الأعظم موجهة للأجور والتعويض وتسديد الديون. ولا تبقى إلا نسبة محدودة للتنمية. وفي هذه الحالة، فإن المجهود يتوجه إلى تأمين الاحتياجات الدنيا”.
لكن هذا الموقف بدا غير مقنع لبعض المراقبين الذين يرون أن المجالس البلدية المنتخبة في العام 2018 تعمّدت الاستعراض السياسي، متجاهلة بذلك العمل على تطوير الخدمات بالجهات التي شكت طويلا من المركزية.
ويؤكد رئيس لجنة المالية في البرلمان التونسي هيكل المكي في تصريح سابق لـ”العرب” أنه “من غير المقبول أن تنصرف المجالس البلدية إلى معارك أخرى بعيدة عن اختصاصاتها وبمنطق المغالبة ولتنفيذ مخططات أيديولوجية”.
ويضيف في هذا السياق أن “للمجالس البلدية أدوارا أخرى أهم من خلق معارك جانبية تتماشى وأيديولوجية البعض.. وهذه المجالس البلدية مطالبة بالنهوض بالبنى التحتية والإنارة والنظافة وغيرها”.
مشروع شامل

يرى بعض المحللين أن إمكانيات تحقيق مشروع اللامركزية في تونس هائلة، لكن هذا المشروع لن يكتب له النجاح ما لم تدل جميع الأطراف بدلوها، بدءا من الحكومة المركزية والسلطة المحلية، مرورا بالمجتمع المدني، ووصولا إلى الجهات الدولية المانحة.
وتعلو المطالب بضرورة إعطاء المزيد من الصلاحيات للسلطة المحلية وعدم حصرها في أنشطة جانبية، حيث يتطلب ذلك قدرا كبيرا من الانفتاح والوعي لدى الفاعلين السياسيين وترسيخ فكرة الديمقراطية.
وينظر إلى الطبقة السياسية في تونس على أنها لم تستوعب فكرة تفعيل الحكم المحلي وأنه لا يعني الحد من المجال التقليدي لسلطة المركز، بقدر ما هو إشراك لمختلف الفاعلين من مجتمع مدني ومنظمات اجتماعية حسب ما جاء في الدستور.
ويؤكد أحمد نجيب الشابي أنه “حان الوقت لوقوف جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين من أجل الدفاع عن مشروع اللامركزية، وضرورة التوافق على إنجاحه لأنه السبيل الوحيد لإخراج تونس من أزمتها”.
وقدم تصوره للمشروع الذي قال إنه “لا يكون إلا بوضع خطة عمل على المدى البعيد تكون مرفوقة ببرنامج واضح، يلتزم به الجميع ويعملون على تطبيقه”.