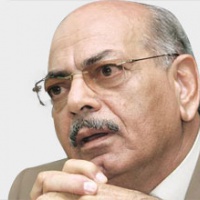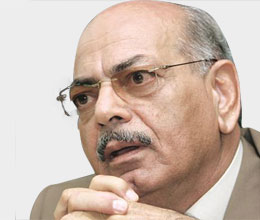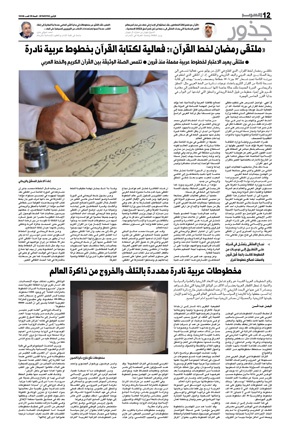القصيدة وعزلتها البيضاء
كلنا، أومعظمنا على الأقل، يتذكر كيف كنا في شبابنا الشعريّ، نتسابق، للإعلاء من قيم الجمال المحض، والسعي، بحماسة مفرطة، لكتابة قصيدة حديثة تقيم دائما في فضاء خاص، يحفظها من مكائد الواقع وكمائنه المبثوثة في الحياة التي كان الكثير منا لا يتعامل معها إلاّ بمجسات من جنون الشباب ورغباته المشبوبة. وكان الجهد الشعري والجهد النقدي، آنذاك، يسعيان، كلاهما تقريبا، في الاتجاه ذاته؛ من أجل قصيدة منقاة من براثن الواقع وقضاياه، التي كنا نعتقد، أنها مفسدة لنقاء القصيدة، وانتهاك لعذريتها الصافية.
وفي أحيان كثيرة، تكون للواقع سطوة كبرى على الذاكرة، فهو الخبرة الحادة والمباشرة لما نرى ونسمع ونعيش، وهو المكابدة حين لا نكون على تماس مع الألم فقط، بل حين ترتطم به أرواحنا الفزعة فينزّ منها أنين أسود، له مذاق الدم ورائحة أجساد بشرية محروقة. من شأن هذا الواقع الصلد أن يفتك بالذاكرة، في خلخلة الكثير من ثقتها بخزينها الثقافي والجمالي، ويبرهن إما على جدارة هذا الخزين بالحياة وإما على جدارته بالذبول.
لم نكن نظن، حينذاك، أن للقصيدة وظيفة من أيّ نوع. ليس لها أن تقول فكرة ما، أو تتبنى موقفا بذاته. “ليس على القصيدة أن تعني شيئا، يكفيها أن تكون”. هذا بعض مما ذهبت إليه بيانات الشاعر والناقد الأميركي أرشيب الدماكليش الذي سحر الكثيرين منا في تلك الفترة الملتهبة. ولم يكن يهمّ الكثيرين منا أن تضيف القصيدة إلى سلوكها الشعري، سلوكا أخلاقيا بالمعنى النبيل للكلمة، أي أن يكون وفاؤها للجمال جزءا من نبلها الشعري الذي تحققه اللغة وتضيئه التجربة، ولم نكن، في أعمارنا تلك، على وعي كاف بأن القصيدة تجسيد لبنية متعاضدة: بنية القول وبنية الموقف في عجينة لغوية شديدة الترابط.
وكانت ثمة وليمة من نوع آخر تقام على الضفة الأخرى من النهر: فريق من الشعراء، أكثر حماسا ربما، يتبنى جمالية معاكسة، وعلى تضاد شديد مع الجمال المحض الذي كنا نحلم به. وكان هذا الفريق يسعى، بهمة عالية، إلى تحريض القصيدة على الخوض في تفاصيل ذلك الواقع، والسير، حافية، في أحيائه المكتظة وأزقته المتداعية. كان هذا الفريق، الساعي إلى القصيدة الذاهبة إلى المعنى الواقعي أو ما يقاربه، يتكون من شعراء يكتبون قصيدة التفعيلة وآخرين يكتبون القصيدة العمودية، وكان الفكر الماركسي والقومي هو الخزان الأيديولوجي الرئيسي، تقريبا، للشعراء من كلا الاتجاهين.
وعلى عكس الداعين إلى القصيدة الحديثة، لم يكن لقصيدة الواقع برهانها النقدي الواسع. لم تكن لها ترسانتها النقدية المؤثرة، بل كان لها تطبيقها الشعري، الذي يحظى بسطوة كبيرة على حاسة التلقي العام، أعني تلقائية الشارع الذي كان يجد نفسه في حل من اشتراطات التلقي العارف أو المدرب. لقد كان برهانها الشعري، أحيانا، أشد تأثيرا من حاجتها إلى خندق نقدي مساند.
وكان الواقع العربي، آنذاك، يغذي قصيدة المعنى بحاجتها من الأحداث، بعد أن صار ملتقى للتصدعات القطرية التي تداهمه من كل حدب وصوب، وبعد أن انحدرت أحلام الستينات الكبيرة، في الشعر والفكر والسياسة، إلى آبار الدم والانكسارت المتواصلة، حيث تتفكك مقومات الأمل تباعا، وتتقهقر الأناشيد الطافحة بالوعود شيئا فشيئا. وكنا، كلما تداعى حلم من تلك الأحلام الكبرى، حثثنا خطانا في اتجاه المزيد من اليأس. وهكذا وجدت هذه القصيدة ما يغذي شهيتها لهجاء السلطة والتعلق بالأمل وإن كان كاذبا، أو في رمقه الأخير.
كان هناك، على مستوى القصيدة الكلاسيكية، محمد مهدي الجواهري، وعمر أبو ريشة وبدوي الجبل، ونزار قباني، وعبدالله البردوني.. وآخرون. أما على صعيد قصيدة التفعيلة فكان البياتي، وخليل حاوي، ومظفر النواب، وسميح القاسم، وأمل دنقل أكثر الأسماء وضوحا. جوقة من شعراء القصيدة الكلاسيكية وقصيدة التفعيلة، تمثل آخر ما في جبهة الشعر من طاقة في التفاعل الحي مع الناس والقدرة على تعبئة وجدانهم الوطني والاجتماعي.
وللمفارقة، قدم ذلك الواقع للقصيدة الحديثة فرصة ثمينة. لم يقدم لها ما يديم جدالها من أجل قصيدة تعتزل الواقع وتديم نفورها منه، بل ساعدها، بالنتيجة لا بالقصد، على إعادة النظر بما كان يترسخ من مفاهيم وتصورات في الشعر والجمال ومعنى الحياة، من أجل قصيدة تكمل مسعاها صوب شعرية متفتحة على الآخر الضحية والآخر المستبد.
وهكذا وفي غمرة ذلك المناخ النفسي الحافل بالمرارة والتشظي، كواقعنا الذي نتجرعه اليوم: كانت تصوراتنا، عن الشعر وجدواه، تفقد الكثير من بريقها الفاتن تدريجيا. وأخذنا نصغي إلى بعض تلك المفاهيم والتصورات وهي ترتطم، في دواخلنا، ببعضها بعضا. ولم يعد للقصيدة، كما يبدو، أن تطيل إقامتها في عزلة بيضاء، أو أن تطل من شاهق على آبار الدم وفجيعة الكائن.
شاعر من العراق