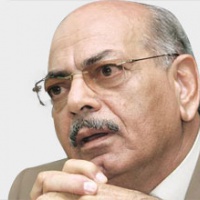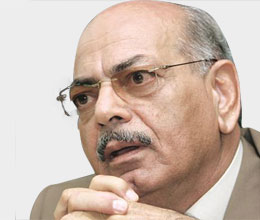الشاعر الصوت والشاعر الصدى
حين يجلس الشاعر إلى قصيدته لحظة الكتابة فلا تتصور أنه وقصيدته وحيدان في هذا الكون العاري، ولا ثالث لهما سوى رائحة الحبر وحيرة الورقة. صحيح أن الشاعر منصرف إلى قصيدته بكلّيّته، في انهماك جسدي حد الذوبان واستغراق ذهني لا يدع شيئا من انتباهه يتسرب خارج هذه اللحظة الراهنة، غير أن الحقيقة في جانبها النفسي واللغوي والثقافي ليست كذلك أبدا. فالشاعر في لحظته تلك يضم إلى روحه أطرافا من التجارب المشابهة والمضادة، الممعنة في البعد والقابلة للاشتعال في أي لحظة.
الكثير من القراءات المنسية والإيماءات الذاهبة إلى النوم منذ زمن، ستصحو بخفة ظبي وبشكل مفاجئ. وها هو وعي الشاعر، أو يقظته النهارية، يذهب إلى غروبه الدافئ وخدره اللذيذ، حيث تمتلئ الورقـة بالنوايا المتلاطمة وتفتـح أصابع الشـاعر أهدابها لتقبّل الحكمة والحنين والأحلام والألم من كل حدب وصوب، وتأخذ تلك القراءات الغافية طريقها إلى النهار.
ليس الشاعر وحده من يقوم بحياكة قصيدته الآن. هناك أمم من الشعراء والبحارة الثملين وهناك حشود من المغنين وصانعي الشباك، وزوارق محملة بالكتب والحالمين ورماة السهام. كل هؤلاء كانوا يشاركون الشاعر في صنع تلك اللحظة الفريدة، وذلك البحر الهائج من الأصداء والتداعيات. لكن الشرط القاسي في ربح هذه المنازلة أن على الشاعر أن يخلّص نفسه من هذه الشباك كلها، وأن يخرج منها جميعا متوجا بثمار تجربته الصعبة، صاعدا في اتجاه صوته الشخصي الذي لا يخص أحدا، ولا يذكّر إلا به هو دون سواه.
كلنا نتذكر أسـد الشاعر الفرنسي بول فيرلين وخِرافَه المهضومة. ألـم يقل إن الأسد قطيع من الخراف المهضومة؟ لم يكن لفيرلين بد من قول هذه العبارة الثرية بالدلالات الحسية، لجعل المعنى، معنى التفاعل بين نصوص الراهن ونصوص الماضي أدنى إلى الفهـم وفي متناول التأويل. ويقوم الأسد في عبارة فيرلين مقام الشاعر أو مقام قصيدته إن شئتم. فهو محتشد بقدرته الهائلة، لا على التقاط فرائسه المنفلتة أمامه كالريح فقط بل على هضم هذه الفرائس أيضا. إن قدرة الأسد هنا تعادل تماما قدرة الشاعر على استيعاب ما يقرأ أو قدرة القصيدة على أن تشرب مياه النصوص القديمة واصطحابها إلى معان جديدة.
هكذا هو التفاعل والتحدي بين القوى المنتجة للإبداع، وهي تتموّج محتدمة في نهر الزمن. وعلى الشاعر اللاحق أن يتملص من سحر السابقين عليه دون أن تفلت منه مكنونات ذلك السحر وما يتخفى في ثناياه من عمق وجاذبية. إنها الخصومة الخلاقة أو الارتطام الحي بين ماضي الشاعر وحاضره، بين قوته الذاتية وروافدها القادمة من بعيد.
وهذه العلاقة الحتمية والمتوترة بين الشاعر وأسلافه الخالدين ليست مضمونة النتائج دائما، فكثيرا ما يخفق الشاعر في بلورة سلوكه الشعري الخاص أو تحقيق شخصيته المتفردة. إنه قلق التأثير، بحسب نظرية هارولد بلوم في الشعر. هذا القلق الذي يحكم وبطريقة ملتبسةٍ علاقة الشاعر بأسلافه دائما. إن الشاعر بعـد هـذه المواجهة الخاسرة قد يذهب إلى الظلّ والذوبـان في هـذا الهـواء المليء بأصوات الغابرين من الشعراء. وقد يفلح في المواجهة، من خلال تمرير تلك الأصوات على جمرة روحه، ليشتعل اللهب الخفي بين النصوص، فتكتسب معنى جديدا ما كان لها أن تكتسبه لولا هذا التماس الجديد.
ومن سحر هذا اللقاء الحافل بالمشقة ومن ضرورة النقيض لنقيضه، تتولد خميرة النص الشعري الجديد وتتنامى حركة المعنى وتكتمل الدلالة. فالشاعر الحق ليس نبتة يتيمة في عراء أجرد، بل هو نشيد الجذور المتراصة احتفاء بصعود المياه إلى الأعالي، وهو الشاعر الذي نتشمم في عروقه رائحة الأسلاف كما يقول إليوت في مقالته الشهيرة “التقاليد والموهبة الفردية”.
شاعر من العراق