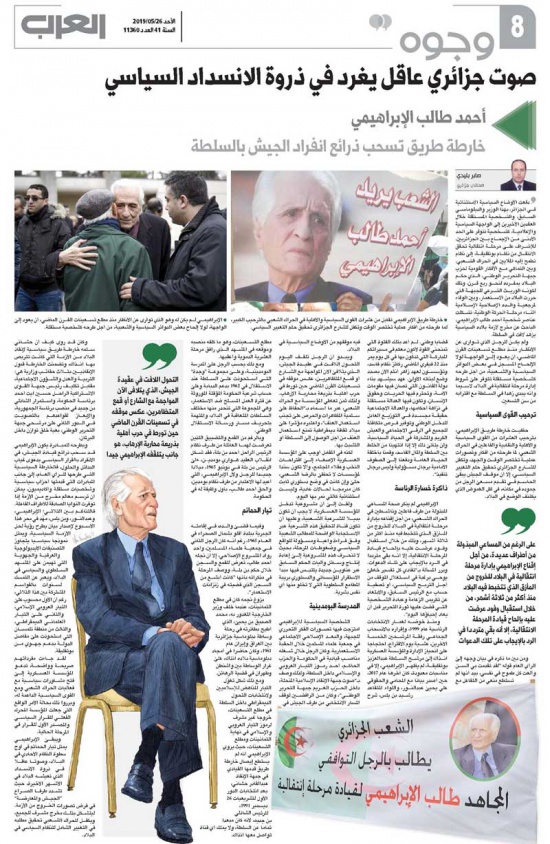السينما هي الحل لتنوير المجتمعات العربية

هل هذا العنوان يعتبر مكايدة للمتأسلمين؟ فليكن، لكن المقصود أساسا هو الثقافة بالمعنى الشامل، أي طرق التفكير وأساليب الحياة. من يرفعون شعار الحل هو التعليم، ومن يصرخون بأن الحل هو التدين، ومن يهمسون بأن العدل هو الحل… ألخ. أختلف مع الجميع، وأقول هذه الشعارات وغيرها عليها أن تنطوي تحت العنوان الحقيقي: الثقافة هي الحل. فكل ما ينادون به ما هو إلا بنود فرعية من مصطلح الثقافة. والثقافة بمفهومها الخاص والعام، دائرتها لم ولن تكتمل إلا بالخيال، ففرق من الفروق الأساسية بين البشر والحيوانات هو عمق الخيال.
الإنسان متخيل بفطرته. بخياله يحلم ويعمل لتحقيق حلمه، بخياله يضيف البعد الأهم للعلم، وهنا نؤكد مقولة أينشتاين “التخيل أهم من المعرفة!”، فأينشتاين امتلك العقل الجبار والعلم المعرفي، لكنه لم يكن يصل لنظرية النسبية إلا بخياله الجامح الشارد، ولهذا فإن الفرق بين الذكي والموهوب، وبين الموهوب والعبقري هو الخيال. قوة الخيال وعمقه وبانوراميته؛ فالمهندس الموهوب العبقري، الطبيب الموهوب العبقري، العالم الموهوب العبقري، كلهم من ذوي الخيال الرحب الوامض غير المحدود. والخيال بند بالغ الأهمية في الثقافة بكافة فروعها.
العالم الافتراضي لم يبدأ مع شبكة النت والفيسبوك وما شابه، لا. العالم الافتراضي بدأ مع بداية وعي البشر. مع التجاور الإنساني والتصادم مع بقية خلق الله، من حيوانات وطيور وزواحف ونباتات، وجمادات متنوعة. العالم الافتراضي بدأ بالنقوش في الكهوف وعلى أسطح الجبال والصخور. وهذه النقوش البدائية ما هي إلا تصوير أولي. ما هي إلا بداية الخيال التصويري.
فما تم رسمه لم يكن القصد منه النقل الواقعي، بل هو تعبير عن مشاعر الراسم الفنان، وتعبير عن مشاعر المجموعة البشرية التي يمثلها. الفنان كان يجمع في مشاعره أساطير قومه وخرافاتهم التي تم تأليفها من تشكيلات جوانب تاريخية، وأحداث صادمة وظواهر طبيعية، مع محاولات فهم الخالق الجبار العظيم وغيرها. وقتها كان الكلام قاصرا، ولم تخترع الكتابة بعد. ثم اتضحت الصورة أكثر في نقوش المعابد ورسوماتها، ثم الرسومات على الجلد والخشب.
ثم اخترعت الكتابة واخترع الورق، فتغلب السرد بأنواعه على الصورة بمختلف تنويعاتها، خاصة بعد اختراع مطبعة نورمبرج، ثم عادت الصورة لتتغلب على الكتابة حين اخترعت الكاميرا الأولية، التي تطورت مع الوقت لتستطيع التقاط ما تراها بإتقان، ثم بدأت الفنيات الإنسانية تتدخل في التصوير بالكاميرا، بتعمد اختيار درجات اللون وزوايا التصوير. ثم تطورت الكاميرا تطورا نوعيا مذهلا حين تمكن الأخوان “لوميير” من اختراع آلة تستطيع تصوير متتاليات الحركة، فكان الشريط السينمائي.. وكانت بداية الفيلم. بداية الشاشة السينمائية (الشاشة الفضية) وبعدها الشاشة التليفزيونية، ثم الشاشات الرقمية، التلفزيون الرقمي وشاشات الكومبيوتر والتليفون الموبايل (الشاشة الزرقاء).
في عصرنا الحالي، تقريبا في كل بيت في أنحاء العام شاشة تلفزيون أو أكثر، شاشات تعرض ما تجود به مئات القنوات الفضائية، وفي أغلب البيوت جهاز كومبيوتر أو أكثر تتم على شاشته متابعة ما يعرض اليوتيوب والفيديو، بل يتم مشاهدة أفلام كاملة، وصار كل من الشيخ العجوز والطفل الصغير يحمل تليفونا محمولا يحتوي على شاشة.
شاشة يمكن مشاهدة الكثير والكثير عليها. دون شك، شاشات السينما وأتباعها أصبحت مصدر المعلومات الأساسية للبشر، أصبحت هي المحرك الأساسي لوعيهم. وعليه أجهزة المخابرات، وإدارات المؤسسات الاقتصادية/المالية الكبرى، لم تترك فرصة انتشار الشاشات تضيع منها، فأعملت عقولها وخبراءها، لبث نبضات تحتية ناعمة بين طيات ما يشاهده البشر على تلك الشاشات، لتوجيههم لما فيه مصلحة الأجهزة المخابراتية وتلك المؤسسات.
وعليه أقول..
إن كنا نريد تنويرا، فعلينا استخدام السينما وبقية الشاشات.
إن كنا نريد تطويرا، فعلينا استخدام السينما وبقية الشاشات.
إن كنا نريد فضح السلفية الجهادية الدموية، فعلينا استخدام السينما وبقية الشاشات.
إن كنا نريد فضح وهم الخلافة الإسلامية، فعلينا استخدام السينما وبقية الشاشات.
إن كنا نريد حرية المرأة، وفهم الأقليات، والعمل على تمازج المجتمع.. الخ، فعلينا استخدام السينما والتلفزيون.
وإن كانت السينما (الثقافة) بكل هذه الأهمية، بكل هذه الخطورة، فهل من الذكاء أننا في مصر وشامل البلدان التي تستخدم لغة الضاد، كلها لم تضع السينما (الثقافة) بندا من بنود الأمن القومي؟! في مصر كيف تركنا الزوايا والمساجد الصغيرة تحت العمارات بالملايين، ونعلم علم اليقين بأن الممسكين بمكبرات الصوت، في تلك الزوايا، نسبة كبيرة منهم ما بين جاهل ومتطرف؟
صارت مكبرات الصوت من أهم عوامل التخلف وأهم أعداء التطور، فهي مع النقل الانتقائي من السلف المتحجر الكاره، ومع الماضي وضد المستقبل، مع الحشود المغيبة وضد العقول النيرة. لن نتقدم ومكبرات الصوت في تلك الزوايا تنشر الترهات. هل تعلمون ما هي القوى التي يمكنها محاصرة طوفان التخلف ذاك؟ إنها دور السينما. دور السينما التي كانت منتشرة في الأحياء الشعبية. حيث كان الناس البسطاء يرتادون تلك السينمات، وكانت النساء بالملايات اللف وملابسهن البسيطة، يدخلن تلك السينمات ويشاهدون الأفلام المصرية والأجنبية.
أقولها بجرأة يحسدني عليها العقلاء، تلك السينمات الشعبية التي كانت ثم بادت، دور من أدوارها أنها مراكز إنتاج أفكار! أفكار خام بسيطة تمور في الدواخل، وتتفتح لتتفكر وتتخذ قرارات شعبية، هامة وإن بدت بسيطة، فهي الخلفية المشاركة في تكوين الشخصية والعقلية الجمعية للعامة. وهي كما تشغل الفكر، هي تشغل الخيال. السينمات الشعبية هي مراكز بحوث شعبية غاية في الأهمية، تم وأدها مع وأد شامل للحياة المدنية منذ عقود سادت فيها الدكتاتوريات المتنوعة.
في الإسكندرية البطلمية، يقال إن الفيلسوف ديمتريوس الفاليري، هو من أشار على الملك بطليموس الأول بإنشاء مكتبة الإسكندرية، وأرى أن الفاليري لو كان معنا الآن، لنصح الرؤساء ببناء أكبر عدد من دور السينما، قبل أن ينصح بالمكتبة. لماذا يا هذا؟ لأن مجتمعنا يكاد يكون نصفه أميّا، وحتى من يقرأ ويكتب، لا يقرأ حقيقة! ومن هنا تزداد أهمية دور السينما. وحين أقول دور السينما، فأنا أقصد المعنيين، دور بمعنى المكان والمبنى المخصص لعرض الأفلام، ودور بمعنى المهمة. السينما هي التي تستطيع تقوية روح الفنون والانطلاق، وهي حائط الصد التنويري الحامي لطبقات الشعب المستهدفة من قِبل جماعات الإرهاب. دور السينما وكأنها مراكز بحوث شعبية، تتلقى وتتحلل وتتأثر بالمعروض، وحسبما تتلقى يكون التأثر.
السينما (الثقافة) أمن قومي، وهي أهم وأخطر من تركها بين يدي السينمائيين، تماما كما قيل إن الحرب أهم وأخطر من تركها بين يد العسكريين، كما عرفنا بعد سنوات طويلة من الجهل، أن الرياضة، وهي بند من بنود الثقافة، عرفنا أنها أهم وأخطر من تركها بين يد الرياضيين! فالرياضة ليست لهوا وتضييع وقت.