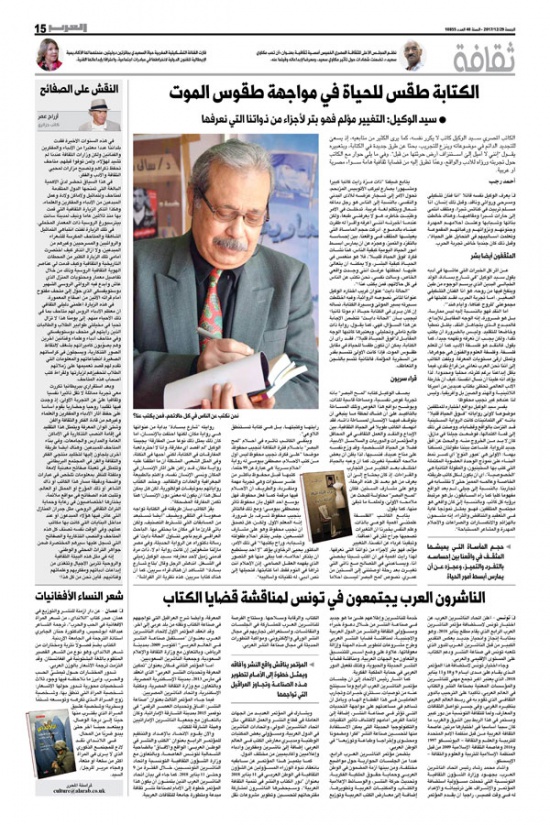الدواعي الموضوعية لتراجع المستوى التعليمي
توفُّر الكمّ الهائل من المراجع والمصادر سواء كانت ورقية أو إلكترونية يوحي بأن سبل البحث والتكوين وتنمية المدارك ونسب الذكاء أصبحت متاحة وفي متناول كل طالبيها، ونخص بالذكر منهم تلاميذ المدارس الإعدادية في سنواتهم الدراسية الأولى أو المعاهد الثانوية أو حتى طلبة الجامعات والكليات على اختلاف الاختصاصات ذات البعد الأدبي أو العلمي أو التقني.
هذا الاعتقاد يوحي أيضا بأن الضغوط المتعلقة بالتعلّم والمتعلّمين ستخف من على كاهل الأسر على المستويين؛ النفسي والمادي.
ولكن للواقع ونتائجه المترتبة عن التجربة اليومية التي تعيشها العائلات ويعيشها كذلك الإطار التربوي، معطيات أخرى تضعنا أمام مفارقات عجيبة، فتوفّر المعلومة الدراسية وسهولة الحصول عليها كان من المفروض أن يساعدا التلميذ أو الطالب ويدفعانه إلى التكوين وتنمية نسب استعمال العقل وتنمية نسب الذكاء لديه، بل العكس تماما هو الذي حصل -دون اعتبار الاستثناءات طبعا- فالمعادلة انقلبت حيث أصبح المتميزون في أي فصل وفي أي اختصاص يمثلون نسبة ضعيفة لا تتجاوز تقريبا العشرة بالمئة من مجموع العدد الجملي لتلاميذ الفصل الواحد.
الغريب أيضا أن المستوى المتوسط هو أيضا يمثل نسبة ضعيفة من المجموع العام، أما النسبة الأكبر فهي للذين يعانون من مشكلات متعددة في التمدرس تختلف حدّتها من تلميذ إلى آخر وفق مجموعة من المعايير والمقاييس التعليمية تحددها المنظومة ككل في جانبها التقييمي والجزائي.
وفرت الشبكة العنكبوتية بمختلف مواقعها وصفحاتها الإلكترونية ومحركات البحث أيسر السبل للتزوّد بالمعلومة حتى أن هناك دروسا في مختلف المواد جاهزة في بعض المواقع التي تُعنى بالتعليم وما على التلميذ أو الولي أو المربي إلا الاطلاع عليها لمزيد الفهم والاستيعاب أو لترسيخ معلومة وقع تداولها في الفصل.
يعني -نظريا- أن كل هذه الوسائط الإلكترونية تساعد على تجويد المستوى التعليمي، وهو الأمر الذي حدا بأغلب الدول العربية لاعتماد التكنولوجيا الحديثة في منظوماتها التعليمية وخاصة في استحداث مادة الإعلامية وجعلها فرعا من فروع الدراسة الإعدادية والثانوية والجامعية لأهمية استغلالها حتى في منظومات العمل الإداري.
ولم تستطع الأسرة استغلال هذا الزخم الإلكتروني لفائدة أبنائها إما لعدم الاقتناع بجدواها والتشبث بالأساليب التقليدية للتمدرس، وإما لعدم القدرة على استغلالها الاستغلال الأمثل، وإما لتجنيب الأطفال -خاصة في المرحلة الابتدائية- التعامل مع الوسائط الإلكترونية خوفا عليهم من استغلالها في اتجاهات أخرى لا أخلاقية أو تقودهم إلى الإدمان عليها.
لم تستطع الأسرة استغلال هذا الزخم الإلكتروني لفائدة أبنائها إما لعدم الاقتناع بجدواها والتشبث بالأساليب التقليدية للتمدرس، وإما لعدم القدرة على استغلالها الاستغلال الأمثل
ولم تنجح عملية تجويد المستوى التعليمي في المؤسسات التربوية نسبيا، لأسباب عديدة لعل أهمها؛ أن الموازنة بين التعليم التقليدي الذي يعتمد على الوسائط الورقية والتدخل المباشر والآني للمدرّس لغاية التقويم ثم التقييم، وبين اعتماد وسائل التكنولوجيا الحديثة (إنترنت وكمبيوترات وآلات عاكسة vidéo projecteur) بالإضافة إلى الدروس التي يقع بثها إما عن طريق الوسائط الإلكترونية وإما عبر شاشة التلفزيون.
أما السبب الثاني فيعود إلى التغييرات العميقة التي شهدها المجتمع والأسر بالخصوص، والتي تتمثل في تسريع نمط العيش بعد أن كانت العائلة تنعم بالهدوء ما ساعد على توطيد العلاقات بين أفرادها. في الوقت الراهن يطرح سؤال ملحّ؛ من يربي الأطفال في ظل خروج الزوجين معا للعمل؟
أكيد أن الإجابة ستعرّف الأنموذج الحالي لتركيبة الأسرة وللعلاقات التي تجمع أفرادها. لا ننكر بأن الحياة تطورت وتطورت معها الوسائل التعليمية -الوافدة من ثقافات أخرى ومن حضارات مختلفة عنا- ولم نهيّئ لها المناخ السليم لتيسير التآلف والاندماج بين تعليم بوسائله التقليدية وبين منتجات التكنولوجيا الحديثة. والنتيجة هي أن هناك شرخا ما في العلاقة التعليمية بين الخماسي المشارك في العملية وهو؛ الأسرة، المدرسة، التلميذ، المدرّس، والسياسة أو المنظومة التعليمية. وهذا طبعا ما يجعل المستوى التعليمي عموما ينحدر نحو الضعف وفي بعض الأحيان نحو عدم الجدوى.
ومما لا شك فيه أيضا أن استيراد نماذج تعليمية من الدول الأوروبية مثل النموذج الكندي أو الفرنسي، بكل حيثياتها وتفاصيلها الدقيقة ودون مراعاة للخصوصية الاجتماعية والحضارية وخاصة المادية والمتمثلة أساسا في انعدام البنية التحتية القادرة على استيعاب النماذج الجديدة خاصة وأن التعليم في المناطق الريفية يعاني مشكلات لا حصر ولا عدّ لها، ساهم في تدني المستوى التعليمي للتلميذ.
بالنتيجة هل العيب في الأسرة ومرافقتها لأبنائها أم العيب في المنظومة التعليمية أم في المعلّم والمتعلّم أم في البرامج أم في الوسائط الورقية والتكنولوجية؟
كلها مجتمعة عوامل موضوعية ساهمت في انحدار المستوى التعليمي مما سلط ضغوطا كبيرة على المسؤولين مركزيا وجهويا ومحليا، وعلى الأسرة التي أصبحت تبحث عن “المكملات” التعليمية لأبنائها عبر الانخراط الطوعي في الدروس الخصوصية، وعلى المدرّس الذي أصبح يرى بأن مجهوداته غير مثمرة، فهي هباء منثور.
كل هذا دفع إلى الارتجالية والتجريب دون وجود مشروع متكامل مدروس ينجز على فترات زمنية ولكنه يحقق النتائج المرجوّة وأهمها دون شك تحسين المستوى التعليمي للمتعلّم.
كاتب من تونس