التلاعب بمفهوم القوامة الدينية وسيلة السلفيين للتغلغل في المجتمعات

أسفرت الانتخابات التشريعية في مصر سنة 2012 عن تصدّر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين، بواقع 43 بالمئة من المقاعد البرلمانية، بينما حصدت الكتلة السلفية المكونة من حزب النور وحزب الأصالة وحزب البناء والتنمية 25 بالمئة من المقاعد، مع العلم أنّ كل هذه الأحزاب أُنشئت بعد الثورة، أي أنّها في أقل من عام استطاعت أن تحصد ربع المقاعد في مجلس النواب.
تذكر الكاتبة رباب كمال في مقدمة كتابها “القوامة الدينية في خطاب السلفية” ذلك اليوم حين سمعت بعض الإعلاميين يستهجنون ما آلت إليه الانتخابات، ويتساءلون: كيف استطاعت الأحزاب الإسلامية والكتلة السلفية تحقيق هذه النتائج؟ وكيف استطاعت الأفكار الدخيلة أن تنتصر على المجتمع؟
وتقول “كان السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو: هل السلفية دخيلة على المجتمع أم أنّ النخب انعزلت مجتمعيا إلى درجة الانفصال عن الواقع؟”.
لتبيّن أن انتصار السلفية الحقيقي في الانتخابات التشريعية لم يكن ناجما عن قدرة الأحزاب على الانتشار السريع، بل يعود إلى انتشار الأفكار السلفية مجتمعيا، أي إلى “تسلف المجتمع” العربي.
وتكشف الكاتبة المصرية أن الانتخابات التشريعية التي عرفتها مصر مع ثورة يناير سبقتها مظاهرة حاشدة الجمعة 29 يوليو 2011، في ميدان التحرير في القاهرة، عُرفت باسم جمعة الشريعة بين أنصار السلفية، بينما عُرفت بـ”جمعة قندهار” بين جموع التيار المدني. لعل أهم ما قيل في جمعة الشريعة جاء على لسان أحد المتظاهرين، حين قال “نحن القوامون”، وهي عبارة، وإن صدرت عفويا، لا يُستهان بها، لأنّها تحمل في طياتها الفكر المؤسس للسلفية في البلاد ذات الأغلبية الإسلامية.

وتلفت إلى أن اللفظ ليس بغريب، حيث سبق له أن تردد على مسامعنا من خلال ما كتبه القيادي في حماس أحمد يوسف من خلال كتابه “الإخوان المسلمون والثورة الإسلامية في إيران”، والذي أشاد فيه بكل من حسن البنا وآية الله الخميني قائلا “نأمل في ظهور جمهورية أخرى للقرآن والسلطان في المستقبل، لتتحقق لأمتنا مكانة القوامة على الناس”.
وتوضح كمال أن القوامة من الألفاظ الشرعية التي ارتبطت ذهنيا لدى العامة بقوامة الرجال على النساء، استنادا إلى الآية رقم (34) من سورة النساء “الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ”. غير أن المفهوم تسلل إلى الحقل الديني ليصبح في فهم البعض طاعة المشايخ والأئمة هي الطريق إلى الفردوس الأعلى، والعتق من جهنم في نظر الجماهير من العوام.
وهنا يتخذ مفهوم القوامة الدينية في خطاب بعض الدعاة شكلا كهنوتيا بدرجات متفاوتة، على حسب التأثير المجتمعي والتأثير في صياغة القوانين المدنية، قد يصل هذا التأثير في بعض البلاد، ذات الأغلبية الإسلامية، إلى سلطة التأديب.
وتضيف “هكذا تشكّل وعي الجمهور بأنّ الفقيه قوّام على المسلمين، ومن هنا كان العقل الجمعي للجماهير يتساءل دائما عن رأي الدين “طلب الفتوى” في أبسط أمورها الحياتية منذ قديم الأزل حتى الألفية الثالثة. وهذا الرأي الديني ليس استشاريا بالضرورة، بل يصبح في بعض الحالات شرطا لتمرير التشريعات المدنية في مجالس النواب في البلاد الإسلامية، فحين تناقش قوانين للأحوال الشخصية من زواج وطلاق وتنظيم للنسل مثلا، أو قوانين تتعلق بالعلوم والطب والتجارب السريرية… إلخ، تُناقش في إطار عدم مخالفتها للنص الديني، قبل مناقشتها في إطار احتياجات المجتمع وتطوره، فيتم تطريز القوانين بما لا يخالف رداء الشريعة.
وتتساءل كمال من يملك القوامة الدينية في الخطاب الإسلامي؟
وتتابع “القوامة أي الوصاية الدينية في الخطاب الديني الإسلامي هي الجائزة الكبرى لمن يملك صحيح الإسلام، ولكل فئة من رجال الدين صحيح إسلام مختلف عن صحيح الآخرين، بحسب الانتماءات المذهبية والتفسيرات الفقهية، ومن هنا ينشأ الصراع على من يحظى بدور ظل الله على الأرض، وهو مبدأ كهنوتي بصبغة إسلامية”.
ويُعدّ من الخطأ أن نعتقد أنّ النزاع على صحيح الإسلام قاصر على رجال الدين والمشايخ، بل امتد إلى السلطة في الحكومات المدنية، التي تتخذ من الإسلام مرجعية تشريعية، ولهذا فإنّ البحث في خطاب القوامة الدينية على المجتمع وخطاب القوامة الدينية في خطاب السلفية بشكل خاص، يجب ألا يتم دون فهم آليات البيئة السياسية والاجتماعية التي نشأ فيها.
فكثيرا ما تُمارس القوامة الدينية على المجتمعات الإسلامية في إطار تعاون واضح بين السلطة الحاكمة والمؤسسات الدينية الحكومية التابعة لها أو الجماعات الإسلامية المداهنة لها.
وفي حالات أخرى، تسعى بعض الجماعات الدينية إلى مناطحة السلطة واتهامها بأنّها لا تطبق صحيح الدين. ومن هنا تبدأ المزايدات بين السلطة المدنية والجماعات الدينية على صحيح الإسلام، والصراع على احتكار صحيح الإسلام ليس انتصارا للدولة المدنية، بل هو انتصار لفكرة الخلافة الإسلامية.
وتشدد كمال على أن خطاب السلفيّة يستند إلى مفهوم القوامة الدينية على المجتمع، ويصنع من نفسه ظلا لله على الأرض، سواء أكان خطاب ولاة أم خطاب معارضة للسلطة.
وتشير إلى أنه ربما تختلف السلفية المؤيدة للسلطة عن المعارضة لها، بحيث ترى الأولى أن الحكام ليسوا من الطواغيت، وعلى العامة طاعة أولي الأمر منهم، بينما ترى الثانية أن الحاكم بغير أمر الله يعيد إلى أمة الإسلام زمن الجاهلية، إلا أن بينهما قاسما مشتركا، ألا وهو رؤيتهما للمجتمع.
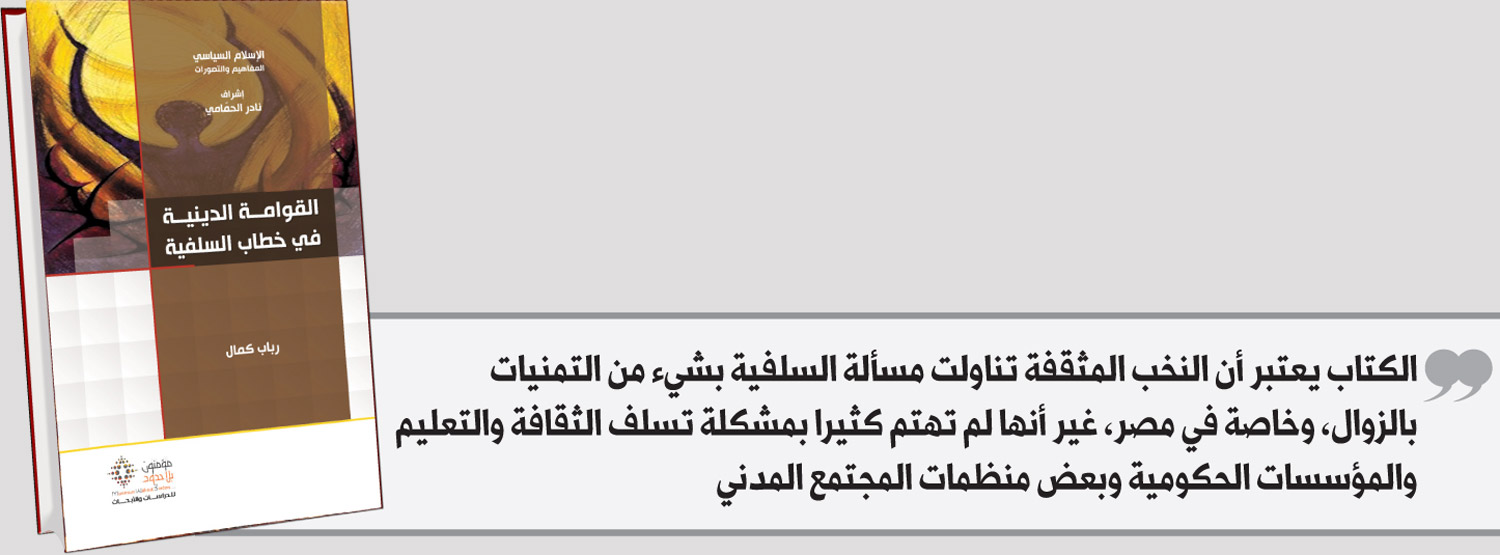
وتستغل السلفية المؤيدة لأي سلطة عربية حزمة القوانين التي تتيح لها فرصة تحريك القضايا القانونية مثل قضايا ازدراء الأديان ضد الأدباء والمفكرين والفنانين، متسلحين بشحذ همم العامة من الجماهير بهدف نصرة الإسلام، وغالبا ما توائم السلطة مصالحها مع التيارات السلفية المؤيدة لها التي لا تخرج عن دورها أو الحدود التي لا يجب أن تتخطاها.
وتنبه كمال إلى أن ما يعرف باسم الربيع العربي ساهم في زيادة المساحة التي تتحرك فيها السلفية، فانتقلت بعض التنظيمات السلفية من العمل الدعوي إلى العمل السياسي. وعلى جانب آخر ازدادت شوكة السلفية الجهادية في المناطق التي تأثرت أمنيا إبان موجة الثورات العربية. وقد تعامل جزء من الإعلام العربي مع السلفية تباعا من منطلق ظاهرة الفقاعات، أي عدّها ظاهرة حديثة غير مؤصلة، وسيطرت عليه مصطلحات تنم عن القراءة السطحية.
واستهجنت كمال تناول بعض وسائل الإعلام والنخب المثقفة مسألة السلفية بشيء من التمنيات بالزوال، وخاصة في مصر، بعدما سيطر الجيش على سدة الحكم من جديد، مؤكدة أن جزءا من النخب لم يهتم كثيرا بمشكلة تسلف الثقافة والتعليم والمؤسسات الحكومية وتسلّف بعض منظمات المجتمع المدني.
وشككت كمال في رؤية النخب التي حصرت المواجهة مع السلفيين بالمناظرات التلفزيونية، على أهميتها، معتبرة أنّ الاستراتيجية في التعامل مع تغلغل الفكر السلفي لدى القواعد الجماهيرية مازالت غائبة عن المجتمع المدني بداية من تطويع القوة الناعمة وانتهاء بتبني المشاريع التنموية.
لتخلص الكاتبة المصرية إلى أن النخب تحتاج إلى رسم خطوط متوازية للعمل والاشتباك الجماهيري في مسائل تنموية على مستوى أكبر. وهو ما قد يتطلّب عقودا طويلة ليأتي بمردوده.




























