البيت العربي التقليدي ورسم الحدود بين الداخل والخارج
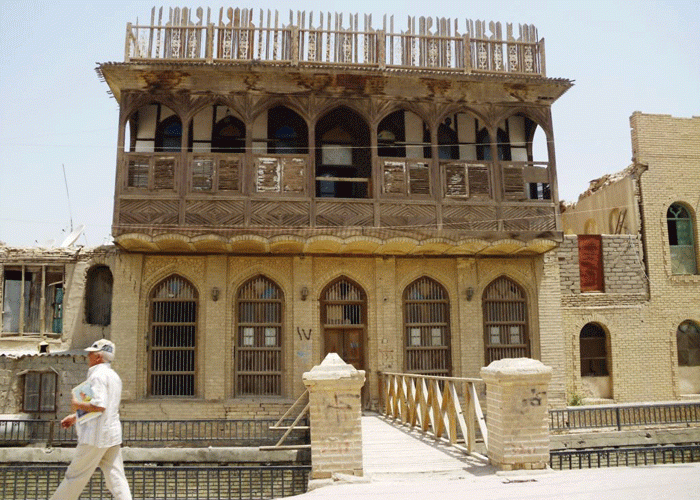
يحافظ تصميم البيت العربي التقليدي على الخصوصية والحميمية بصفة جلية، فتخطيطه العام بوصلته ومركز الجذب فيه هو الداخل، ما يجعل البيت لا يطلّ على الجيران ولا يمكّن الجيران من الإطلالة عليه، كما يسمح للضيوف بالولوج إليه لكن دون رؤيته من الداخل، لا سيما وأنّ غرفة ضيافة الرجال واستقبالهم عادة ما تطل على الشارع. أمّا إذا كان البيت مكوّنا من طابقين وهي خاصية تتميز بها بيوت الأعيان والوجهاء والأثرياء، تكون غرف الطابق العلوي محجّبة بالمشربيات أو بمكوّنات أخرى مشابهة لها تحجب عين الغرباء عن رؤية ما بداخل الغرف بالرغم من فتح شبابيكها ونوافذها لتهويتها وإنارتها خلال النهار.
أمّا الصحن الذي يقع في سرّة البيت بمنأى عن أعين الجيران والغرباء فهو يشكّل لأهله مجال حرّية مطلقة أكثر ممّا توفّره لهم أجزاء البيت الأخرى، يتنقلون فيه بحرية بين الداخل والخارج دون الإخلال بمبدأ الخلوة الحميمية، وإذا تدرّجنا من العام إلى الخاص نلاحظ أنّ الخيط الناظم للكلّ والجزء والواصل بينهما يظلّ دائما الرغبة في الستر والإخفاء، فالنوافذ التي تكون عادة ضيقة وصغيرة في أعلى الجدران على عكس ما تكون عليه في المنازل الحديثة سواء كانت شققا في عمارات أو منازل مستقلّة بذاتها واسعة وتتوسّط الجدران، فهي تخفي أكثر مما تظهر وتحجّب أكثر ممّا تمتع الأنظار.
وخلاصة الأمر، فإنّ أعمدة المنزل العربي الحقيقية التي يُشيّد عليها قبل أن تكون متكوّنة من الحجر والآجر والرخام، هي قبل كلّ ذلك تتشكّل من مجموعة من القيم الثقافية، فإذا نظرنا في كلياته وجزئياته أي من حيث تصميمه العام المتميز بدائريته وانغلاقه والتفاف جزئياته على بعضها البعض أو من خلال نوافذه ومشربياته نجده يستند إلى عمود أساس يتمثّل في الرغبة في الخصوصية والتستر، حيث يسمح فيه بالنظر من الداخل إلى الخارج ويمنعه من الخارج إلى الداخل.
ولعلّ هذه الرغبة التي لا يمكن فهمها إلّا بالعودة إلى التقسيم “الجندري” بين الذكور والإناث للمجال والمكان وإرادة تقنين التواصل بينهما وفق المنظومة الأخلاقية السائدة لا تتجلّى على أحسن ما يكون كما تتجلّى في المشربية كما يُطلق عليها في بعض بلدان المشرق العربي، أو الشناشيل في العراق، وقد عرفها المعمار العربي كما تقول المدونات التاريخية منذ العصر العباسي قبل أن يستلهمها في معمار بيوت الأتراك العثمانيين ويطلقون عليها “البرمقلي” وهي التسمية التي استقرت في اللهجة التونسية إلى اليوم والمشتقة من الكلمة التركية “بارمق “parmak التي تعني في الأصل إصبع اليد أو الرجل قبل أن تصبح دالة في التركية العثمانية مع إضافة لاحق “بارمقلق parmaqlyq” على معنى التشبيك في أصابع اليدين وفي النوافذ في ذات الوقت، وفي التركية المعاصرة للدلالة على تشبيك في النوافذ والبناءات يحمي من الشمس ويُهَوّي البيت كما أنه يسمح لمن هو فيه بأن يرى دون أن يُرى من الشارع.
المنزل العربي يستند إلى الرغبة في الخصوصية، حيث يسمح فيه بالنظر من الداخل إلى الخارج ويمنعه من الخارج إلى الداخل
وإذا كانت شناشيل العراق وبالتحديد قرية جيكور قد حظيت بالتغني والإنشاد في الأدب المكتوب وخصّص لها بدر شاكر السياب قصيدة كاملة اختارها عنوانا لمجموعته الشعرية “شناشيل بنت الجلبي”، فإنّ البرمقلي التونسي الذي مازال يوشح بعض المنازل العتيقة التي بعضها صار دورا للثقافة والفنون في تونس الحاضرة وضواحيها، قد حظي بالخصوص بتغنّي الأدب الشعبي كما في أغنية “مشموم الفلّ” التراثية التي تقول في مطلعها “للّاك حليمة من البرمقلي تطلّ علينا”، أو في السرديّات الوعظية والتعليميّة كما في حكاية “الياداس” من تراث من يُسمون بـ”البلديّة” كناية عمّن يعتبرون أنفسهم من السكّان “الأصليين” لتونس الحاضرة حيث تطلّ المرأة الضجرة من برمقلي منزلها على الشارع.
تدور أحداث هذه الحكاية بين الداخل والخارج ولكن الخارج لا نراه إلّا من خلال الداخل، من خلال عيني هذه المرأة التي ترصد ما يدور في الشارع دون أن يتمكن من فيه من رؤيتها في تواصل أحاديّ الجانب من الداخل إلى الخارج ويمنع العكس، أي يمنع تبادل النظرات بين المرأة ومحيطها الخارجي المشكّل من الذكور راسما بذلك الحدود بين المحلّل والمحرّم، وبين المشروع وغير المشروع، بين ما هو مسموح به من الحريم، وما هو محرّم عليها: أن تكون ناظرة إلى الخارج غير منظورة منه.
غير أنّ الحكاية في بداياتها تتعمّد العبث بالحدود الاجتماعية والثقافية المرسومة بينهما، وتستعمل لذلك تعلّة أخلاقية بأن تجعل المرأة ترى من البرمقلي رجلا أساء معاملة متسوّلة وعنّفها واسترجع النقود التي أعطاها إيّاها لأنّها حذرته من كيد النساء فنزلت إليه من سلالم البيت مسرعة لتأديبه وأغرته بالدخول إلى البيت بعد أن أعلمته أنّها وحيدة وزوجها غائب والحال قيلولة، لتذيقه بعد ذلك من ألوان الخوف والترويع والإذلال أطباقا وتغنم من ذلك فكّ الحصار المطبق عليها فيراها الآخرون كما تراهم على عكس ما يرغب فيه البرمقلي والمجتمع دون ارتكاب محرم كبير كانت توحي به الأحداث لأوّل وهلة، ولغايات أخلاقية محمودة يجلّها هذا المجتمع نفسه: عدم نهر السائل وتأديب كلّ من تسوّل له نفسه الاعتداء على شرف المحصّنين والمحصّنات.
البرمقلي، كما المشربية، مازال موجودا ماديا ولكن في أبنية تراثية لا تحظى دائما بالصيانة، ورمزيا بتوظيفه في التراث اللّامادي السردي والشعري الذي تتناقله الأجيال جيلا بعد جيل عبر المشافهة ولكنه يكاد يندثر في المنازل الحديثة في معظم الحواضر العربية لا فقط بسبب إعادة رسم الحدود بين الداخل والخارج، وإنّما لأنّه أصبحت تعوّضه تصميمات معمارية أخرى دخيلة كثيرا ما يقع استلهامها بطريقة آلية لا تنسجم مع طابع المعمار العربي الإسلامي وروحه.




























