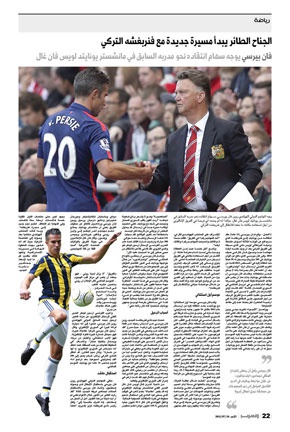الأكراد وسوريا والثورة و"يسار الممانعة"
لم تكن هناك حدود تمنع السكّان من التنقل والانتقال من ولاية إلى أخرى تحت سيطرة الدولة العثمانية خصوصا في بلاد المشرق، فكان انتقال العائلات والإقامة في أيّ من مناطقها ومدنها متاحا لمن يستطيع ويرغب، دون تمييز على أساس العرق أو الدين. فبعض العائلات كانت تتوزع بحسب مصالحها أو ظروفها بين إسطنبول ودمشق وبيروت وطبرية وعكا.
وكان الجميع يحملون الهوية العثمانية. غير أن تمييزا واضحا حصل بين السكان بعد استلام حزب تركيا الفتاة السلطة في الأسيتانة، عاصمة الخلافة. ولكنه تمييز بين الأتراك من جهة وبين سائر الشعوب من جهة ثانية ولمصلحة الأتراك بالطبع. من هنا جاءت عبارة “التتريك” لتصف سلوك السلطات التركية حيال باقي القوميات في محاولة لمحو الشخصية القومية لكل منها ودمجها بالقومية التركية، وبالأخص لجهة اللغة.
وكان الشعب الكردي كما سواه من أبناء المنطقة ينتشر في مختلف أرجائها ويشكل مع سواه النسيج الاجتماعي فيها. وكان من المتعذر أن تدخل مدينة أو منطقة دون أن تجد من بين أبنائها أسرا كردية مقيمة.
صحيح أن مناطق كردستان، التي قسمتها اتفاقية سايكس-بيكو أثناء الحرب العالمية الأولى بين تركيا والعراق وإيران، كانت مناطق كردية تماما تقريبا، غير أن السكان الأكراد كما سواهم كانوا يبحثون عن حياة أفضل في السهول والسواحل والمدن في سوريا ولبنان والأردن ومدن العراق وتركيا اليوم.
وبالنسبة إلى سوريا، توزع الأكراد في سائر المدن والمناطق دون تمييز، ولو أن الشريط المحاذي لتركيا شهد مدنا ذات غالبية كردية محدودة مثل عفرين، في حين أن باقي المناطق كانت مختلطة بين الأكراد والعرب والأشوريين مع أرجحية بسيطة للأكراد.
وبعد الاحصاء السكاني عام 1947 تحصل سكان سوريا على الهوية السورية دون تمييز. وأتيحت الفرص التي مكنها النظام للمواطنين بنفس القدر للجميع، كما تشارك الجميع أشكال المعاناة دون تمييز. فكان من الأكراد السوريين وزراء ونواب ورجال أعمال وأصحاب مهن وتجار وعاملون في مختلف الاختصاصات.
في مرحلة لاحقة، ونتيجة القمع الذي تعرض له الأكراد في إيران، ثم بعد ذلك في سبعينات وثمانينات القرن الماضي في العراق وفي تركيا، وبالتالي نتيجة تفاقم الوضع الأمني خصوصا في المناطق الكردية، نزح الآلاف من السكان باتجاه سوريا واستقروا هناك وتركزوا غالبا في المناطق المحاذية للحدود التركية. ولكن نظام حافظ الأسد، وبعده ابنه بشار، رفض منحهم الجنسية السورية. فكانت عنوانا للمظلومية التي انتفضوا لأجلها في السنوات الأولى من العقد الماضي فواجههم النظام بحملة قمع شرسة.
عدد كبير من ناشطي الأكراد القادمين من العراق وخصوصا من تركيا كانوا من أتباع حزب العمال الكردستاني، أو التحقوا به، في حين أن آخرين يتوزعون التأييد بين مسعود البارزاني وجلال الطالباني وحزبيهما، وجلّهم من كردستان العراق.
شكّل الناشطون من أتباع حزب العمال الكردستاني حزب الاتحاد الديمقراطي الكوردي (P Y D) وهم أكثر الأكراد غلوا في المسألة القومية.
مع اندلاع الثورة السورية عمل النظام السوري على استقطاب هذا الحزب وسواه، وبعد اتساع رقعة الثورة نسق معه في المناطق الشمالية الشرقية وسلمه إدارة بعض المدن والأحياء والمناطق التي اضطر للانسحاب منها. وكان لهذا الحزب ولأتباع الحزب الديمقراطي الكردستاني (مسعود البارزاني) والاتحاد الوطني الكردستاني (جلال الطالباني) بنسب أقل، تنسيق واسع مع النظام الأسدي في قمع المحتجين واعتقال والتخلص من الناشطين في الثورة في المناطق التي تسلموها منه، سواء كانوا عربا أم أكرادا. فقد تمايز أتباع هذه الأحزاب بشكل واضح عن عامة الشعب خصوصا في تعاونهم مع أجهزة النظام ضد الثورة.
حاولت المعارضة السورية استقطاب القوى الكردية، ولكن هذه القوى رفعت من سقف مطالبها حيال المعارضة ما لم تفعله حيال النظام، فقد وضعت شروطا تعجيزية وطالبت بمزايا تعجز هذه المعارضة عن الإقرار بها كالمطالبة بإقليم كردي على غرار كوردستان العراق يتمتع باستقلال ذاتي.
لا أحد ينكر على الشعب الكردي، أينما كان، وبغض النظر عن النسب العددية، حقوقه الثقافية واللغوية والتعليمية. ولكن، ماذا يريدون لعشرات الآلاف من الأكراد المندمجين في نسيج المجتمع السوري في مختلف المدن أن يفعلوا؟ أن يتحوّلوا إلى جاليات؟ أم أن يقتلعوا أنفسهم من بيوتهم وبيئاتهم ليوظفوا في مشروع صالح مسلم الذي يحاول تقليد مسعود البارزاني في سوريا؟
وحين سيطر تنظيم داعش على الرقة، وبدأت محاولاتها للتوسع شرقا وشمالا باتجاه مناطق سيطرة الأحزاب الكردية، شكّلت تلك الأحزاب، وبالأخص حزب الاتحاد الديمقراطي ما أسمته قوات حماية الشعب الكوردي لمواجهة تمدد داعش. هذه الغالبية التي تشكلت من الأكراد الذين قدموا إلى سوريا في العقود القليلة الماضية والذين أطلقوا على هذه المدينة تسمية كوباني كونها كانت مقرا لشركة أوروبية تعمل في المنطقة. فتسمية كوباني ليست كردية وإنما محاولة لتغيير اسم المدينة الحقيقي والتاريخي عين العرب، من منطلق شوفيني ليس إلا.
وبعد تشكل التحالف الدولي لمحاربة داعش، سارعت القوى الكردية إلى المطالبة بتخليص عين العرب (كوباني) من أيدي داعش. ولما كان هذا التحالف يعتمد فقط على القوة الجوية، فقد طالب هؤلاء باستقدام قوة من البيشمركة (الشرطة الكوردستانية في كوردستان العراق) لمساعدتهم في قتال داعش. كان لا بد من مفاوضات عسيرة مع تركيا للسماح لقوة من البيشمركة أن تعبر الأراضي التركية للوصول إلى عين العرب. وقد تم ذلك بضغوط أميركية، مقابل أن تشارك مجموعات من الجيش السوري الحر في هذه المعركة لإرضاء الحكومة التركية. وبمساعدة سخية من طيران التحالف وبالأخص الطيران الأميركي، تمكنت تلك القوات من استعادة مدينة عين العرب.
وفي حين جاء التدخل الأميركي صارخا لمصلحة القوى الكردية، كانت قوات المعارضة السورية وخصوصا المدنيون السوريون في حلب ودرعا وسواهما، واللاجئون الفلسطينيون في مخيم اليرموك، يتعرضون لهجومين متزامنين من داعش وطيران النظام دون أيّ مساعدة من أحد.
هلل “اليسار الممانع″ (والأحزاب الشيوعية العالمية المتهالكة) لبطولات المقاتلين الأكراد، وخصوصا المقاتلات، في صفوف قوات حماية الشعب الكوردي، ولم يلحظوا دورا للجيش السوري الحر، كما لم يتنبهوا لدور الطيران الحربي الأميركي في هذه المعركة، والذي لولاه لما تقدمت هذه القوات خطوة واحدة في مدينة عين العرب، ولاحقا في تل أبيض.
هذا اليسار الممانع نفسه، وهذه الأحزاب الشيوعية نفسها التي عابت ولا تزال تعيب على الثورة السورية أنها ثورة برعاية أميركية خليجية، ما أسهم بشكل بالغ في حصارها إعلاميا وشعبيا على الصعيدين العربي والعالمي، مكّن القوى الظلامية والإرهابية أن تتغول على تلك الثورة وبالتالي أسهم في ضمور قوتها وخصوصا الجيش الحر.
وهكذا نتحقق أن الثورة السورية لا تواجه شراسة ودموية النظام الأسدي وحلفائه المباشرين فحسب، ولكنها تواجه أيضا حصارا مطبقا من الأميركيين و”شركائهم” وأدواتهم، وكذلك ممن يدّعون مواجهة المشروع الأميركي الصهيوني في المنطقة.
كاتب لبناني