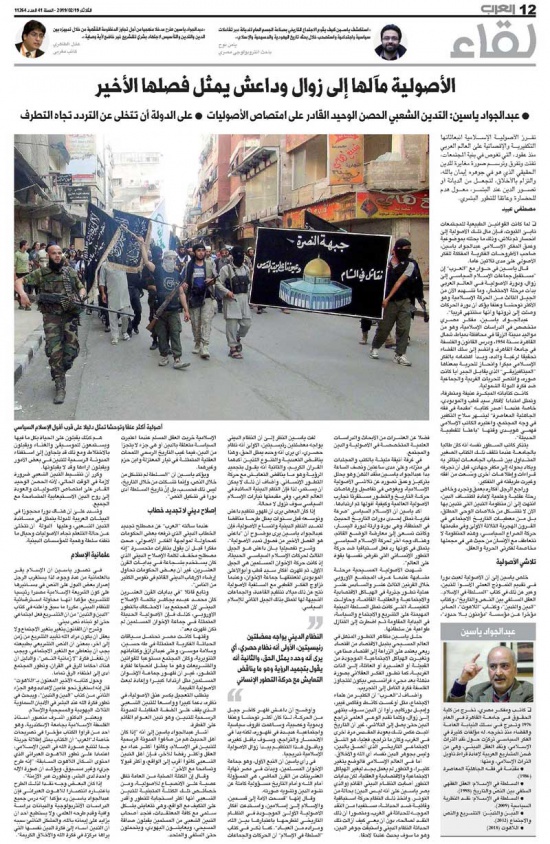الأصولية مآلها إلى زوال وداعش يمثل فصلها الأخير

تفرز الأصولية الإسلامية انبعاثاتها التكفيرية والإقصائية على العالم العربي منذ عقود، التي تغوص في بنية المجتمعات، تفتت وتفرق وترسم صورة مغايرة للدين الحقيقي الذي هو في جوهره إيمان بالله، والتزام بالأخلاق، لتجعل من الديانة أو تصور الدين عند البشر، معول هدم للحضارة وعائقا للتطور البشري.
لما كانت القوانين الطبيعية للمجتمعات تأبى الثبوت، فإن مآل تلك الأصولية إلى انحسار ثم تلاش، وذلك ما يحلله بموضوعية وعمق المفكر الإسلامي عبدالجواد ياسين، صاحب الأطروحات الفكرية المفككة للفكر الأصولي على مدى ثلاثين عاما.
قال ياسين في حوار مع “العرب” إن “مستقبل جماعات الإسلام السياسي إلى زوال، ودورة الأصولية في العالم العربي بدأت مرحلة الاحتضار، وما نشهده الآن من الجيل الثالث من الحركة الإسلامية وهو الأكثر توحشا وعنفا يؤكد أن دورة الحركات وصلت إلى ذروتها وأنها ستنتهي قريبا”.
عبدالجواد ياسين، مفكر مصري متخصص في الدراسات الإسلامية، وهو من مواليد مدينة الزرقا في محافظة دمياط، شمال القاهرة سنة 1954، ودرس القانون والفلسفة في جامعة القاهرة، وانضم إلى سلك القضاء تحقيقا لرغبة والده، وبدأ اهتمامه بالفكر الإسلامي مبكرا وانحاز للحرية بمعناها “الميتافيزيقي” الذي يقابل الجبر أيا كانت صوره، وانتصر للحريات الفردية والجماعية ضد فكرة الدولة الشمولية.
كانت كتاباته المبكرة عنيفة ومتطرفة، وتمثل امتدادا لأفكار سيد قطب والمودودي، خاصة عندما أصدر كتابه “مقدمة في فقه الجاهلية المعاصرة” ليشهر سلاح التكفير في وجه المجتمع، واعتبره الكاتب الإسلامي فهمي هويدي وقتها “باعثا للقطبية الحديثة”.
يتذكر كاتب السطور نفسه أنه كان طالبا بالجامعة عندما تلقف ذلك الكتاب الصغير المتداول بين شباب الجامعات ليتأثر به ويكاد يحوله إلى مكفر جهادي، قبل أن تجرفه قراءات وإطلاعات أخرى وسّعت من أفقه وغيرت طريقته في التفكير.
وراجع الرجل أفكاره بعمق وتجرد وخاض رحلة عقلية وعلمية لإعادة اكتشاف الدين، انتهت إلى أن منظومة التدين التي نتدين بها الآن لا تتشكل من خلاصات الوحي المطلق، بل من معطيات التاريخ الاجتماعي في القرون الهجرية الثلاثة الأولى وفي مقدمتها حركة الصراع السياسي، وهذه المنظومة لا تتعاطف مع الإنسان من حيث هي في مجملها مخاصمة لفكرتي الحرية والعقل.
تلاشي الأصولية

خلص ياسين إلى أن الأصولية لعبت دورا في تقديم النموذج العملي الأسوأ للتدين، وعبر عن ذلك في كتاب “السلطة في الإسلام.. العقل السلفي بين النص والتاريخ”، وكتاب “الدين والتدين”، وكتاب “اللاهوت”، الصادر مؤخرا عن مؤسسة “مؤمنون بلا حدود”، فضلا عن العشرات من الأبحاث والدراسات العلمية المتخصصة في الأصولية والدين والمجتمع.
في غرفة أنيقة مليئة بالكتب والمجلدات في منزله، وعلى مدى ساعتين ونصف الساعة بدا عبدالجواد ياسين متّقد الذهن وهو يحلل بتركيز وعمق تصوره عن تلاشي الأصولية الإسلامية، ويغوص في تفاصيل وإرهاصات حركة التاريخ والتطور مستقرئا تجارب الأصولية العالمية وكيفية أفولها ثم ارتدادها.
أكد ياسين أن الإسلام السياسي “صرعة فكرية تمثل إحدى دورات التاريخ الحديث في المنطقة، وهي دورة وارثة لدورة اليسار، وكانت تسعى إلى معارضة الوضع القائم، وهناك وجه آخر لحركة الإسلام السياسي يتمثل في كونها رد فعل استباقيا ضد حركة التطور الإنساني التي تفرض نفسها بقوة على العالم”.
شهدت الأصولية المسيحية مرحلة مشابهة عندما عرف المجتمع الأوروبي خلال القرنين الثالث عشر والسادس عشر عملية تطور جذرية في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والعقلية القائمة، وحاولت الكنيسة، التي كانت تمثل السلطة الدينية المهيمنة على التشريع والاجتماع والسياسة، في البداية المقاومة ثم اضطرت إلى التنازل طواعية عن سلطانها.
حلل ياسين مظاهر التطور المذهل في العالم المسيحي بتبدل الاقتصاد من اقتصاد ريعي يعتمد على الزراعة إلى اقتصاد صناعي، وتغيرت الهياكل الاجتماعية الموجودة من القبيلة أو العشيرة أو العائلة، إلى الذات الفردية، كما تطور الفكر العقلاني بصورة مذهلة بعد مجيء فرانسيس بيكون لتتجاوز الفلسفة فكرة التأمل إلى التجريب.
النظام الديني يواجه معضلتين رئيسيتين، الأولى أنه نظام حصري، أي يرى أنه وحده يمثل الحق، والثانية أنه يقول بتجميد الرؤية وهو ما يناقض التعايش مع حركة التطور الإنساني
وأضاف لـ”العرب” أن الكثير من علماء الاجتماع، مثل أوغست كانط، وفاكس فيبر، وإميل دوركايم، رأوا أن الدين سوف ينتهي إلى زوال، وكلما تقدم الوعي العلمي تراجع الدين حتى يصل إلى التلاشي، غير أن التاريخ أثبت عكس ذلك بعودة المقدس مرة أخرى في الغرب، وكان ما تراجع، فعليا، هو الشق الاجتماعي التاريخي الذي أُلصق بالدين، وليس بجوهر الدين نفسه، أي الله والأخلاق.
أما في العالم الإسلامي فالوضع يتغير كثيرا، والتطور لم يعمل بجد ليغير الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والعقلية، لكن بدايات التطور أصابت النظام الديني القائم (والذي يصر ياسين على أنه ليس الدين) بحالة من التوتر. واتخذ ذلك النظام حركة استباقية وقائية ضد الحداثة، مستفيدا من النقد الموجه للحداثة في الغرب، ومتصورا أن ذلك النقد لصالحه، دون أن يعي كيف أزالت تلك الحداثة النظام الديني واستبقت جوهر الدين، وهو ما سوف يحدث عندنا لاحقا.
لفت ياسين النظر إلى أن النظام الديني يواجه معضلتين رئيسيتين، الأولى أنه نظام حصري، أي يرى أنه وحده يمثل الحق، وهذا يناقض التعددية والتنوع اللذين أكدهما القرآن الكريم، والثانية أنه يقول بتجميد الرؤية وهو ما يناقض التعايش مع حركة التطور الإنساني. وأضاف أن ذلك لا يمكن أن يستمر، لذا فإن النظم الدينية السائدة في العالم العربي، وفي مقدمتها تيارات الإسلام السياسي سوف تزول لا محالة.
إذا كان البعض يرى أن ظهور تنظيم داعش وتوسعه قبل سنوات يمثل طرحا مناقضا لتمدد النظم الدينية واتساع الأصولية، فإن عبدالجواد ياسين يرى بوضوح أن “داعش هو الفصل الأخير من فصول تمدد الأصولية”.
وشرح تفصيليا بأن داعش هو الجيل الثالث لحركات الإسلام السياسي الحديثة، إذ كانت حركة الإخوان المسلمين هي الجيل الأول، ثم ظهرت أفكار سيد قطب وأبوالأعلى المودودي لتعتنقها جماعة الإخوان، وعندما تزاوج الفكر القطبي مع السلفية الأصولية نتج عن ذلك ميلاد تنظيم القاعدة، والجماعات الشبيهة لها لتمثل بذلك الجيل الثاني للإسلام السياسي.
مستقبل جماعات الإسلام السياسي إلى زوال، ودورة الأصولية في العالم العربي بدأت مرحلة الاحتضار
وأوضح أن داعش ظهر كآخر جيل من الحركة، لذا كان أكثر توحشا وعنفا ودموية وعصبية، وساهمت ظروف سياسية واجتماعية عديدة في ظهوره، لكنه بدأ في الانحسار والتراجع، وسوف يأفل كغيره، وبأفول هذا التنظيم يبدأ زوال الأصولية الإسلامية تدريجيا.
في رأي ياسين أن النبع الأول، وهو جماعة الإخوان المسلمين، وبدأت في مصر نهاية العشرينات من القرن الماضي، هي المسؤولة أمام الله وأمام التاريخ مسؤولية كاملة عن تشوه الدين وتشويه صورته.
وقال إنها “قسمت الأمة إلى قسمين، والإسلام إلى إسلامين، واستدعت أفكار الأصولية الأولى الموجودة في النظام التاريخي لتطرحها باعتبارها دين الله، ومراده من العباد”. كما ذكر في كتاب “السلطة في الإسلام” أن الحركات والجماعات الإسلامية خربت العقل المسلم عندما اعتبرت السياسة متعلقة بالدين أو هي جزء لا يتجزأ من الدين، فيما غيب التاريخ الرسمي اللمحات العقلية المتمثلة في تيار المعتزلة وابن حزم وغيرهما.
ويؤكد ياسين أن “السلطة لم تتشكل من خلال النص، وإنما تشكلت من خلال التاريخ، ليس ذلك فحسب، بل إنّ تاريخ السلطة أدّى دورا في تشكيل النص”.
إصلاح ديني لا تجديد خطاب

عندما سألته “العرب” عن مصطلح تجديد الخطاب الديني الذي ترفعه بعض الحكومات كمحاولة لمواجهة الفكر الأصولي، صمت مفكرا قبل أن يقول بنظرات متحسرة “إنه مصطلح مخفف لكلمة الإصلاح الديني الذي كان يستخدم بشجاعة في بدايات القرن العشرين، غير أن بعض الحكومات تحاول إرضاء الإرهاب الديني القائم في نفوس الكثير من الناس”.
وتابع قائلا “في بدايات القرن العشرين كان محمد عبده يجاهر بكلمة الإصلاح الديني لأن المجتمع بدأ الاحتكاك بالتطور الأوروبي، كذلك فإن الأصولية الحديثة المتمثلة في جماعة الإخوان المسلمين لم تكن ظهرت بعد”.
وقتها كانت مصر تحتمل سياقات الحداثة الفكرية المتمثلة في طه حسين، وسلامة موسى، وعلي عبدالرازق وكتاباتهم التنويرية، وكان المجتمع مستوعبا للقوانين والتشريعات وهو ما يمثل انصياعا لفكرة التطور، غير أن ظهور جماعة الإخوان المسلمين مثل ارتدادا كبيرا وإعادة لبعث الأصولية القديمة.
يتطلب التعجيل بكسر عنق الأصولية، في نظره، دعما كبيرا وواسعا للتدين الشعبي الذي يقف على الضفة المقابلة للمدونة الرسمية للتدين، وهو تدين العوام القائم على الفطرة.
أشار عبدالجواد ياسين إلى أنه “إذا كان أهل الحديث هم من صاغوا المدونة الرسمية للتدين في الإسلام، وكانوا أكثر عداء مع العقل وأكثر رفضا للآخر، فإن أهل التدين الشعبي كانوا أقرب إلى الواقع، وأكثر قبولا وتسامحا مع الآخر”.
وقال إن الكتلة الصلبة من العامة تظل عصية على الانصياع للأصولية، ومن خصائص تلك الكتلة المتبنية للتدين الشعبي أنها أكثر استجابة للتطور وأقدر على التكيف مع الواقع، وهي تتعايش بشكل سلمي مع كافة المعتقدات، فنجد أصحاب التدين الشعبي من المسلمين يقبلون صداقة المسيحي، ويعايشون اليهودي، ويتحملون حتى السلفي والملحد.
هم كذلك يقبلون على الحياة بكل ما فيها ويستمعون للموسيقى والغناء ويقبلون بالاختلاط، ومع ذلك قد يلجأون إلى استفتاء المدونة الرسمية للتدين في بعض الأمور ويقبلون آراءها وقد لا يقبلونها.
وكرر أن تنشيط التدين الشعبي ضرورة لازمة في الوقت الحالي، لأنه الحصن الوحيد القادر على امتصاص الأصوليات والعودة إلى روح الدين الاستيعابية المتسامحة مع الجميع.
وشدد على أن هناك دورا محجوزا في البيئات العربية للدولة يتمثل في مساندة التدين الشعبي، وعليها- الدولة- أن تتخلى عن حالة التلعثم تجاه الأصوليات وحيال ما تظنه سلطة وهمية للمؤسسات الدينية.
علمانية الإسلام

في تصور ياسين أن الإسلام يقر بالعلمانية من عدة وجوه، لذا يستغرب الرجل إصرار بعض الدول على النص في دساتيرها على كون الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع، مؤكدا أنها محاولة استرضائية للنظام الديني، مكررا ما سبق وأعلنه في كتاب “الدين والتدين” من أن التشريع فعل اجتماعي حتى لو تبناه نص ديني.
وشرح أن القانون يتغير بتغير الاجتماع ولا يعقل أن يكون مراد الله تأبيد التشريع من زمن إلى آخر، بمعنى أن النص التشريعي بطبيعته يجب أن يتعاطى مع التغير الاجتماعي، ويجب أن نفعّل فكرة “لا زمانية النص”، والدليل أن هناك أحكاما للرق في القرآن، وتطور المجتمع أدى إلى اختفاء الرق تماما.
وحول كتابه الأخير المعنون بـ”اللاهوت” قال إنه استغرق نحو عامين لإعداده وهو الجزء الثاني من كتاب “الدين والتدين”، ويبحث في تطور فكرة الله عند البشر في الأديان السماوية الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام.
ويعتبر الدكتور أشرف منصور أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الإسكندرية، وهو أحد من قرأوا الكتاب مؤخرا في تصريحات خاصة لـ”العرب” أن الكتاب يمثل إطلالة جريئة جدا لتتبع صورة الله في الدين الإسلامي، اعتمادا على تطور اللاهوت العبراني الذي احتوى أشكال اللاهوت السابقة؛ “إنه طرح جريء وغير مسبوق، ويؤكد أن صورة الإله واحدة لدى البشر، وتطورت عبر الأزمنة”.
إذا كان البعض وجه نقدا لذلك الطرح باعتباره انتصارا للاهوت العبراني فإن عبدالجواد ياسين رد مؤكدا “إنه درس جميع الدراسات الأنثربولوجية والديانات دراسة وافية وقدم طرحه العلمي، ولا يستطيع أحد أن يزايد على إيمانه بالله، والمشكل الناشئ سببه أن التدين أساء إلى فكرة الدين نفسها التي يراها مركزة في فكرة الله والأخلاق الكريمة”.
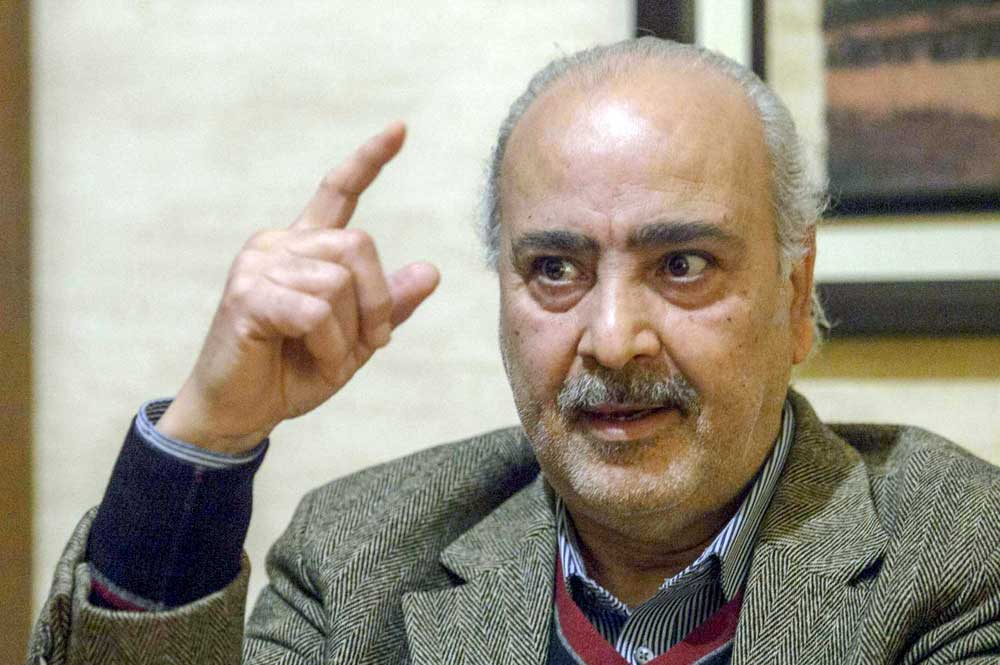
كاتب ومفكر مصري، تخرج من كلية الحقوق في جامعة القاهرة في العام 1976 وتدرج في سلك النيابة العامة والقضاء منذ تخرجه. له مؤلفات كثيرة في الفكر السياسي تركزت حول نقد التراث الإسلامي، ونقد العقل الديني، وهي من ضمن المشاريع العربية لإعادة قراءة تأويل التراث الإسلامي، ومنها:
- مقدّمة في فقه الجاهليّة المعاصرة (1986).
- السلطة في الإسلام: العقل الفقهي السلفي بين النصّ والتاريخ (1998)
- السلطة في الإسلام: نقد النظرية السياسية (2009)
- الدّين والتديّن: التشريع والنص والاجتماع (2012)
- اللاهوت (2018)