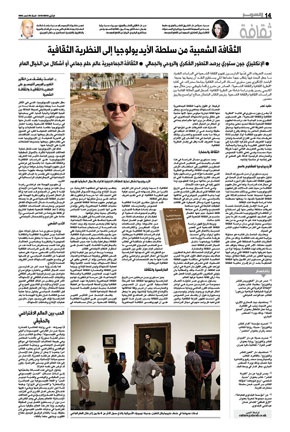بهذا الكلام وجب الإعلام
خلال النصف الأوّل من القرن العشرين، في أجواء كانت توحي بانسحاب الدين من مسرح الحياة، على طريق “غروب الأوثان” وفق نبوءة نيتشه، وكانت “الحضارة المعاصرة” في المقابل توحي بانهيار وشيك، على طريق “انحدار الغرب” وفق نبوءة شبينغلر، وهي النبوءة التي أثارت حماسة الكثير من المسلمين دون فهم لأبعادها، ودون إعداد بديل عنها عدا فتاوى فقهاء الانحطاط وشيوخ الفتن وصولا إلى تفجيرات لا تبتغي غير خراب العمران، وأيضاً في أجواء ارتبطت فيها بعض التجارب “العَلمانية” بسياسات فاشية تبيد الأقليات باسم الدولة الوطنية كما فعل كمال أتاتورك، وهي نفس الأجواء التي ارتبط فيها الإلحاد أحيانا بالعنف باسم العلم كما فعل ستالين. وهي الأجواء التي ارتبطت فيها الحضارة الصناعية بتدمير البيئة واستنزاف خيرات الطبيعة واستعمار الشعوب وإخفاق وعود السعادة الدنيوية.
الهدف الأول، تحقيق نوع من الأمن الروحي، فربما تساهم الصلوات والابتهالات في تحقيق طمأنينة القلب وهدوء النّفس، ما قد ينعكس إيجاباً على مستوى الأمن العام.
الهدف الثاني، التحكم في الغرائز، وهنا قد يساهم الصوم والزواج والاختلاط في شعائر الحج في ضبط الشهوات الغريزية ما قد يساهم في سمو النفس وتهذيب السلوك.
الهدف الثالث، تقوية نسيج التضامن الاجتماعي، ومرة أخرى فإن أعمال الخير والإحسان والصدقة والزكاة ومفاهيم التضحية والغفران، قد تساهم في تقوية قيم الأخوة التضامن، أو هذا هو المأمول.
نظريا تبدو هذه الأهداف معقولة ومقبولة. دون أن ننسى كيف كانت الأديان إبان الحرب الباردة على الشيوعية سلاحا فعالا في يد “الأحرار” لغاية مواجهة ذلك الوحش “المادي” المسمى بالشيوعية. وهذا ما جعل الرهان على الأديان يبدو في بعض الأحيان، كأنه رهان على الحرية أيضاً.
لكن هناك مسألة غير محسومة. حين نراهن على الدّور الإيجابي للأديان، فعلى أي جانب يقع الرهان؟ هل نراهن على فكرة الخلق ومن ثمة أن يكون للطبيعة نظام “عقلاني” يمكن للعقل البشري أن يعرفه علميا ويمتثل له أخلاقيا، كما كان تصوّر فلاسفة التنوير؟ هل نراهن على فكرة البعث ومن ثم خلود النفس كمسلمة من مسلمات العقل العملي كما يقول كانط؟ هل نراهن على القيم الدينية بصرف النظر عن الغيبيات كما يعول أندريه كومت سبونفيل؟ أم نراهن على السعادة الأخروية كما يقول عبدالكريم سروش؟
بصرف النظر عن مجال الرهان، فإنّ مبدأ الرهان على الأديان أصبح اليوم مثار شك. فبدل أن تحقق عودة الأديان نوعا من الأمن الروحي، ارتفع منسوب العنف والإرهاب. وبدل أن تساهم عودة الأديان في تقوية نسيج التضامن الاجتماعي فقد أيقظت الفتن وأشعلت الحروب المذهبية والطائفية التي تكاد تدمر كل شيء. فأين يكمن الخلل؟ حين تكون الغاية معقولة وتستعصي على التحقّق، هذا يعني أن ثمة مشكلة في الوسيلة.
فماذا نلاحظ؟ في سبيل تحقيق الأمن الروحي والسمو النفسي تم استعمال الدين استعمالا خاطئا، في إطار ما يسمّى بالاستعمال الأيديولوجي للدين، بمعنى استعمال الدين في الصراع على السلطة. فهل يمكن لدين تم توريطه في الصراع على السلطة أن يحقق أي قدر من الأمن الرّوحي؟
المعضلة لا تقف عند حدود استعمال الدين وإنما تشمل مضامين الخطاب الديني. فالملاحظ أن مضامين الخطاب الديني مفعمة بتصورات تؤجج الغضب بدل الطمأنينة، تبعث الحقد بدل السكينة، تثير الكراهية بدل المحبة. من بين ذلك، تكريس فكرة تأثيم النفس، بحيث يتصور المسلم نفسه آثما في كل أحواله؛ فالنفس أمارة بالسوء، والعين تزنى، والأذن تزنى، وأغلب الناس في الجحيم، وفي النهاية سيُفتن المؤمن في قبره فتنة قد لا ينجو منها، ولا يُعفى منها إلا من مات شهيدا، وما إلى ذلك من مضامين يستثمرها خطاب العنف التكفيري. وبعد هذا، يكفي أن يكون المرء قد مرّ من بعض الانحرافات حتى يقع بسهولة في فخ التأثيم الديني الذي يفرز الحاجة إلى العنف، ولِم لا الإعفاء من فتنة القبر ولو بحزام ناسف.
من بين ذلك ترسيخ فكرة الخوف على الدين من الضياع، بحيث يتصور المسلم كأن دينه مهدد مستهدف من طرف أعداء يحيطون به من كل جانب. من بين ذلك أيضا، تقديس الموروث الفقهي، وهو تقديس أدخل العقل الإسلامي في غيبوبة. بحيث ليس مطلوبا من المسلم أن يفكر طالما أسلافه “فكروا” له.
لكن بعد المضامين لا يجب أن نغفل المفاهيم. فالغالب على مفاهيم الخطاب الديني أنها تمثل تهديداً للأمن والتنمية والسّلام، من قبيل مفاهيم الطاعة والجماعة والولاء والبراء، وهي مفاهيم تعكس عصر التوسعات الإمبراطورية، ما يجعلها تتنافر مع مقتضيات عصر الدولة الوطنية. وبلاشك نحتاج إلى مفاهيم جديدة. هل لا يزال بالإمكان الرهان على الأديان؟
لا يزال بالإمكان الرهان على الأديان وليس قبل إصلاح الدين في مستوى الخطاب. هذا الكلام يصدق على كافة الأديان طالما معركة الإصلاح الديني سيرورة لم تكتمل، وهو أصدق ما يكون على الإسلام حيث الإصلاح لم يبدأ بعد. وبهذا الكلام وجب الإعلام.
كاتب مغربي