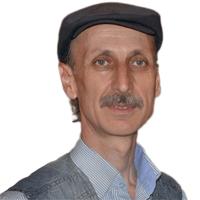"المقولات والإجراء".. كتاب مرجعي لفهم السينما وتحوّلاتها

تجهد طاقات السينما الشابة في البحث عن مراجع سينمائية تنال منها المزيد من المعرفة السينمائية التي تشكّل لها القاعدة المعرفية المؤهلة لفهم السينما أولا وتذوّقها ثانيا. ولبناء ذهنية سينمائية شخصية من خلال ربط خيوط هذه المعرفة السينمائية واتجاهاتها وتشكيل فهم شخصي عنها في مرحلة ثالثة. وفي دمشق صدر كتاب سينمائي جديد حمل عنوان “التكوين السينمائي – المقولات والإجراء” يسعى لأن يكون دليلا للمهتمين بفن السينما ومساعدا لهم في دخول عالم الشاشة الكبيرة.
دمشق - يقول بازان في السينما إنها “خط مقارب للواقع يتحرّك دائما ليقترب منها ويعتمد عليها”. ويتابع عن الفرق بينها وبين المسرح، فيكتب “قوتها جاذبة إلى المركز يعمل كل شيء فيها لجذب المشاهد، كالفراشة التي يجذبها الضوء، وبالعكس فإن قوة السينما طاردة تبعث الاهتمام إلى الخارج إلى دنيا مظلمة لا حدود لها تحاول الكاميرا باستمرار أن تضيئها”.
هذه واحدة من الأفكار السينمائية العميقة التي قدّمها كتاب “التكوين السينمائي – المقولات والإجراء” الصادر حديثا عن دار سوريانا الدولية للدراسات والترجمة والنشر بدمشق، وهو من تأليف المخرجة السينمائية السورية كوثر معراوي التي تتناول فيه موضوعات هامة وعميقة تهمّ المخرج السينمائي خصوصا، وكذلك الناقد في الفن السينمائي لما قدّمه من معلومات تأريخية في نشوء الفن السينمائي في العالم والذهنيات الفكرية التي تشكّلت فيها، كما يلقي الضوء على أساليب عملها ومدارسها العالمية الشهيرة، ولا يغفل عن ذكر بعض رواد السينما العالمية وما تركوه من أثر في ترسيخ الفن السينمائي وتطويره.
موضوعات عميقة

كوثر معراوي: هدف الكتاب إيصال فن السينما إلى الجيل الناشئ بطرق مبسطة
عن الكتاب تقول المؤلفة كوثر معراوي “المقولات والإجراء يعطي في القسم الأول منه نظرة عامة عن تاريخ السينما، فيعرفنا على أساليب السينما ونظرياتها وأشهر روادها الأوائل ومراحل الوعي في تاريخ السينما بطريقة مختصرة، ولمن يرغب بالتعمّق والتبحّر في هذا العالم الساحر فعليه العودة إلى المراجع والمصادر الأساسية والمتعدّدة والكثيرة عن تاريخ السينما، لينهل منها المزيد من المعرفة والعلم عن فن السينما”.
وتواصل “أما القسم الثاني من الكتاب فأعتبره دليلا ومرجعا مصغّرا لإجراءات العمل السينمائي من عناصر تكوين الفيلم السينمائي ورمزية كل لقطة على حدة، فمثلا كيف يمكن لتنوّع عدسات الكاميرا خدمة المشهد السينمائي فنيا لتكوين كل لقطة كلوحة فنية، كما تطرّقت لما يسبّب التشويه والتشويش على جمالية تكوين الصورة السينمائية وكيفية تفاديه وتأثير العرض ودقة الصورة عليها، وانتقاء ما يخدم الصورة وجماليتها والعمل الفني بشكل عام”.
وحفل الكتاب أيضا بلمحة بسيطة ومختصرة عن المونتاج وأهميته، إضافة إلى مراجع يستطيع القارئ الرجوع إليها لمعرفة المزيد عن المونتاج، كما شمل العديد من النصائح لتجنب الوقوع في الأخطاء التي غالبا ما تتكرّر عند تنفيذ المشروع الخاص وأهمية التحضير الجيد للعمل قبل البدء في التصوير.
وتطرقت معراوي في كتابها أيضا للأساليب الفنية والتقنية للمخرج، وهي ترى أن المهتمين بالشأن الفني يستطيعون الاستفادة من هذا الكتاب، وتقول “من خلال خبرتي في هذا المجال وجدت أن كتابا من هذا النوع سيكون مفيدا لعشاق السينما والفن عموما، وهذه هي الغاية والهدف منه”.
وعن منطق الكتاب الذي قدّمته ومدى الفائدة التي يمكن تحقيقها منه لدى جمهور الشباب، تضيف “رغبت أن يكون العمل دليلا لكل من يعمل بفن السينما، لأنه يقدّم معلومات مفتاحية للكثير من المسمّيات والنظريات المتعلقة بفن السينما، التي أتيت بها من مراجع سينمائية موثوقة، الكتاب يمهّد الطريق لكل مهتم بفن السينما في أن يتعرّف إلى رواد السينما وأهم مدارسها ومقولاتها العامة لكي يحدّد مساره وطريقه الذي يستهويه سواء بالمتابعة أو العمل”.
وكتب عمار الياسري الناقد العراقي مقدّما طبعة الكتاب “إن الثورة الصوريّة التي أنتجها اختراع جهاز ‘السينما توغرف’ فتحت الباب على مصراعيه أمام تشكلات الأنواع السينمائية المنسابة مع الضوء، وهذا التفاوت في الشكل يعود إلى محاولات التجريب التي تسعى لها الذات المبدعة التي تسأم السائد دوما. لذا كانت النظريات السينمائية والتجارب البصرية تسير بخطى ثابتة مع تطوّر السينما حتى تنوّعت التيارات وتعدّدت المذاهب، ولو تابعنا كتاب “التكوين السينمائي – المقولات والإجراء” نجده سياحة جمالية وشّجت الصلة ما بين النظرية والتطبيق على امتداد عمر السينما المعاصرة، ففي المحور الأول استعرضت المؤلفة وناقشت طروحات منظري الواقعية والانطباعية، ثم بيّنت التيارات السينمائية الواقعية والانطباعية والأنماط الفيلمية المنبثقة عنها. في حين كان محورها الثاني يشتغل على الجانب التطبيقي لجماليات الصورة السينمائية المتمثلة بجماليات الإطار والتصوير والمونتاج وما إلى ذلك”.
نظريات وتجارب

قدّم الكتاب فصولا في نظريات السينما بدءا بالنظرية الواقعية، فاستعرض النظرية الواقعية للسينمائي المؤسّس لويس لوميير ثم بازان وكراكاور، ثم واقعية الرواد، فمجموعة الكاميرا عين، ثم قدّم النظرية الانطباعية وتحدّث عن الأب الروحي لها جورج ميليه وبعده رودلوف أرنهايم فهوغو منستربيرج مرورا بسيرجي أيزنشتين وصولا إلى بيلا بالاز.
وتحدّث عن الانطباعيين الأوائل مخصّصا الحديث عن أول من أطلق اسم الفن السابع على السينما، وهو الناقد كانودو الذي كان يرى أن السينما دمجت الفنون التشكيلية والفنون الإيقاعية، بمعنى أنها فن الحياة، كما كان يسميها، وهي التي تعبّر عن الروح البشرية والجسد.
وكان يرى أن الصدق الأسمى في فن السينما يكمن في قدرتها على التعبير على النفس الداخلية وليس في تقديم الواقع. ولهذا كان يعتبر أن التعبير النفسي السيكولوجي في فن السينما هو الأهم. والسينما عنده تمتلك قدرة على تفسير وعي الناس في إدراك الحياة وتحليله وتعميقه، وهي تمتلك القدرة أيضا على المساهمة القوية في التغيير الاجتماعي والثقافي والسياسي لو استخدمت وفق منظور ثوري ذهني محدّد.
كذلك قدّم الكتاب نظرية الفيلم الفرنسي المعاصر فتحدّث عن جان متري الذي كتب في علم جمال السينما والسينما التجريبية، وكريستيان ميتز الذي حاول تقديم السينما على أساس علمي ومن ثم تحليل مشاكل الفيلم بناء على هذا المعطى العلمي. وتابع ليصل إلى النظرية الظاهراتية ورائدها موريس ميرلوبونتي الذي اهتم بفكرة الفينومينولوجيا.

الكتاب يمهّد الطريق لكل مهتم بفن السينما للتعرّف على روادها وأهم مدارسها ونظرياتها ومفرداتها ومقولاتها العامة
وفي انعطافة نحو أساليب العمل السينمائي قدّم الكتاب فكر هيجل الذي قال إن الأسلوب “ما تتكشف به شخصية الذات التي تظهر في طريقة التعبير عن نفسها أو نمط الأداء أو التنفيذ الذي يأخذ في اعتباره شروط المواد المستخدمة، وكذلك متطلبات التصميم والتنفيذ مع مراعاة قوانين هذا الفن”.
ثم انتقل الكتاب ليحكي عن الأسلوب في السينما، فبيّن أنهما في طريقين يكون الأول من خلال العمل الفني ذاته والثاني من خلال العمل الفني ومخرج العمل. وتحت بند الأساليب السينمائية وفقا للنظريات استعرض الكتاب مدارس سينمائية عالمية شهيرة منها: الواقعية الإيطالية التي وجدت بعد الحرب العالمية الثانية في إيطاليا لسببين اثنين، وهما حالة التدهور التي كان عليها الإنتاج السينمائي الإيطالي، ومحاولة طرح مشاكل الإنسان الإيطالي في هذه المرحلة، وقدّم الفيلم الذي كان بداية هذه المدرسة وهو “روما.. مدينة مفتوحة” للمخرج روبرتو روسوليني.
وتابع ليصل إلى الموجة الفرنسية الجديدة التي ساهم بها كلود شابرول وفرانسوا تروفو وآلان رينييه وجان لوك غودار وكانت متأثرة بالواقعية الإيطالية وتمرّدت على الفيلم الرائج جيد الصنع، فقللت الاعتماد على التجهيزات الضوئية ولم تلتزم بالأسلوب القديم واعتمدت مبدأ التداعي الحر، بحيث كسرت منطقية الترتيب الزمني للأحداث.
ثم كانت السينما الواقعية في بريطانيا، السينما الحرة، أواخر الخمسينات ومن روادها كارل رايس وتميّزت بأنها بدأت بالفيلم الوثائقي ثم انتقلت إلى الروائي، ثم مرّ الكتاب على الفيلم المباشر فالواقعية الملحمية ثم الواقعية الاشتراكية ثم الواقعية الشعرية فالرمزية وصولا إلى جماعة سينما دوغما الذين ظهروا بمناسبة المئوية الأولى للسينما.
وتطرّق الكتاب أيضا إلى موضوعات عملية في فن السينما، فأوجد حيزا في عناصر اللغة السينمائية، وتحديدا في مفهوم الخط الوهمي وتقنيات التصوير وكذلك في أنواع اللقطات وأحجامها وفي زاويا الكاميرا وعدساتها وأنواع العدسات ثم العروض والدقة فيها وفي دور الإضاءة في تشكيل الصورة. كذلك قدّم معلومات في المونتاج مستعرضا مبادئ فسيفولود بودوفكين الخمسة في المونتاج ثم في أنواع المونتاج وطرقه.
وكوثر معراوي مخرجة سينمائية سورية عملت في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية كما قدّمت عملا مسرحيا. تخصّصت في السينما التي كتبت فيها سيناريو فيلم “إنسان” وأخرجته ريم عبدالعزيز، وقدّمت في سينما الشباب العديد من الأفلام منها “صمت الألوان” و”ضجيج الذاكرة” ثم قدمت فيلما احترافيا بعنوان “أفراح سوداء”، والذي يتحدّث عن الحرب من خلال عيون الأطفال ومفهومهم المدهش لها ولإكراهاتها. كما ساهمت معراوي في رباعية سينمائية حملت عنوان “حنين الذاكرة”، ونالت العديد من الجوائز السينمائية في سوريا والعراق وغيرهما.