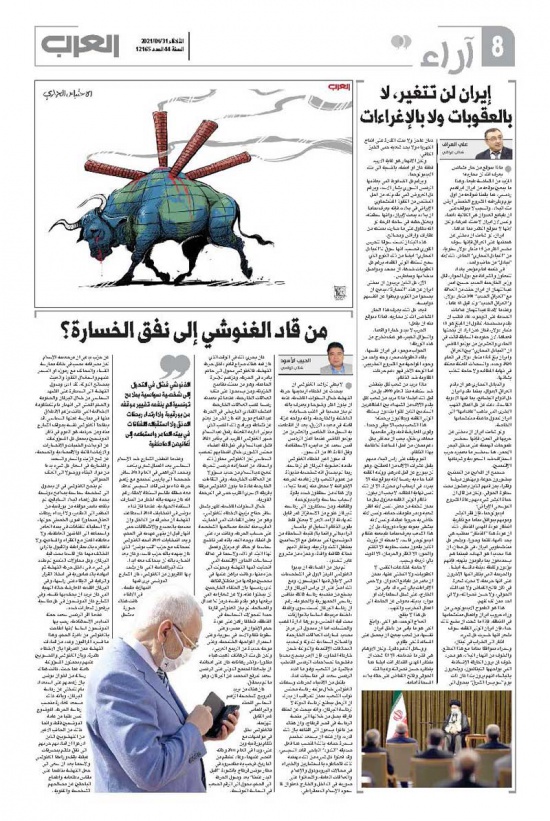محمد صالح البحر: التأمل روح المبدع الذي يطوع له الخيال طينته

انتشار الجوائز المخصصة للرواية شجع الكثيرين على كتابتها من مبتدئين إلى شعراء وصحافيين ونقاد وحتى مولعين بفن الرواية، هذا ما خلق سيلا كبيرا من كتاب الرواية ما يتطلب الوقوف بجدية نقدية صارمة للتمييز من بين ما يكتب. “العرب” كان لها هذا الحوار مع الكاتب والروائي المصري محمد صالح البحر في إطلالة على عالم الرواية وكيف يجب أن يكون.
تتجلى في تجربة الروائي والقاص المصري محمد صالح البحر الروح والجسد والعمق والبساطة والغموض والوضوح والرقة والتوحش في عوالم الحياة في صعيد مصر، هذه العوالم التي تشكلت عبر الحضارة المصرية القديمة التي لا تزال تلقي بظلالها على البيئة والمجتمع والحياة.
من عوالم الصعيد ينحت الكاتب عالما ثريا من واقع حيوات وشخصيات ورؤى وأفكار يصعب كشف أسرارها إلا لمن يعيش داخلها، لذلك حرص صالح البحر على عدم مغادرة الصعيد على الرغم من أن كثيرين قبله وبعده هاجروا إلى العاصمة، لكنه ظل وفيا لمكانه، فأبدع ليحقق مكانة متميزة داخل المشهد الروائي المصري.
وقدم سبعة أعمال سردية، في الرواية “حقيبة الرسول”، “موت وردة”، “1/2 مسافة”، “حتى يجد الأسود من يحبه”، وفي القصة القصيرة “قسوة الألهة”، “أزمنة الآخرين”، “ثلاث خطوات باتجاه السماء”، وله أكثر من عمل قيد النشر.
الرواية والعقل

محمد صالح البحر: كل رواية نكتبها هي وجود صغير يحاول أن يستقل بنفسه
يقول صالح البحر “بدأت الكتابة هاويا، وسأنتهي هاويا أيضا، فالهواية هي الشيء الوحيد الذي يمارسه الإنسان بحب، ويضحي بكل شيء من أجله، ولا يمل من ممارسته على طول حياته كلها، الهواية هي شغف الإنسان الدائم، وطريقه الوحيدة للمتعة الحقيقية، ليست متعة تزجية الوقت أو الحواس فحسب، بل متعة الكشف المستمر للذات وللعالم الذي يحيا فيه، متعة المعرفة التي بلا حدود”.
ويتابع “لا أحد يستطيع أن يحدد على وجه الدقة، متى بدأتْ مسيرته مع الكتابة؟ إنها مثل زخات المطر التي تأتي هادئة، ثم تبدأ في ممارسة الصخب الذي لا يفتر من بعد، هكذا تبدو حكايات الأمهات والجدات ـ عن حمار الليل، وأُمِّنا الغولة، وأبورجل مسلوخة، وغيرها من حكايات الصعيد الممتدة في الزمن ـ كأول الغيث الذي لم أشعر به، رغم أنه هو الذي أثار المخيلة، ونبهها إلى أهمية الحكاية في الحياة، ثم جاءت القراءة لتضع قدميّ على حافة البئر الممتلئة بسحر الحكايات وكنوزها التي لا تنضب، كان كل لغز وكل كتاب مثل شيطان لا يكف عن الوسوسة، نداهة لا تكف عن الغواية، وكل ذلك علمني كيف أرصد ما يدور من حولي بعين ثاقبة”.
ويواصل قوله “بدا المكان في الصعيد متخما بالكنوز التي تنتظر الكشف، وعندما بدأتُ الإمساك بالقلم بدأ السقوط في البئر، أذكر أن أول قصة حقيقية كتبتها كانت من خلال هذا الرصد، عن بنت الجيران التي فاتها قطار الزواج، وشكلت الدورة الشهرية كابوسا نفسيا لها، كان يصل إلى حد الصراخ والإغماء، وجلب المشايخ للتلاوة وتهدئة الروح، وها أنا ذا لا أزال أغوص في أعماق البئر التي لا تنتهي، بحثا عن عمقها الذي لا يبين، ويبدو أنه غير موجود من الأساس، لا أعرف ما الذي يربطني بالمكان هنا على وجه التحديد، لكنني أؤمن بقدرةالحكايات الهائلة على خطف الروح، وتلبسها كجِنّي عاشق، تتحدث باسمه وتنطلق نحو غاياته”.
ويلفت صالح البحر إلى أن لديه سبعة أعمال سردية مطبوعة، وعملين بانتظار الطباعة، ورواية لا يزال يعمل عليها، “عشرة أعمال خلال ثلاثين عاما من فعل الكتابة الاحترافية، والمقترنة بالاحتكاك المباشر بالفعل الثقافي في مصر والعالم العربي، يبدو الأمر للبعض وكأنني مقل جدا في عملية الكتابة، وأنا لا أكف عن الدهشة من اعتقادهم هذا، فأنا أكتب كل يوم تقريبا، وأفكر في الكتابة كل لحظة، لكنني أؤمن أن الرضا هو المستحيل الذي أتطلع إليه، إنهم لا يعلمون أن كل كتاب صدر لي حتى الآن، هو لحظة يأس من معانقة المستحيل الذي أرجوه، لحظة ضعف إنساني يخشى معانقة ملاك الموت له، قبل أن يشعر أحد ما بمروره على جسد الحياة”.

ويضيف “لا أعرف إن كنت ستصدقني أم لا، لكن الرواية ليست عملا مغلقا على شخصياته وأحداثه، بل عملا مفتوحا على وجود أكبر وسابق لوجودها، لكل رواية زمنها المفتوح، ليس زمن أحداثها ولا كتابتها ولا قراءتها، بل زمن وجودها، الزمن الذي استمدتْ منه كل شيء فيها، ويشكل الخلفية الوجودية السابقة لها، والتي مهدتْ لوجودها، هذا الزمن الذي لا يشعر به أحد، لا القارئ ولا الكاتب حتى، ومع ذلك لا يمكن تخيل شخصيات أو أحداث الرواية دونه”.
ويوضح الكاتب أننا لا ننتبه أن كل شخصية في كل رواية قد وُلِدت قبل أن تُكتب، بمعنى أن لها امتدادها السابق عن الرواية، امتداد وجودها في الحياة، والذي لم يهتم به الكاتب لأنه أراد أن يمسك بها في لحظة يريدها هو، لتشكل سياقا ينشده هو، ولأن هذه الشخصيات هي المادة الأولى للحياة، المادة الخام القابلة دوما للتشكل، والدخول في أحداث وحيوات جديدة، فإنها تستجيب له، وتخضع لمصيره، لكن ثمة حياة أبدية ـ جبارة ولا تنتهي ـ تكمن في مكان ما، وكل ما نفعله كروائيين أننا ننهل من معينها الدائم.
ويتساءل صالح البحر “هل سأل أحدنا من قبل، كيف وصل السيد أحمد عبدالجواد إلى هذه الحياة المتناقضة بين اللهو والشِدَّة، والتي ألبسه إياها، أو مسكه عليها، نجيب محفوظ”؟ ويقول “لهذا أحاول دائما أن أمسك بشخصياتي في حياتهم الأبدية هذه، ليتناسبوا مع المصير الذي أريده لهم، ولا أكتفي بأن أجلبهم منها فقط، وهو ما حدث لآدم مثلا في رواية ‘موت وردة’، فقد جاء من الأبد، من نقطة البداية التي شكلتْ جذور الصراع على الأرض، وقريبا من الفكرة الأم التي شكلتْ رواية الحياة كلها في الأعلى، قبل أن تهبط إلى الأرض”.
ويواصل إثارة التساءل “ربما لم يطرح أحد على نفسه هذا السؤال من قبل، أيهما أسبق عن الآخر، الحياة أم الرواية؟ لكنه السؤال الذي لا يكف عن صب الطنين في داخلي المتوجس بطبيعته، التأمل روح المبدع الذي يطوع له الخيال، طينته اللدنة التي تتوق للتشكل بين يديه، وتنتظر بلهفة العاشق نفخته التي تهبها الحياة، الحياة لم تبدأ على الأرض، الحياة بدأتْ هناك في الأعلى، بدأت بفكرة، أعقبها حوار، ثم شخصيات، ثم أحداث تتصارع فيها تلك الشخصيات، بدأت في السماء، ثم شكلت الأرض جزأها الثاني الذي لم ينته بعد”.

التشويق مهم لقراءة الرواية، لكنه الآن صار تشويقا للعقل لا تشويقا للحواس وإثارة للفكر لا إثارة للمشاعر
ويتابع “ألسنا هنا أمام سياق روائي بامتياز، إذا آمنا بأن الرواية قصة سردية طويلة، لا يحدها المكان ولا الزمن ولا الأحداث ولا الشخصيات، وتقوم على تقديم رؤية متكاملة للذات وللمجتمع وللعالم الذي توجد فيه، ألسنا هنا أمام سياق يخبرنا بأن الوجود الروائي سابق لوجود الحياة على الأرض، أو لعلنا مجرد شخصيات في خضم الأمواج الهائلة للرواية الكبرى التي تشمل كل شيء، نحن وما نحيا فيه وما نكتبه، غير أن السؤال الذي سيطل برأسه، ما الذي تشكله أهمية هذا السبق الروائي؟ ولعل الإجابة تكمن في أن كل رواية نكتبها هي وجود صغير يحاول أن يستقل بنفسه عن الوجود الأكبر، كلما نبتت فيه فكرة جديدة، هكذا تصيرالرواية سياقا معرفيا لا يشبع، مولودا آخر لا يمل بدء الحياة من جديد كلما أوشكت حياة آبائه على النهاية، ولم تكتمل معرفتهم بعد، الرواية إذن تواصل معرفي في سياق لن ينتهي إلا بانتهاء الحياة على الأرض، والتي هي مجرد تفاصيل لأحداث الرواية الكبرى التي بدأت قبلها بكثير”.
ويؤكد “لذلك يجب أن تكون الرواية ملفتة للعقل، لا النظر، فالتشويق مهم لقراءة الرواية، لكنه الآن صار تشويقا للعقل، لا تشويقا للحواس، وإثارة للفكر لا إثارة للمشاعر الغريزية، لذلك يجب أن تقوم الرواية على حالة معرفية تضيف إلى العقل، وتثيره باتجاه التفكير في شيء لم يكن يفكر فيه من قبل، ولذلك أيضا يجب أن يكون الروائي بديلا حقيقيا عن الفيلسوف، في عالم صار الآن بلا فلسفة حاكمة”.
ويشير صالح البحر إلى أن “الرواية في أصل عمقها حالة مناجاة تدور بين الروائي وذاته، تحت قسوة ظروف محددة وخاصة، ومن خلال صراع المناجاة تحدث حالة الكشف التي يرى الروائي من خلالها مصيره في هذا الوجود الضاغط، في ظل هذا التعريف الخاص يمكن تحديد علاقة الرواية بكل الأشياء، السياسة والمجتمع والذات والوجود والعالم، ويمكن للرواية أن تصير ذاتية أو اجتماعية أو سياسية أو تاريخية، أو غير ذلك”.
الرواية في رأيه، حالة كشف، تضيف بطريقة فنية معرفة جديدة للإنسان في الموضوع الذي تتناوله، من خلال التأمل والرصد وتشابك العلاقات والخلفية المعرفية المختزنة في وعي الروائي، لذلك فإن الرواية كما تكشف وتعري الذات، تكشف وتعري أيضا التوترات السياسية والاجتماعية والإنسانية في المجتمعات. هكذا يمكن اعتبار الرواية تلك النافذة التي نطل من خلالها لنرى كل شيء، أنفسنا، عيوبنا، تناقضاتنا، مجتمعاتنا، بيئتنا، صراعاتنا المحتدمة، وكل ما يخص وجودنا في الحياة، ونقدر بتفتيته وتحليله على الوصول إلى وجود أفضل في مستقبل قريب.
استسهال الكتابة

عن زحف الشعراء والنقاد باتجاه الرواية، يقول صالح البحر “إنه زحف التهافت لا القيمة، لهاث الذي يجري خلف غنيمة مرتقبة، يراها سهلة المنال، وليس عنت الذي يجري خلف ذاته ليدركها كي يعرف نفسه، ويحدد وجوده في الحياة، لو يعرف الناس حجم المعاناة التي يكابدها الروائي أثناء عملية الكتابة، لانصرفوا حتى عن قراءتها، كي لا يصيبهم وهج نيرانها”.
ويضيف “في ما سبق كان البعض يُقبل على كتابة الرواية من قبيل الوجاهة، وكان معظمهم أغنياء، أو كتابا كبارا في الصحافة والفكر والسياسة، مثل مصطفى محمود، أنيس منصور، رفعت السعيد، العقاد، مصطفى أمين، ورغم ذلك لم يكن المجتمع، ولا النقد الأدبي، يأخذهم على محمل الجد، أما الآن فقد خلقت وسائل التواصل الاجتماعي سيلا منهمرا من الكتابات، ظنَّ الكثيرون من خلالها أنهم يمتلكون القدرة على الكتابة، ثم جاءت الجوائز الكبرى للرواية لتزيد الطين بَلَّة”.
يشير الكاتب إلى أن السيل أصبح طوفانا لا قبل لأحد به، والنتيجة النهائية أن الرواية العربية ماعتْ إلى درجة كبيرة، وتفرق دمها بين الاستسهال المخل لأناس لا يمتلكون الحد الأدنى من الفنية، أو البحث الذي يغلب فيه العقل الراصد، وجمع المعلومات، على الفن بقدرته الهائلة على الولوج إلى أعماق النفس الإنسانية، للتأثير فيها.
ويعتقد صالح البحر أن “ما أنجزه جيل التسعينات من إضافة، شكلتْ رؤية إبداعية مغايرة عن الأجيال السابقة، هو ما تدور في فلكه الرواية المصرية حتى الآن، إضافة إلى الخبرات الكبيرة التي تم اكتسابها من الرواية العالمية، بعدما اتسع نطاق ترجمتها منذ أوائل الألفية الثالثة، وكان من الممكن عبر كل تلك المكتسبات أن تصل الرواية المصرية إلى آفاق عالية وبعيدة المنال، لولا الاستسهال، وسيطرة آليات السوق بكل مفرداتها”.
ويوضح “أما في ما يخص الوجود في دائرة الحراك الإبداعي للرواية، والتي تتسع بشكل كبير بفعل الجوائز، ووسائل التواصل الاجتماعي التي أتاحتْ قدرا هائلا من إمكانيات التعبير عن النفس، وتُراكم كل لحظة جبالا من الكلمات المكتوبة، فإنني أرى أن على كل مبدع أن يعي جيدا، أن الوجود في دائرة القوة دافع مهم للاستمرار وتطوير الذات، وأن الوجود الآمن ـ في رحاب القطيع المتشابه ـ وَهَنٌ يشبه الموت، ويؤدي إليه، وأخيرا عليه أن يؤمن أن أحدا مهما كان أو بلغ، لا يستطيع أن ينفي أحدا آخر مهما بذل من جهد، أو امتلك من أدوات، فكل وجود هو حقيقة مستقلة بذاتها، لا يقتلها الانكار، ولا يحجبها الظل”.