الكتابة عن الحرب مغرية لكنها لا تضمن الجودة

دمشق – قدرة الرواية في سوريا على مواكبة الحرب بمجرياتها وما خلفته من تداعيات ورصدها لآثار هذه الحرب في نفوس السوريين محاور تداعت لمناقشتها مجموعة من الأدباء والنقاد ضمن اللقاء الشهري “شام والقلم” الذي استضافه المركز الثقافي العربي في أبورمانة بدمشق.
وفي مداخلة أولى أوضح الروائي والناقد نذير جعفر أن الرواية دخلت هذه الحرب من أوسع أبوابها، وهناك روايات كتبت بالدم في حين أن هناك روايات أخرى زورت الحقائق، مشيراً إلى أن نجاح المبدع يكون بقدر استجابته ومدى تفاعله وإحساسه واستشعاره وتنبئه بمسارات ومآلات هذه الحرب وتأثيراتها وقدرته على رؤية وقول ما لم يقله أو ما لم يره الآخرون بأساليب وتقنيات جديدة ومخيلة تكسر الرتابة والمألوف ولا تقف على السطح.
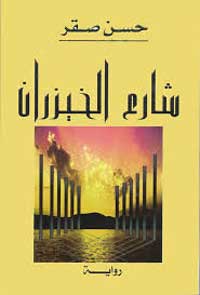
وبين جعفر أن هناك ما يزيد على 200 رواية وبضع روايات عربية عن الحرب في سوريا، وهي خمسة أنواع في رأيه. الأول استعاد تاريخ الثمانينات عبر سردية تربط بين الأمس واليوم، بينما الثاني ينجرف إلى مستوى التقارير المحكوم بالعداء وتصفية الحسابات، واكتفى الثالث بدور الشاهد الذي يدون يومياته على غرار ما كتبه البديري الحلاق عن جرائم جنود الاحتلال العثماني والسائرين في ركابه، أما الرابع فاتخذ منحى فلسفياً لفهم ما يحدث عبر الحفر عميقاً في دواخل النفس البشرية كرواية حسن صقر “شارع الخيزران”، والنوع الخامس هو الروايات التي عايشت الفقد والمعاناة وانتصرت لحقيقة ما يحدث كرواية “مفقود” لحيدر حيدر و”طابقان في عدرا العمالية” لصفوان إبراهيم.
وتساءلت الروائية إيمان شرباتي في مداخلتها عن مدى نضج التجربة الروائية في الوقت الذي لا يزال فيه الحدث طازجاً والحرب مستمرة، خاصة أن هناك روايات خالدة كـ”الحرب والسلم” لتولستوي والتي كتبت زمن شيوع السلم، وهو ما أتاح لها فرصة التأمل والابتعاد عن الطابع التقريري والجنوح إلى الخيال والإبداع والابتكار ما يمنحها صفة الديمومة.
أما عن روايتها “بنت العراب” التي كتبت سنة 2015 فأوضحت شرباتي أن هذه الرواية قصة حب كانت الحرب خلفية لأحداثها، وأفسحت المجال لتطور الشخصيات وتشابكها في ظل ما يحدث دون أن تتناول ضجيج المعركة، حيث سعت لتجنب الصيغة التقريرية التي سقطت فيها الكثير من الأعمال.
وبيّن الروائي محمد الحفري أن الرواية الوثائقية حاضرة في الأدب وهذا لا يضر بالفن بل يزيده تنوعاً وجمالاً، مشيراً إلى أن البعض من كتاب الجيل الجديد اشتغلوا على التقنية ونسوا الحكاية وهذا لا يجوز فالشرطان متلازمان، لكن الحكاية تتفوق قليلاً لأننا نحن أبناء هذا الوجع.
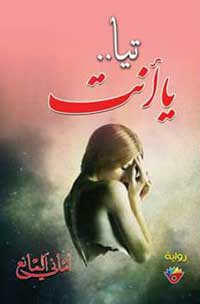
الحفري الذي أنجز روايتين عن الحرب هما “جنوب القلب” و”ذرعان” -إضافة إلى عدد من القصص كانت الحرب محورها- أشار إلى عدد من الروايات التي كان محورها تداعيات أحداث هذه السنوات العشر، منها “زناة” و”آثام” لسهيل ديب و”غزلان الندى” لعلي المزعل و”شمو” لمحمد الطاهر و”ألسنة اللهب” لمنال رشيد أبوحلفة و”تيا يا أنت” لآمال المانع، لافتاً إلى أن ما كتب على صعيد كل الأجناس الأدبية مازال قليلاً قياساً إلى حجم الحدث السوري والفاجعة المروعة، ورفض المقولة التي تقول إن الرواية لا تكتب أثناء الحرب.
أدارت الندوة فاتن دعبول التي لفتت إلى دور المرأة السورية في كتابة رواية الحرب، مشيرة إلى تباين هذه الرواية بين من وثق لها بمصداقية وبين من سيسها وجعلها ردود أفعال.
ومما نخلص إليه من آراء المتدخلين في الندوة أن الحرب تظل مُغرية للكتابة لا شكّ في ذلك، لكنها ليست ضامنة لنوعية السرد ولا لمعمارية الرواية؛ فضجيج المعارك بين الكلمات وانفجار الألغام بين الجُمَل أو سقوط قذائف الهاون على اللغة وتسلّل أصوات الصواريخ بين المقاطع وآلام البشر التي لا تحتمل ومظاهر الدمار والخراب، كلها رغم شدة تأثيرها النفسي ووجعها المتسع لا تكفل تعدد الأصوات في الرواية وليست دليلا على الجودة، مثلها مثل الوثائق والأخبار والحكايات المستقاة من أفواه أبطالها ورواتها، غير القادرة هي الأخرى على أن تكون بُرهانا قاطعا على حيوية السَّرد وجماليات حبكته وبنائه وسلاسة تحريك الشخصيات.
ورغم احتدام الجدل حول إشكالية الكتابة عن الأحداث بينما لم تنته ولا تزال في طور الاستمرارية والتبدلات اليومية إلا أن المُبدع السوري الذي جاءته الحرب لتزلزل أفكاره وتعصف بكيانه وتهدد حياته وحياة أسرته لم يجد بُدًا من التفاعل معها عبر الكتابة عنها، فجاءت بعض الأعمال على درجة من النضج فيما كانت أعمال أخرى أقرب إلى المباشرة والسطحية.
وتناول الحرب روائيا يختلف بين نص وآخر، لكن التعاطي مع النص الروائي على أنّه وثيقة يُحتّم علينا إشهارها في وجه التاريخ يبقى إحدى أكبر هنات الرواية السورية في الفترة الأخيرة.


























