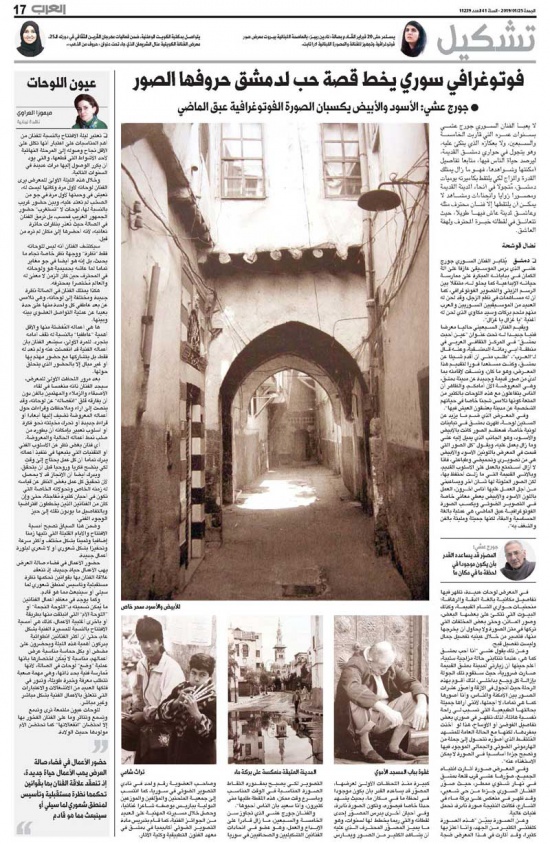المسرح المصري يتصدى للتشدد والعزلة ومخاطر مواقع التواصل

هناك من الفنون التجارية أيضا ما يدعم هذه النزعات التغريبية والانفصالية عن الواقع، لكن المسرح المصري الجديد يأبى أن يكون من بينها، إذ تسعى عروضه الواعية إلى معالجة قضايا الفرد والمجتمع في آن، وتجسد مسرحية “جاري التحميل” المعروضة حاليا على مسرح “أوبرا ملك” بالقاهرة هذا التوجه الهادف إلى مواجهة الخلل بصدر عار من أجل إصلاحه وتجاوزه.
القاهرة - يمضي المسرح المصري في مسلكه الوعر طارحا قضايا العصر ومستجداته في قوالب جمالية مبتكرة. وفي مسرحية “جاري التحميل”، التي تعرض حاليا في القاهرة، يناقش مسرح الشباب مأساة الانخراط في العالم الافتراضي بسبب قسوة الواقع وسوداويته، الأمر الذي يقود إلى انغماس الشباب في الغيبوبة والعزلة واليأس، وقد يتحولون إلى مدمنين أو متطرفين.
بمجرد رفع الستار للإعلان عن بدء العرض، للمؤلف سامح عثمان والمخرج سامح الحضري، يجد مشاهدو المسرحية أنفسهم في معترك الحدث، فلا يدرون هل هم يجلسون على مقاعد المتفرجين في المسرح، أم أنهم انضموا إلى فريق التمثيل ليشاركوهم جلستهم الانطوائية في مقهى الإنترنت “السايبر”.
سيرك الشائعات
الشرك الذي نصبه صُنّاع العرض جاء بسيطا وتلقائيّا وطبيعيّا، فالنادل الذي يعمل بالسايبر يخاطب شباب الممثلين وجمهور المتفرجين معا بقوله “أهلا بكم في السايبر”، ويطلب من الجمهور التواصل مع شبكة “الواي فاي” الخاصة بالمكان بإدخال الكود السري المثبت في تذاكر الدخول، وقبل أن ينظر أحد إلى تذكرته، يستدرك النادل “مش أي حاجة نقولها هنا تصدقوها”، بمعنى أن هذا المكان هو مكان الخيالات
والشائعات، وليس كل ما يحدث ويقال فيه قابلا للتصديق.
هكذا، أعلن العرض عن تشاركيته وتفاعليته الوهمية منذ البداية، فالجميع من ممثلين وجمهور مدعوون لقراءة العالم من داخل صالة “سايبر” بعيون زجاجية ومنظور افتراضي، والأحداث كلها “يجري تحميلها”، الواحد تلو الآخر، وقد تكتمل قصة، ويتوقف تحميل أخرى، ولا يشترط وجود رابط أساسي أو ثيمة جامعة للعمل، شأنه شأن الحياة المفككة، فالمسرحية مجموعة نثارات ومواقف ومشاهد قصيرة، تبرز الاهتمامات الفردية للشخوص، والهموم الذاتية لكل واحد من هؤلاء المتجاورين أجسادا، والمنعزلين أرواحا عن بعضهم البعض.
على الرغم من مساحة التخييل الواسعة التي يسمح بها العرض، من خلال أحداثه التي لا تنكفئ فقط على الواقع الحالي بمشكلاته وتعقيداته وهمومه، بل تنسحب إلى عقد مقارنة بين الحاضر والماضي على مستوى اهتمامات الشباب ومفاهيم الثورة الاجتماعية والسياسية وآليات الإصلاح وأبجدياته، فإن هناك اتفاقا ضمنيّا جرى بين صُنّاع العمل على توجيه دفته في المقام الأول نحو معالجة قضايا الشباب الراهنة، وعلى رأسها قضية التغييب والاغتراب بسبب السوشيال ميديا وسطوة الواقع الافتراضي، فجاءت هذه القضية هي المحورية، وبقية القضايا فرعية هامشية.
العرض نجح في استعراض خارطة الشر على أرض الواقع، من خلال تصوير حكايات الشباب، وخيوط المعاناة التي يعيشونها
هذا الاتفاق على إعلاء شأن هذه القضية في العمل دون سواها بلغ حد الهوس لدى المخرج سامح الحضري والمؤلف سامح عثمان، وكأنهما يخشيان مثلا تشتيت المشاهدين في أمور جانبية، مع أن المتفرجين أكثر وعيا من تصوراتهما بطبيعة الحال، وكان ممكنا أن تحظى المناقشات والإشكالات والتساؤلات الأخرى من قبيل: ما الفرق بين ثورتي 1919 و25 يناير 2011؟ بتحليل أوسع نطاقا، دون الإخلال بالخط الرئيسي للمسرحية.
لقد بلغ إصرار المخرج والمؤلف على إشباع الجمهور بفكرة العمل أنهما شرحا هذه الفكرة باقتضاب في البطاقة التعريفية الخاصة بالعمل وأبطاله، فقال الحضري “ما بين ممثل يحلم، وعاطل يتمنى، وفتاة تنتظر، وتاجر دين يتأهب، ولاعب بلا كرة، ونادل لا يسقي أحدا، وأم تدعو، وعجوز يحمل تركة ثقيلة، جارٍ التحميل”، في حين قال عثمان “وما الدنيا إلا واي فاي كبير، وكلنا داخلين نعمل داونلود، حد يرستر الراوتر”.
في دائرة الضوء المحدودة، المكثفة، داخل هذا السايبر، انطلقت تجليات المسرحية لتشرّح نسيج المجتمع المصري، الذي يعاني شبابه التفكك الأسري، وسوء أحوال المعيشة، وغياب الحريات، والأزمة الاقتصادية، وانتشار البطالة، وهجرة أعداد كبيرة من السكان بحثا عن فرص عمل وحياة أفضل.
وفي ظل هذه الحقائق القاسية، يهرب الكثيرون إلى السوشيال ميديا والعوالم الافتراضية، ومن خلال شاشة الموبايل ينسى كل فرد همومه، ويفتش عن كل ما يفتقده من علاقات ومشاعر حقيقية دافئة، كالحب والصداقة والإخاء والثقة المتبادلة. وعبر أحاديث كل شخصية، تتكشف ملامح أزمتها ومسبباتها. وكذلك من خلال ما يسرده النادل (الراوي العليم)، والحوارات التي يشترك فيها الشباب والنادل والعجوز الحكيم، لكن تبقى السمة المسيطرة على العمل هي عدم وجود حبكة متصاعدة متنامية، فالمقصود إبراز أن حالة فرد هي مسرحية مأساوية مكتملة الفصول بحد ذاتها.
لقد تشوهت الشخصيات تماما بفعل كوارث الواقع، وضاعت الأفكار والآمال في زحام التفاصيل، وارتضت القلوب بالتجمد والنفوس بالانعزال والعقول بالانطفاء، وجاء الواقع الافتراضي ليمثل غيبوبة اختيارية للجميع، شأنه شأن غيبوبة أخرى يبرزها العرض أيضا هي إدمان المخدرات، لدى بعض الشباب، وغيبوبة ثالثة هي “الشعوذة” واللجوء إلى حفلات الزار وإشعال البخور لطرد “العفاريت”.
خارطة الشر
نجح العرض في استعراض خارطة الشر على أرض الواقع، من خلال تصوير حكايات الشباب، وخيوط المعاناة التي تشكل ملابسات كل مأساة. وجاءت مساحات التفوق في تلك القفزات المكانية والزمانية في العمل، حيث ينسلخ الممثلون من قيود السايبر والزمن الراهن، في مشاهد تخييلية تدور في فضاءات بعيدة.
المسرحية تتكون من مجموعة نثارات ومشاهد قصيرة، تبرز الاهتمامات الفردية للشخوص، وهمومهم الذاتية
من هذه المشاهد، استرجاع أحداث ثورة 1919 وتفاصيلها من خلال أحداث رواية “بين القصرين” لنجيب محفوظ، وشخصياته الشهيرة السيد أحمد عبدالجواد وزوجته أمينة وابنهما فهمي أيقونة الثورة وشهيدها، وخطاب التنحي للرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر بعد هزيمة يونيو 1967، وخطابي الرئيس الراحل أنور السادات التاريخيين بعد انتصار 1973، وقبيل زيارته إسرائيل لعقد معاهدة كامب ديفيد، بالإضافة إلى استحضار أجواء مصر الفرعونية في عهد رع وآمون، واستعادة وقائع مسرحية “هاملت” لشكسبير “أكون أو لا أكون”، ومسرحية “سيدتي الجميلة” لفؤاد المهندس، وغيرهما.
مثل هذه الإحالات، التي انطلق فيها الممثلون بملابس تناسب العصور المختلفة من تصميم رباب البرنس، هي التي حركت المسرحية، وكسرت جمودها وبرودتها وانحسارها في إسار السايبر الضيق، خصوصا المشاهد التي أظهرت ملكات الممثلين في أداء الاستعراضات الحركية والغنائية التي صممها محمد ميزو ولحنها محمد شحاتة، ولولا تحفظ فريق العمل وخوفه من تشتيت المشاهدين خارج نطاق الفكرة الأساسية المحصورة في السايبر، لأمكن استغلال هذه الانطلاقات خارج الزمان والمكان، والاستفادة منها جماليّا وفنيّا وذهنيّا على نحو أوسع.
لم تقف المسرحية سلبية إلى النهاية إزاء قوى التغييب التي تحاصر المجتمع وأبناءه الواعدين، وتدفع الشباب إلى الانعزال والإدمان والجنون والتطرف، إنما حاولت طرح الحلول بواسطة شخصية الحكيم العجوز، التي لعبها ياسر صادق (أفضل ممثلي العرض)، فالأضرار النفسية والاجتماعية للسوشيال ميديا من الممكن مواجهتها بتقنين استخدامها مثلا، والفراغ يمكن استغلاله في أنشطة تفاعلية مثمرة على أرض الواقع، والطاقة المكبوتة يمكن توجيهها إلى البناء والعمل الوطني، إلى آخر هذه التوصيات التي جرى تمريرها دراميّا من غير تلقين أو مباشرة.
لقد أوغلت المسرحية في تصوير أن “الشجرة تشيخ”، ولم تعد تحتمل كوكبا معلقا بها بعدما طرحت أوراقها الخضراء التي أظلت الأنبياء والعاشقين، لكن المسرحية فتحت ثقبا صغيرا يأتي منه شعاع دافئ اسمه الأمل، من أجل تجاوز الألم، فكانت كلمة الختام “الوسيلة أن تزرع فسيلة”.