هل يُحدث الاختلاف في اللقاحات فارقا في القضاء على كورونا

لا يمكن للعالم العودة إلى حياته الطبيعية من دون لقاح ضد فايروس كورونا المستجد ومن خلال برنامج تلقيح عالمي منسق، لكن بعد أن ظهرت عدة لقاحات أصبح التركيز العالمي متجها نحو التقنيات التي استخدمت لتطوير هذه اللقاحات ودورها في تحديد مدى فاعلية اللقاحات وملاءمتها للبيئة المناخية لكل دولة.
لندن- بدأ العالم يتنفس الصعداء بعد التوصل إلى لقاحات ضد وباء كورونا وباشرت عدة دول حقن قسم من سكانها بجرعات من اللقاحات التي حصلت على الترخيص، وبقدر ما اهتم العالم بمدى قدرة هذه اللقاحات على توفير المناعة ضد الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها، انصب الاهتمام أيضا بالتقنيات التي استخدمتها المختبرات في تطوير لقاحات كوفيد – 19، ومدى أهميتها.
ووظف العلماء تقنيات مختلفة في تطوير لقاحات كورونا، اثنتان منها تعمل بنفس الطرق القديمة التي استخدمت في لقاحات سابقة؛ إذ تعتمد الطريقة الأولى على حقن الجسم بفايروس حقيقي ضعيف أو ميت، وهو ما استخدم في لقاحات شلل الأطفال والجدري والإنفلونزا، أما الطريقة الثانية؛ فتعتمد على حقن الجسم بجزء صغير من الفايروس لتحفيز مناعة الجسم على العمل لصد الفايروس، أما بقية الطرق فتعتبر حديثة نسبيا.
الفايروسات الموَهَّنة

تحتوي اللقاحات التقليدية على فايروس معطل (موهّن) غير قادر على التسبب في مرض شديد وتثيره استجابة مناعية توفر حماية من الفايروس الحي. وعادة ما يؤثّر إضعاف الفايروس الحي من الهندسة الوراثية على قدرته في التسبب بالمرض أو على التكاثر. ويصيب هذا الفايروس الخلايا متسببا في أعراض خفيفة.
وتتمثل إحدى أبرز المخاوف الصحية من الفايروس “الموهّن” في أنه قد يكتسب تغييرات جينية تمكنه من التطوّر إلى سلالة أكثر خطورة. كما يمكن أن تنتج أخطاء التصنيع لقاحا معيبا يسبب تفشي المرض، وسبق أن حدث ذلك مع لقاح شلل الأطفال.
ومن بين مساوئ اللقاحات الموهّنة أنها قد تكون غير ملائمة للأشخاص الذين يعانون من حالات نقص المناعة، كما هو الحال لدى المرضى الذين يتناولون أدوية لتثبيط المناعة بعد زرع الأعضاء لتجنب رفض العضو المزروع، أو لدى المصابين ببعض أنواع السرطان.
ويتطلب هذا النوع من اللقاحات الموهّنة معرفة عميقة وشاملة بالفايروس المُستهدف، لكن هذه الطريقة تحمل فائدة كبيرة، فهي تشبه العدوى الطبيعية، وتخلق استجابات قوية وذاكرة مناعية يمكن أن تستمر لسنوات عديدة، وهذه التقنية تعمل عليها أكثر من فرقة بحثية حول العالم.
الفايروسات المعطّلة
تم استخدام الفايروسات المعطّلة لأكثر من قرن من الزمان، واستخدمها مبتكر لقاح شلل الأطفال في الخمسينات من القرن الماضي، جوناس سالك، وهي من القواعد الأساسية للقاحات ضدّ عدد من الأمراض، بما في ذلك داء الكلب و”التهاب الكبد أ” (Hépatite A).
ويقصد بالفايروس المعطّل الذي يُقتل كيميائيا، ليصبح أقل ضررا أو أقل قدرة على إحداث المرض، لكنه مع ذلك يساعد الجسم في التعرف على مسببات الأمراض.
لقاح "أوكسفورد" البريطاني اعتمد على تقنية الناقل التي تقوم على الإتيان بفايروس آمن واللعب في تركيبته ليصبح شبيها بتركيبة فايروس كورونا لكن ليست له أعراض كورونا
وبعض اللقاحات التي استخدمت هذه التقنية سابقا، كانت تتضمن كائنات مجهرية كاملة مقتولة، كما هو الحال في لقاح السعال الديكي، الذي يؤخذ عادة مع لقاح التيتانوس والديفتريا.
وكانت هذه اللقاحات أحيانا تسبب أعراضا مؤقتة لأنها تحاكي العدوى الحقيقية. ولهذا كانت فعالة في إثارة استجابات لمناعة قوية، وكثيرا ما كانت تقي من المرض لعقود.
وتوفر الكثير من اللقاحات التي تحتوي على كائنات مجهرية حيّة حصانة مزدوجة من أمراض معدية أخرى لا علاقة لها بالفايروس الذي يراد الوقاية منه. وطورت شركتان صينيتان لقاحات يتمّ اختبارها من أجل السلامة والفعالية في التجارب السريرية واسعة النطاق للمرحلة الثالثة.
وتقف شركة سينوفاك للمستحضرات الدوائية الحيوية ومقرّها بكين وراء لقاح “كورونافاك”، كما صُمم لقاح للوقاية من مرض كوفيد – 19 لدى وحدة تابعة لشركة سينوفارم للأدوية المدعومة من الدولة. ويحتوي اللقاحان على فايروس معطّل، ولم يتسبب في آثار جانبية ضارة خطيرة ودفع الجهاز المناعي إلى إنتاج أجسام مضادة ضد فايروس كورونا المستجد.
نواقل من الفايروسات الغدية

تعد الفايروسات الغدية البشرية من الأكثر سهولة للتحوير الجيني، وهي عبارة عن فايروس نزع منه جين التكاثر، ولذلك فهو لا يمثل خطرا على الجسم من ناحية العدوى. ويستخدم العلماء “النواقل” (vector) من أجل إيصال المادة الجينية من فايروس آخر إلى الخلية، وهو الفايروس الذي يطوّر ضده اللقاح.
وعمل الباحثون من مركز غاماليا الروسي لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة على اللقاحات القائمة على نواقل الفايروسات الغدية منذ الثمانينات من القرن الماضي، وأصبحوا روادا على مستوى العالم في تطوير هذا النمط من اللقاحات.
وتعتمد الكثير من اللقاحات لكوفيد – 19 على نواقل من الفايروسات الغدية، من بينها لقاح “سبوتنيك – في” (Sputnik – V) الذي تم تسجيله من قبل وزارة الصحة الروسية في 11 أغسطس الماضي كأول لقاح مسجّل ضد فايروس كورونا المستجد.
كما اعتمد لقاح “أوكسفورد“ البريطاني على تقنية الناقل التي تقوم على الإتيان بفايروس آمن واللعب في تركيبته ليصبح شبيها بتركيبة فايروس كورونا لكن ليست له أعراض كورونا، وقد تم اختيار فايروس يدعى “أدينو فايروس” (Adenoviruses) الذي يصيب القردة بالزكام، وتم التلاعب بتركيبته ليصبح شبيها بكورونا ومن ثم تمّ حقن شخص به، حتى ينتج جسمه أجساما مضادة.
ويتم خلال عملية تطوير اللقاح، وضع الجين الذي يرمز البروتين – أس للنتوء الشوكي لفايروس كورونا ضمن ناقل من الفايروسات الغدية. وهذا العنصر الذي تمّ إدخاله آمن بالنسبة إلى الجسم، لكنه يحرض جهاز المناعة على الاستجابة وتكوين الأجسام المضادة التي تحمينا من العدوى. وسبق أن نجح علماء مركز غاماليا في إيجاد لقاح ضد حمى إيبولا على أساس نواقل من الفايروسات الغدية وحصلوا على شهادة تسجيل له من وزارة الصحة الروسية.
لقاح الـ"دي.أن.أي"

تستخدم هذه التقنية نبضة كهربائية قصيرة لتوصيل البلازميدات، وهي جزيئات الـ”دي.أن.أي”، التي تحمل المعلومات الجينية الخاصة بالفايروس، إلى الخلايا البشرية، مما يؤدي إلى استجابة مناعية، وتعمل على هذه التقنية شركة “إينوفيو” الأميركية.
وتقول الشركة إن لقاحها المحتمل قادر على البقاء بحالة مستقرة في درجة حرارة الغرفة لأكثر من عام، ولا يحتاج إلى تبريد للنقل أو للتخزين لسنوات عدة، وفق ما أعلن عنه الرئيس التنفيذي للشركة جوزيف كيم. وتعتبر هذه ميزة كبيرة عندما يتعلق الأمر بتحصين أشخاص في دول حارة، حيث من الصعب الحفاظ على سلسلة البرودة الضرورية لحفظ العديد من الأشياء.
الجسيمات الشبيهة بالفايروسات
الجسيمات الشبيهة بالفايروس “في.أل.بي” (VLP) هي جسيمات تشبه الفايروسات الحقيقية، لكنها لا تحتوي على جينات فايروسية، وباستخدامها في اللقاح، يمكنها (بعد حقن اللقاح في الجسم) تحفيز استجابة الجسم لإنتاج الأجسام المضادة، وتحفيز مناعته الخلوية أيضا، بهدف التصدي للفايروس دون وجود خطر للعدوى. وتشبه جسيمات”في.أل.بي” (VLP) اللقاحات الأخرى، إذ تُساعد الجسم على التعرف على الفايروس والتخلص منه.
أما تلقيح الحمض النووي الريبوزي فهو تقنية تستخدم لحماية الكائن الحي من الأمراض عن طريق حقنه بحمض نووي «دنا» مُهَنْدَس وراثيّا لإنتاج استجابة مناعيّة. ويعني ذلك أن جزءا من الشيفرة الجينية لفايروس كورونا يتم حقنه في الجسم، الأمر الذي يحفز الجسم على البدء في إنتاج البروتينات الفايروسية، وهذا المقدار كاف لتدريب النظام المناعي.
الأحماض النووية
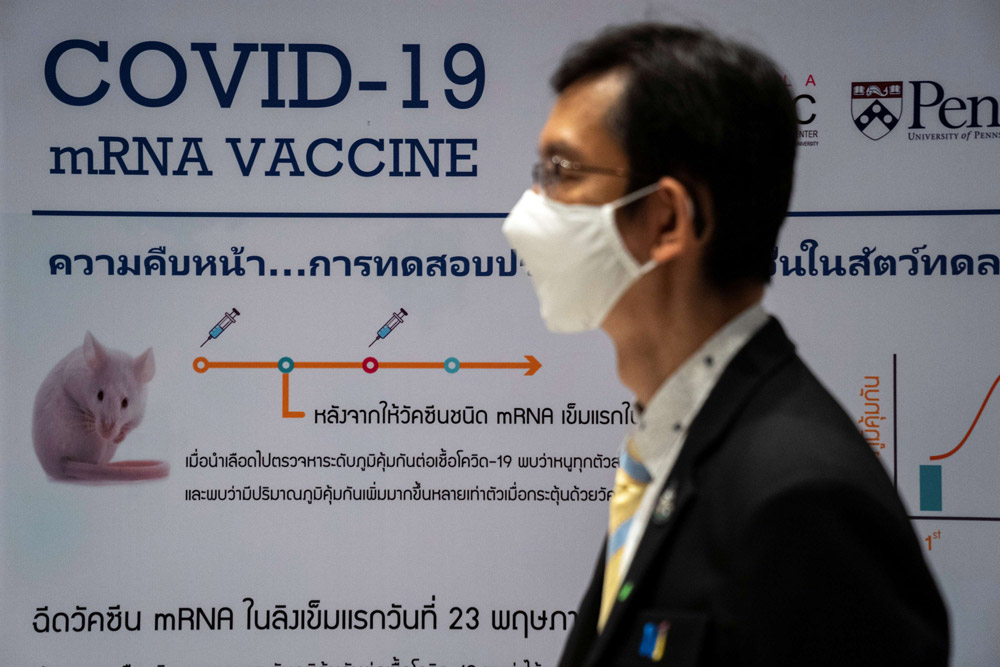
وقد تم اعتماد تقنية الحمض النووي الريبوزي (mRNA) في تطوير لقاحي موديرنا وفايزر – بايونتيك الأميركيين. وأهم الاختلافات بين اللقاحين، أن موديرنا يمكن تخزينه في ثلاجات عادية ولا يتطلب شبكة نقل فائقة البرودة، ما يجعل الوصول إليه أكثر سهولة بالنسبة إلى المرافق الصغيرة والمناطق النائية.
ويحتاج تخزين لقاح موديرنا إلى حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية، وذلك لمدة 30 يوما، في حين يحتاج لقاح فايزر إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر، لتخزينه للمدة نفسها.
وقال البروفيسور المساعد، لويو داهي، من جامعة نانيانغ التكنولوجية “لقاح كورونافاك (الصيني) يعتبر طريقة أكثر تقليدية يتم استخدامها بنجاح في عدة لقاحات مشهورة”.
وأضاف “لقاحات الحمض النووي الريبوزي تعتبر نوعا جديدا من اللقاحات وليس هناك (حاليا) مثال ناجح على استخدام هذه اللقاحات بين البشر”.
ومن الناحية النظرية، تكمن إحدى مزايا لقاح سينوفاك الرئيسية في إمكانية تخزينه في ثلاجة عادية في درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية، مثل لقاح أوكسفورد، المصنوع من فايروس تم تعديله وراثيا ويسبب نزلات البرد الشائعة لدى قردة الشمبانزي.
اختيار الدول للقاح يعتمد على أكثر من عامل، من بينها العامل الاقتصادي ومدى توفر اللقاح وسلامته وفعاليته
وينبغي تخزين لقاح موديرنا في درجة حرارة -20، بينما يجب تخزين لقاح فايزر في درجة حرارة -70.ويعني ذلك أن لقاح سينوفاك ولقاح أوكسفورد – أسترازينيكا مفيدان أكثر بالنسبة إلى البلدان النامية والتي قد لا يكون في مقدورها تخزين كميات كبيرة من اللقاح في درجة حرارة منخفضة.
وأكد استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، أمجد الخولي، أن الفارق التقني بين لقاحي “سينوفارم” و”فايزر – بايونتيك” لا يعني أن أحدهما أفضل من الآخر، على الرغم من أن نسبة فعالية لقاح “فايزر – بايونتيك” تصل إلى 95 في المئة، بينما تصل نسبة فعالية لقاح “سينوفارم” إلى 86 في المئة.
لكن بعيدا عن الاختلافات التقنية، يعتقد أمجد الخولي، أن اختيار الدول للقاح يعتمد على أكثر من عامل، من بينها العامل الاقتصادي وتوفر المنتج، قائلا “لن يستطيع منتج واحد تغطية احتياجات العالم كله، وبالتالي يمكن أن تلجأ الدول لأكثر من مورد طالما أن النتائج الأولية مبشرة وتؤكد سلامة اللقاح”.


























