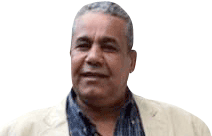هل ينقذ “تزاوج” نهر الكونغو والنيل مصر

تزداد مشكلة مصر مع المياه تأزما بينما تتحول التحذيرات من حالة العطش التي تنتظرها إلى حقائق تتجسد يوما بعد يوم وتنذر بكارثة شاملة؛ طبيعية وبيئية واقتصادية وسياسية واجتماعية، باتت تهدد هبة النيل، طالما تعطي أولوية الاهتمام لمشاكل راهنة على حساب هذه القضية القومية المصيرية، في الوقت الذي تشهد فيه دول حوض النيل تغييرات سياسية وصناعية وتنموية كبرى بشكل يغير المعادلات، وبالتالي ميزان القوى في التفاوض والاتفاقيات.
القاهرة – قبل اكتشاف منابعهما، اعتقد قطاع وازن من الجغرافيين وعلماء العمران، عبر التاريخ، أن نهر الكونغو هو فرع من فروع النيل. وحين تأكد استقلالهما بحوض وجغرافية منفصلين، طرحت سيناريوهات “تزويجهما”، فتبلور من هذه السيناريوهات، نسبيا، مشروعان؛ الأول عبر النيل الأبيض إلى جنوب السودان، والثاني عبر بحيرة تشاد إلى مثلث العوينات جنوب غرب مصر.
يعتبر نهر الكونغو ثاني أطول أنهار أفريقيا، بعد النيل، وأوسعها حوضا، وهو أعمق أنهار العالم، وثانيها غزارة، بعد الأمازون. والكونغو الديمقراطية، كدولة، بها نصف مياه القارة، حيث يتدفق نهرها بعنفوان 40 ألف متر مكعب في الثانية. وتغذّي مجراه الواسع شبكة روافد. وتندفع مياهه داخل المحيط الأطلسي إلى عمق 30 كيلومترا، لـ”يُهدر” فيه سنويا ألف مليار متر مكعب. وتتشارك في حوضه تسع دول، أربع منها “نيلية”.
فكرة المشروع الأقدم، اقترحها أباتا باشا، كبير مهندسي الري المصريين بالسودان، عام 1902. وقد كلف أباتا نظيره البريطاني ويليام جارستين، بدراستها، فأعد تقريرا مفصلا عام 1904، ما زال مرجعا أساسيا لحوضي النيل والكونغو. ومحور الفكرة، ببساطة، “عكس” اتجاه ثان لمصب النهر نحو النيل شرقا إضافة إلى الأصلي باتجاه الأطلسي غربا، عبر ربط الكونغو بالنيل الأبيض، في جنوب السودان، بقناة اصطناعية.
تجدد طرح الفكرة مرات عدّة، وفي الستينات تأجلت مناقشتها أمام أولوية السد العالي، لأن الظروف الجيوسياسية لم تكن ملائمة. وفي السبعينات، تقدمت القاهرة خطوة بإرسال فريق يقوده إبراهيم مصطفى كامل، الخبير الهندسي في مياه النيل، وإبراهيم حميدة، الرئيس السابق لمركز بحوث الصحراء والمياه، لمعاينة الطبيعة الجغرافية للنهر، ومدى صلاحية الفكرة. وتمّ إعداد تقرير إيجابي.
بعدها، لجأ أنور السادات إلى شركة “آرثر دي ليتل” بواشنطن، المتخصصة في الدراسات الاستراتيجية، والمعتمدة كمكتب استشاري للبيت الأبيض. فنصحت دراستها، عام 1980، بتنفيذ المشروع، لأنه:
– يوفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وزراعة 80 مليون فدان، وتزداد كميات المياه خلال 10 سنوات لتبلغ 112 مليارا، تسمح بزراعة نصف الصحراء الغربية.
– يوفر للدول الثلاث -الأربع الآن- مصر والسودان وجنوب السودان والكونغو، طاقة كهربائية تكفي لثلثي قارة أفريقيا؛ 18 ألف ميغاوات، أي 10 أضعاف طاقة السد العالي. قيمتها، إذا صُدِّرت، 21 مليار دولار سنويا.
– يوفر للدول الثلاث 320 مليون فدان صالحة للزراعة.
– يسمح لدولتي المصب بتخزين كميات ضخمة، في مصر بمنخفض القطارة، وبالتبعية مضاعفة الخزان الجوفي وتخفيف ملوحته، وفي السودان عبر بحيرات صناعية بالمناطق المنخفضة.

لكن، لم تخرج الفكرة إلى المجال العام وقتها. ورصدت دوائرها تحديات فنية، مثل صعوبة التعامل مع الفاصل الصخري بين الحوضين، 600 كم، وقدرة النيل على تحمّل التدفق المتوقع، وعراقيل قانونية تتعلق بالأحواض المشتركة، والأهم مخاطر “الأسر النهري” للنيل من قبل الكونغو الأقوى والأقل ارتفاعا، ما يعني “شفطه” وتحويل مساره عكسيا، ليختفي من مصر والسوادن.
صدفة كانت وراء الطرح الرابع، وتفادي التحديات الأكبر، وتحويلها إلى حلم يداعب المصريين للتخلص من “واحدية” مصدر وجودهم. حدث ذلك في مارس 2011، حين نشطت الدولة المصرية لتفعيل تراثها الأفريقي، بداية من حوض النيل ومع أكثر من دولة.
لكن ما يهم بين هذه الدول هي الكونغو. وقّعت وزيرة التعاون الدولي السابقة، فايزة أبوالنجا، سلسلة من الاتفاقات، منها منحة بـ10.5 مليون دولار، لتأهيل كوادر من الكونغو بمركز تدريب الري الإقليمي في القاهرة. وحفر 30 بئرا توفر مياه الشرب وري الزراعات البسيطة، في 30 تجمعا بشريا. وإقامة سدود صغيرة لتوفير احتياجات الزراعة والرعي، في تجمعات أخرى. ودراسة إنشاء سدود، متعددة الأغراض، من ضمنها توليد الكهرباء.
في يونيو من نفس العام، رعت أبوالنجا استثمارا مصريا خاصا، ضخما، في الكونغو، وهو شركة قابضة باسم “ساركو”، نالت امتياز تشييد شبكة طرقات برية وسكك حديد بطول 1280 كم، تعبر 22 رافدا للنهر، وإنشاء مجموعة مطارات، وشركة طيران “إفراتا إير لاين”، وامتياز مناجم ذهب ونحاس وألماس، وشركة تنقيب عن البترول، ومصنع ضخم للإسمنت، ومجمعات علاجية، وشبكة محمول. ولغياب بنية الدولة عن كيشانسا، استعانت الشركة بهيئات مصرية. وأُعدت 295 خارطة توفر معلومات كاملة عن الكونغو.
أثناء العمل، لاحظ عبدالعال حسن عطية، نائب رئيس الثروة المعدنية المصري، وقتها، تقاربا بين أفرع النهرين داخل الأراضي الكونغولية. كان حسن متابعا لفكرة الربط، فتجددت، مع تحويل المشروع من “ربط” إلى “نقل” عبر 4 رافعات مياه عملاقة متتابعة، كلفتها مليار دولار. أعادت الشركة دراسة المشروع بسيناريوهاته الأولى والمستحدثة، وتواصلت مع الرئيس الكونغولي، وقتها، جوزيف كابيلا، وسلمته ما في حوزتها.
يقول طارحو المشروع “المعدل”، “درسناه فنيا، وتصميماتنا لدى الجهات السيادية. أضيف إلى المزايا السابقة: إحداث طفرة تنموية مشتركة، تعيد إلى القاهرة صورتها كقاطرة لتقدم القارة. ومحطات رفع عملاقة تشغل مولدات كهرباء تنتج 300 مليار وات في الساعة، تنير القارة كاملة. وإقامة 20 تجمعا عمرانيا، كمرحلة أولى، يفصل بينها مئتا كيلومتر لكل تجمع، بطول 4200 كيلومتر، في الدول الأربع.
لكن وزارة الموارد المائية أعلنت في يناير 2015 رفضها له، ووصفته بـ”الخيالي فكرة وتكلفة”. وما يدهش أن أسباب الرفض، من الحكومة وخبراء، تستند في معظمها إلى ما تم تجاوزه في الطرح “المعدل”.
قناة ترانسكوا

سيناريو تشاد طرحه لأول مرة مهندس إيطالي عام 1935. تقوم فكرته على ربط رافد أوبانجي، الكونغولي، عبر جمهورية أفريقيا الوسطى لمسافة 1600 كم، بنهر شاري الذي يصب في بحيرة تشاد، ومنها إلى النيل عبر مثلث العوينات، حيث فرع مندثر منه بالصحراء الغربية.
تجدد الطرح “جزئيا” في الستينات، كمشروع تنموي لعشرات الملايين بـ12 دولة في أفريقيا الوسطى والساحل، من بينها ليبيا والجزائر، واستبعدت منه فكرة المد للنيل. ومع مؤشرات جفاف البحيرة، ما يهدد مصدر رزق وحياة مئات الملايين، كرر المهندس النيجيري، ج. أومولا، عام 1982، وشركة “بونيفيكا” لاستصلاح الأراضي الإيطالية، الطرح الجزئي، مع تصميمات فنية له.
وفي عام 1994، اقترحت لجنة حوض البحيرة مشروعا مشابها. وانعقدت قمة لرؤساء دول حوضها في مارس 2008، برعاية اليونسكو، أقر خلالها المشروع. عرف المشروع باسم قناة ترانسكوا. وعام 2017 دخلت مجموعة “باور كونستراكشن” الصينية، المتخصصة في البنية التحتية لمشروعات الطاقة، متبنية المشروع، ورصدت 14 مليار دولار كتكلفة أولية. لكن المشروع رفض من قبل المعارضة الكونغولية. وقال، موديست موتينجا، عضو مجلس الشيوخ الكونغولي، ومؤلف كتاب “حرب المياه على أبواب الكونغو”، “لن نحل مشكلة تشاد على حساب نظامنا البيئي”.
مشروع التشاد الموازي
الوضع مختلف مع القاهرة، فقد حصل طارحو مشروعها على موافقة كينشاسا، وأربع دول أخرى. ومصر يمكنها التدخل لتغيير رفض المشروع التشادي الموازي، كبديل، مع إعادته إلى طرحه الأول الممتد حتى مثلث العوينات، وتطويره ليصبح تنمويا مشتركا.
للقاهرة تراثها الإيجابي في الكونغو، التي لم تنس دعم جمال عبدالناصر لنضال رمزها التاريخي، باتريس لوممبا، وإرساله قوات مصرية لحماية الدولة الوليدة، بقيادة سعدالدين الشاذلي. الأهم أن طرحها محوره “شراكة تنموية” تحدث للكونغو طفرة نوعية، بالتوازي مع ما تشهده من تحول سياسي، عبر نقل سلمي نادر للسلطة في القارة السمراء، من الرئيس السابق جوزيف كابيلا، إلى المعارض فيليكس تشيسيكيدي، في نهاية يناير الماضي، مع غالبية لحزب الأول في البرلمان والحكومة، وهو ما رأته ليلى مرزوقي، ممثلة الأمم المتحدة في الكونغو، أمام مجلس الأمن الدولي مؤشرا إيجابيا على “إصلاحات جريئة تعزز المؤسسات وتحسن الظروف المعيشية للكونغوليين”.
تستتبع المشروعات التاريخية تحديات وتكلفة توازيها، تستحقها إذا ما درست احترافيا. فقط، تحتاج القاهرة إلى رجل دولة يجمع وعيه لإنقاذها من أن تصبح “مومياء سياسية”، كما حذر جمال حمدان؛ إذا ما حرمت من النيل، وبيّن دورها القاري لتسترد مكانتها كرمز أفريقي.. هذه المرة في التقدم، بعد أن كانت أيقونة للتحرر.