مصطلح "ما بعد الإسلام السياسي" محاولة لتجميل الأحزاب الدينية

البحوث التي تؤمن بفكرة “ما بعد الإسلام السياسي” وتقدم الأدلة على وجوده ضمن المشاهد السياسية في عدد من الدول العربية لا يمكن أن تمرر دون نقد فهي تعتبر مجرد محاولات لإعطاء هذا المصطلح الجديد شرعية تتضمن مساعي لتجميل الأحزاب الدينية والإسلام السياسي عموما، بعد أن أخذ ينحسر في الدول التي شهدت حكومات إسلامية وبسبب العنف الديني الذي مارسته الجماعات المتطرفة.
لندن – صدر عن مركز “الدراسات الاستراتيجية” (2018) كتاب “ما بعد الإسلام السياسي”، وهو على ما يبدو جديد في موضوعه، لكن من يقرأه يجد فيه تبريراً لعودة الإسلام السياسي بتعلة أن الأحزاب الدينية قد تغيرت وقدمت مراجعات لنفسها، وتخلت عن أهدافها في قيام دولة إسلامية، وأسلمة المجتمع، وهذا في واقع الحال لم يكن إلا تكتيكاً من قِبل هذه الأحزاب، كي تجعل من الديمقراطية ومسايرة العصر مركباً لتحقيق هدفها المذكور، والسبب أنها لو تخلت عن ذلك الهدف ستكون أحزاب بلا هوية دينية عقائدية، وبالتالي ليس من داع البحث في الإسلام السياسي وما بعده.
مضمون الكتاب هو في الأصل نقاشات ندوة عُقدت لهذا الغرض، وشاركت في تنظيمها مؤسسة فريدريش أيبرت الألمانية في الأردن والعراق، جمعها وحررها الكاتب الأردني محمد رمان.
جاء إصدار الكتاب في إطار سلسلة منشورات أصدرتها مؤسسة البحث الألمانية حول الإسلام السياسي، تضم تسعة عشر كتابا، تتناول فكرة أن الأحزاب الدينية في السنوات الأخيرة أخذت تلعب دورا مهما في الحياة السياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم أيضا.
غير أن الظروف شابتها تغيرات لم تكن في صالح الإسلام السياسي، فحاولت الأحزاب الدينية مسايرتها بالقبول بالديمقراطية مثلا والتعددية مرحليا، ليبرز مصطلح “ما بعد الإسلام السياسي” فيما يعتبره البعض ظاهرة جديدة.
لو نوقشت مبررات الإسلام السياسي لوجدناها بعيدة عن الواقع، فالأحزاب الدينية لم تتخل عن أهدافها التي نشأت عليها. حزب النهضة في تونس ما يزال بعيدا جدا عن مثال الأحزاب المسيحية الديمقراطية، فهي مسيحية بالاسم فقط.
من أمثلة الأحزاب التي اعتمدها الباحثون كنموذج لمفهوم “ما بعد الإسلام السياسي”: حزب العدالة والتنمية التركي، وحزب العدالة والتنمية المغربي، وحركة النهضة التونسية، وهناك أحزاب وجماعات أخرى أخذت تحذو حذو هذه الأحزاب المذكورة في قبول الديمقراطية والتي لم تقبلها إلا بعد التأكد أنها لصالحها وذلك باستغلال الشعور الديني لدى الناس. ومع ذلك، هناك من يشكك في حقيقة المصطلح الجديد وينكر أي تطور لدى الإسلاميين جميعا بعيدا عن الإسلام السياسي نفسه، حتى بعد سقوط تجربة الإخوان المسلمين في مصر في 2013. فالاتجاه الصاعد لدى الإسلاميين، مع اختلاف درجاته، هو اتجاه راديكالي في جوهره.
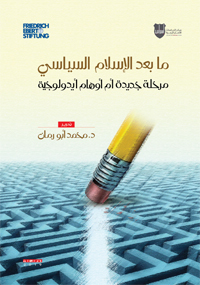
عموماً، اتخذ الكتاب من مناقشة الحجج والأفكار السابقة ومحاولة تفكيك جدلية مفهوم “ما بعد الإسلام السياسي” مهمة له. وتبدو محاولات شرعنة المصطلح هادفة إلى تجميل الأحزاب الدينية والإسلام السياسي عموما، بعد أن أخذ ينحسر من ضمائر الناس في الدول التي شهدت حكومات إسلامية، والعنف الديني الذي مارسته الجماعات المتطرفة.
فولادة مفهوم مرحلة “ما بعد الإسلام السياسي”، بحسب الكتاب، يتمثل بالفشل والتقهقر من جهة والتطور الطبيعي من جهة ثانية. طرح ذلك الباحثان في الحركات الإسلامية، نادر الهاشمي وناثان بروان، مع القول بعدم جمود الحركات الإسلامية، إنما هي حركات مرتبطة بسياقات تاريخية واجتماعية وثقافية تتطور تطورا طبيعيا عبر مراحل عقائدية وسياسية، وبالتالي ستتحول إلى أحزاب تخلع عنها طابع الإسلام السياسي أو إطاره المغلق عقائديا أو أيديولوجيا، لتدخل في مرحلة جديدة أُطلق عليها بمرحلة “ما بعد الإسلام السياسي”.
ويبقى حزب العدالة والتنمية التركي، ومنذ تشكيله في العام 2001 المثال الواضح على مفهوم “ما بعد الإسلام السياسي” على الانتقال من الإسلامية الراديكالية إلى القبول بالديمقراطية والعلمانية، بعد التخلي عن الخطابات الدينية الإسلامية السياسية. وقد قاد ذلك إلى وصف هذا الحزب المنتمي إلى التنظيم العالمي للإخوان المسلمين بأنه حزب ديمقراطي محافظ شأنه شأن الأحزاب الديمقراطية المحافظة الأوروبية.
أما في إندونيسيا فالخطاب الإسلامي يتجه إلى التطور نحو الإسلام الليبرالي والتقدمي، وفق وصف الكتاب لهذه التجربة، وذلك باتجاهه نحو الديمقراطية والقبول بالتعددية والحداثة. وفي النموذج الإسلامي السياسي الأردني، خرجت قيادة الأحزاب الإسلامية الأردنية الجديدة من رحم الإخوان المسلمين الأردنيين، فظهر حزب الشراكة والإنقاذ وحزب المؤتمر الوطني الأردني (زمزم) والجمعية الجديدة لجماعة الإخوان المسلمين. وتنتمي هذه الأحزاب بمختلف تطوراتها إلى مرحلة ما بعد الإسلام السياسي، بتعلة أنها تدعو إلى دولة مدنية، دون أن يقدم الكتاب دلائل على أن هذه التطورات لم تكن مجرد تكتيكات لمواجهة التراجع الإسلامي.
أما في الإسلام السياسي الشيعي فيرى الكتاب أنه شهد تطورات وتحولات يمكن وضعها ضمن مفهوم “ما بعد الإسلام السياسي”، خاصة التيارات التي تخلت عن عقيدة “ولاية الفقيه” السياسية، وقبلت بالديمقراطية والعلمانية، ومثال ذلك الأفكار التي بشر بها آية الله حسين منتظري، الذي كان في بداياته متحمساً لولاية الفقيه، وهو الذي دعا إلى تطبيقها في إيران، قبل أن يُسجن في داره، وعزز الكتاب هذا الطرح بمواقف محمد مهدي شمس الدين رجل الدين الشيعي اللبناني والبعض من آراء آية الله علي السيستاني المرجع الشيعي الأعلى في العراق.
لكن من الصعب القبول بالمنطق الذي يعتبر هذه الآراء تحولات من الإسلام السياسي إلى “ما بعد الإسلام السياسي”، بينما الأساس فيها وخصوصا آراء السيستاني وشمس الدين أنها فقهية وليست سياسية.
التبشير بمفهوم ما بعد الإسلام السياسي لا يعني غير تشجيع التطبيع مع الأحزاب الدينية، بتقديمها بشكل جديد لكن الجوهر يبقى نفسه “إسلام سياسي”، ينتظر فرص “التمكين”، للوصول إلى أهدافه في أسلمة المجتمعات وقيام النظام الديني. لم يكن هذا الكتاب هو الوحيد في موضوعه إنما هناك أكثر من كتاب للدفع بهذا المصطلح كي يتحول من وهم إلى حقيقة، مثل كتاب “ما بعد الإسلاموية:الأوجه المتغيرة للإسلام السياسي”.




























