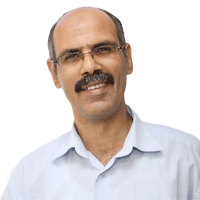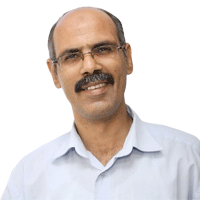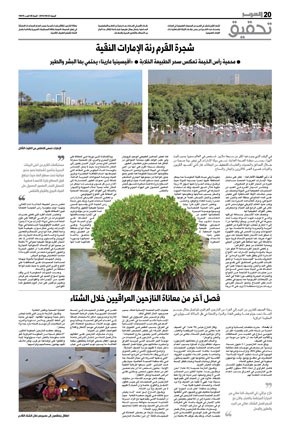عن أوليفيي روي والإخوان المسلمين وداعش

أعاد الباحث الفرنسي أوليفيي روي إصدار كتابه “فشل الإسلام السياسي”، الذي صدر للمرة الأولى عام 1992، في ظل الأحداث التي كانت تجري بالجزائر، مذيّلا بملحق جديد من اثنتي عشرة صفحة، كتب في ضوء التطورات الجارية اليوم.
وقد أثار الكتاب أثناء صدوره في تلك المرحلة من بداية التسعينات جدلا في أوساط الباحثين المشتغلين بالظاهرة الإسلامية، وبالاستشراق الصحفي الذي بدأ ينمو بشكل خاص في الصحافة الفرنسية خلال تلك الفترة، بسبب التداعيات التي خلفتها أحداث الجزائر في الساحة الفرنسية. ووجه المفاجأة أن أوليفيي روي بدا كما لو أنه يستبق الأحداث ويصادر على المطلوب، بحيث ظهر عنوان الكتاب نشازا في النغمة العامة التي كانت تسير فيها البحوث والدراسات التي انصبّت على الظاهرة الإسلامية السياسية في الغرب عامة، وفي فرنسا بشكل خاص.
لقد صدمت التطورات السياسية التي وقعت في الجزائر في تلك المرحلة الجميع، بعد الفوز الكبير الذي حققته الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات التي نظمت في العام 1991، إثر تنحية الشاذلي بن جديد ووضع دستور جديد والسماح بتأسيس أحزاب سياسية والخروج من خندق الحزب الوحيد. وتتمثل قوة النموذج الجزائري في أنه كان -في تقديرنا- أول تجربة مكنت من خروج ظاهرة ما سمي بـ”الأفغان العرب” إلى العلن، بعدما خرج من أحشاء الجبهة “الجيش الإسلامي للإنقاذ”، الذي تشكلت نواته من الجزائريين الذين سبق لهم أن قاتلوا في أفغانستان، وسوف تصبح الحالة الجزائرية في ما بعد الأرضية الخصبة التي نما فوقها الفكر المتطرف وازدهر فيها التيار التكفيري، بحيث أن تلك التجربة كانت اختبارا أوليا لعدد من الأفكار الجذرية في الفكر الديني، وبداية ازدهار فتاوى التكفير والقتل، التي تطورت في ما بعد فأصبح لها باب خاص في الفكر التكفيري الحالي.
التجربة الجزائرية كانت اختبارا أوليا لعدد من الأفكار الجذرية في الفكر الديني، وبداية ازدهار فتاوى التكفير والقتل
بيْدَ أن أبرز التساؤلات التي طرحت، على هامش الحالة الجزائرية، كانت ترتبط بعلاقة الدين بالسياسة في الفكر الغربي المعاصر. وبالنسبة لأوليفيي روي، فإن الفكر السياسي الغربي التقليدي انكمش طويلا داخل قوقعة وضعها ماكس فيبر، رافضا الخروج منها. ذلك أن فيبر أكد بأن الحضارة الوحيدة التي استطاعت خلق مجال سياسي متميز، منفصل من جهة عن المجال الديني، ومن جهة ثانية عن المجال الخصوصي أو الشخصي، وبأن هذا المجال السياسي المتميز هو ما نطلق عليه “دولة القانون الحديث”.
ينتقد أوليفيي روي، مسلحا باطلاع واسع على الأدبيات الغربية، هذه الفكرة، بحيث يشير إلى أن الإيمان بها يقود إلى استنتاج مفاده أن الخلاص بالنسبة إلى جميع الأمم والشعوب اليوم هو النموذج الحضاري الغربي، وهو ما يسميه بـ”النزعة المقارنية”، أو نزعة المقارنة بين النماذج والانتصار لواحد منها على الآخر.
يعتبر روي من المطلعين الجيدين على الكتابات الدينية الإسلامية، لذلك ينطلق من معرفة صلبة بهذه الكتابات لكي يؤكد -مستفيدا من قراءاته للفقه السياسي الإسلامي- أن الجوهر الأساسي في الإسلام يكمن في “الشريعة”، بالمعنى الواسع للكلمة لا بمعنى الفقه، كما يصر على ذلك السلفيون ومن يدور معهم. وبحسب روي، فإن هذه الشريعة تتميز بخاصيتين أساسيتين: الخاصية الأولى هي الاستقلالية عن السياسي، والخاصية الثانية هي الانفتاح والقابلية المستمرة للإضافة، أو التراكم. فالشريعة لم تغلق على الإطلاق طوال تاريخ الإسلام، لأنها لا ترتكز على”حزمة من التصورات بل على مجموعة من المبادئ الإرشادية العامة التي تهم جميع ما يتعلق بالشأن الإنساني”.
أبرز التساؤلات التي طرحت، على هامش الحالة الجزائرية، كانت ترتبط بعلاقة الدين بالسياسة في الفكر الغربي المعاصر
ويلاحظ روي أن عدم حصر الشريعة داخل مؤسسة معينة، من جهة، وعدم انغلاقها داخل قواعد محددة سلفا، من جهة ثانية، هما “نقطتا الضعف” اللتان جعلتا الاستبداد السياسي -بوصفه استيعابا للاجتماعي من لدن السياسي- غير ممكن في تاريخ الإسلام. وعلى النقيض من التجربة الغربية، حيث تضخم الدولة الذي يؤدي إلى الديكتاتورية، فإن الإسلام لا يمنح سوى حيز صغير للمجال السياسي، الأمر الذي يجعل من المستبعد تأسيس نظام استبدادي باسم الدين. غير أن الملحق الذي ذيّل به أوليفيي روي كتابه -الذي لم يكن جديدا بالنسبة إلينا بعد سنوات عدة على قراءته للمرة الأولى- هو ما استرعى الاهتمام، بالنظر للخلاصة التي خلص إليها.
فبحسب روي فإن تنظيمي القاعدة وداعش لا علاقة لهما، لا من الناحية التنظيمية ولا من الناحية الفكرية، بجماعة الإخوان المسلمين، والاستثناء الوحيد لديه هو “المجموعة الصغيرة من المصريين التي التحقت بأسامة بن لادن في أفغانستان في نهاية الثمانينات بعد أن قطعت علاقتها بالجماعة”، في إشارة إلى أيمن الظواهري ومن معه، علما بأن هذه المجموعة قطعت علاقتها بالإخوان المسلمين قبل نشأة الجهاد الأفغاني.
لقد انطلق روي في مقدمة كتابه من منطلقات ناقضت ما ورد في الملحق المذي. فقد توقف عند ظاهرة تضخيم مفهوم الدولة في الفكر السياسي الغربي، وعد ذلك التضخيم من الأسس الموضوعية التي يمكن أن ينشأ عنها الاستبداد السياسي، بل نشأ عنها هذا الاستبداد بالفعل، طالما أن الستالينية والنازية، على سبيل المثال، كانتا من نتاج تلك النظرية حول الدولة، ثم إنه اعتبر أن ما منع هيمنة السياسي على الاجتماعي في الإسلام هو أن هذا الأخير لم يمنح المجال السياسي الحيز الذي منحه إياه الفكر الغربي الحديث. بيد أنه لم يفطن إلى قضية جوهرية، ترتبط بالتحول الذي حصل في الفكر السياسي الإسلامي الحديث، وانقلاب الدور بين الاجتماعي والسياسي، بحيث صار الأخير أكبر من الأول ومستوعبا له، من خلال تضخيم السياسي باستيلاد مفهوم “الدولة الإسلامية”، وتقزيم الاجتماعي من خلال التنظير للوصاية السياسية للدولة على المجتمع والأمة، ولم ينتج هذا التحول إلا مع ظهور التيار السياسي الإسلامي، ممثلا بداية في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، قبل أن يتبلور لاحقا في أدبيات كل من أبي الأعلى المودودي ثم سيد قطب، لكي تصبح الدولة في الإسلام هي القاعدة التي ينهض عليها المجتمع، بعد أن كان المجتمع هو القاعدة التي تنهض عليها السياسة.