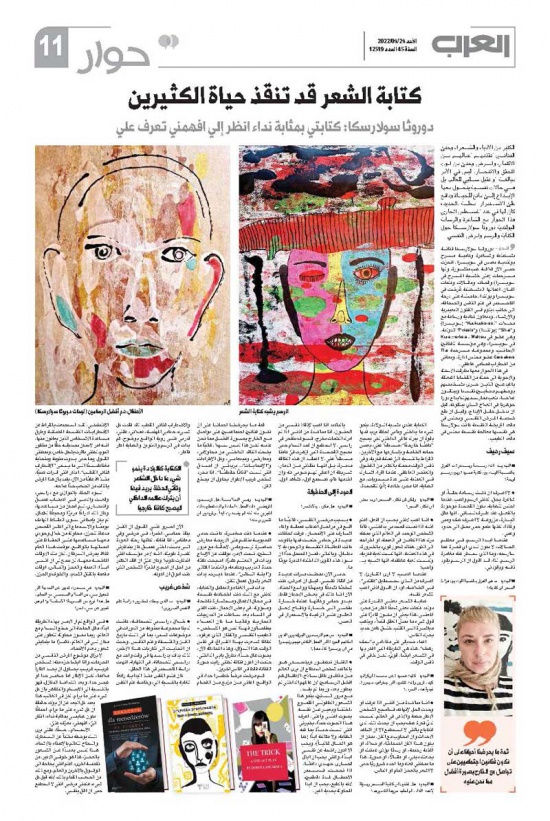صمت إقليمي ودولي مريب بعد ارتفاع ضجيج السلاح في طرابلس

عاد السلاح ليكون هو المحاور الوحيد بين الخصوم في ليبيا وسط صمت دولي غريب كأنما فهم العالم أن أفضل طريق لحل الخلافات هي فسح المجال أمام الحرب عسى أن تفضي إلى منتصر يتم التعامل معه كشريك للحوار. لكن هذا الرهان لا يبدو منطقيا، فالحرب ستزيد من تعقيد الأوضاع خاصة بالنسبة إلى المدنيين.
في كثير من الدول التي يرتفع فيها الرصاص يتم الحديث عن أهمية إخماده قبل أن يزداد اتساعا وتصعب السيطرة عليه إلا في ليبيا التي بدأت في عاصمتها طرابلس ملامح اشتباكات تتعالى بين الميليشيات التابعة لكل من رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المعينة من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا.
لم يعلن المجتمع الدولي وقواه المنغمسة في الأزمة الليبية عن تبني موقف صارم مما يجري ويمكن أن يضرم المزيد من النيران في البلاد، كأن الأطراف المعنية بالأزمة ترتاح لهذه الاشتباكات التي قد تعفيها من مسؤولية البحث عن تسوية سياسية بعيدة المنال، على أمل أن يزيح أحد الطرفين الآخر وينهي أزمة الازدواجية الحادة في الحكومة، ويوقف حيرة البعض في المفاضلة بين الدبيبة وباشاغا.
يمثل توازن القوى في ليبيا أحد علامات الضعف في عملية إدارة الأزمة في شقيها السياسي والعسكري، ولعب هذا البعد دورا سلبيا، فعندما تصعب التسوية الرضائية بين القوى المتصارعة يتم اللجوء إلى الأوزان النسبية لكل منها لتوزيع الحصص وممارسة ضغوط كنوع من الوسائل التي توقف استمرار النزيف.

تبدو هذه المعادلة في ليبيا متساوية إلى حد كبير، فالطرف الذي يملك تفوقا سياسيا يفتقر إلى التفوق العسكري أو العكس، كما أن المكونات الاجتماعية التي تلعب دورا مهما تكاد تصبح متقاربة بين الأطراف المتنازعة، وما يجعل الأزمة تدور في حلقات مفرغة أن السياسيين الذين يستثمرون في الميليشيات يعلمون أن المعارك الممتدة تحمل خسارة لهم ويفضلون أن يكون رفع السلاح محكوما بضوابط عصابات لا يجب أن تستغرق في الحرب وقتا طويلا يكبدها جميعا خسائر فادحة، ناهيك عن ميول قوى خارجية منقسمة أيضا، حتى لو تغيرت التوجهات، فكل طرف لديه قوة أو أكثر تدعمه وتقف خلف تحركاته السياسية والعسكرية، وهي إشكالية عميقة تسببت في الانسداد الحاصل حاليا وتفسير التذبذب الذي شهدته المبادرات المختلفة الرامية إلى إيجاد حل، فكلما ظهرت على إحداها بادرة أمل انتكست فجأة لتعيد المشهد إلى صورته القاتمة التي ترتاح لها بعض القوى طالما أن التسوية لن تحقق لها أهدافها.
لا ينطبق المثل الشائع “كلما اشتدت الأزمات انفرجت” هنا على الحالة الليبية، فمن يعولون على أن تؤدي الاشتباكات المستمرة إلى إعادة فرز للقوى الفاعلة يمكن أن يصبح تقديرهم خطأ، فكمية السلاح التي تملكها ميليشيات كبيرة بصورة لا تجعل الرهان على فوز طرف وهزيمة آخر سريعا مسألة سهلة.
ولم يتوقف تدفق الأسلحة على ليبيا، برا وبحرا وجوا، الفترة الماضية، على الرغم من قرارات مجلس الأمن بحظر تصدير السلاح، واستمرار العملية “إيريني” في عرض البحر المتوسط لمنع تهريب الأسلحة، وكل ذلك يتم تحت سمع وبصر المجتمع الدولي الذي يتشدق بأنه يبحث عن حل للأزمة الليبية دون أن يستخدم أدوات فاعلة، ويرفض تفاقم الأوضاع بالطريقة التي تؤدي إلى غلبة صوت الرصاص على العقل.
يأتي التفكير في حسم ما يجري في طرابلس عبر الرصاص نتيجة طبيعية للعقم الذي أصاب المؤتمرات الدولية التي عقدت في مدن أوروبية مختلفة، والفشل الذي واجهته تحركات العديد من القوى الإقليمية الفترة الماضية، وقد أدار الجميع عملية سياسية من دون أن إدارة أزمة تبحث عن حل عملي لها.
هناك الكثير من القرارات التي اتخذت والمواقف التي تشبث بها أصحابها لم تصمد أمام الاشتباكات المسلحة، وفي الوقت الذي كان معلوما فيه بالضرورة أن استمرار السلاح في أيدي الميليشيات يعطل التسوية ويقود إلى تجدد الحرب حتما لم يحرك المجتمع الدولي ساكنا لنزع هذا السلاح، ربما عمل البعض على تعطيل هذا الاتجاه بكل السبل، وكانت النتيجة أن هؤلاء قبلوا إجراء انتخابات قبل نزع السلاح، وهي إشارة على أن إجراء الانتخابات في حد ذاتها ليس حلا مفيدا.
ما يدور في طرابلس لا يمثل مفاجأة لمتابعي الأزمة الليبية، ويخطئ من يتصور أن اشتباكات الميليشيات حدثت ليأكل بعضها بعضا وحل جيد لإنهاء أزمة الدبيبة – باشاغا من خلال تفوق أحدهما أو انهيارهما معا، لأن طي هذه الصفحة وبدء صفحة جديدة لن يكون أفضل حالا ما لم يظهر المجتمع الدولي اهتماما مخلصا بالتسوية.
يخطئ أيضا من يعتقد أن الأزمة الأوكرانية وتداعياتها عطلت التسوية في ليبيا، لأن الأزمة الأخيرة سبقت ما يدور بين روسيا والغرب على أرض أوكرانيا بأكثر من عشر سنوات، بمعنى أن الحسابات لم تتغير بعد الحرب الروسية، فلا موسكو سحبت قوات “فاغنر” من ليبيا ولا الفريق المناهض لها قام بما يوحي بأنه سيخوض مواجهة معها ليتمكن من حل الأزمة في ليبيا، بل ترى بعض الأطراف الدولية أن التسخين في ليبيا أفضل وسيلة للدفاع عن المصالح.

يشير إخفاق الأمم المتحدة في تعيين مبعوث جديد خلفا للسفيرة ستيفاني ويليامز إلى جانب آخر من العجز الدولي الفاضح في التعامل مع الأزمة الليبية، فالخلافات على اسم المبعوث الجديد ليست هي الأزمة إنما السبب يكمن في الآلية العقيمة التي يتم التفكير بها والتعامل بها، والتي لا يريد أصحابها تسوية في الوقت الراهن للأزمة.
ولذلك بات عدم تعيين مبعوث حلا مرضيا لبعض القوى، كأن غيابه يمنح الضوء الأخضر لتجدد الصراع بين الميليشيات، حيث كان وجوده (شكلا) يمثل أحد الكوابح التي تمنع الإفراط في الصدام بين الجماعات المسلحة، وتدخلت ويليامز مرارا لتوفير الهدوء في طرابلس بتحركاتها بين الأطراف المختلفة لأنها أرادت الحفاظ على صورتها كدبلوماسية ماهرة تستطيع إطفاء الحرائق كما تستطيع إشعالها عندما تريد.
المثير أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الذي تم تحميله جزءا كبيرا من المعارك في ليبيا وتحول إلى ما يشبه “إله للعنف الدموي” نأى بنفسه عن حرب الدبيبة – باشاغا وأعلن عدم انحيازه لأي منهما، لأنه أحد المستفيدين من تناحرهما.
كأنّ الأطراف الدولية المعنية بالأزمة ترتاح لهذه الاشتباكات التي قد تعفيها من مسؤولية البحث عن تسوية
يخصم القتال بين المسلحين من رصيد الميليشيات العسكري ويستنزف الكثير من الأذرع التي مكنت من الحصول على مزايا مادية، ويضع المتصارعين السياسيين في موضع اتهام بأن كليهما يرأس ميليشيات خارجة عن القانون ولا يجب أن يرأس حكومة وطنية، ما ينطوي على إشارة ضمنية بعدم الصلاحية العسكرية والسياسية.
قد تتصور بعض القوى الدولية أن تهيئة الأجواء للاشتباكات يفجر برميلا جديدا للبارود في ليبيا قد يعفيها من الانخراط في البحث عن تسوية، غير أن النتيجة التي يمكن أن تحدث هي المزيد من حلقات الحرب التي توافرت لها ظروف في السابق أجبرت الجميع على الجلوس على طاولة المفاوضات، بينما الأوضاع الدولية حاليا يمكن أن تكون مهيأة لتوسيع رقعتها، وتصبح ليبيا جزءا من ارتدادات الأزمة الأوكرانية.