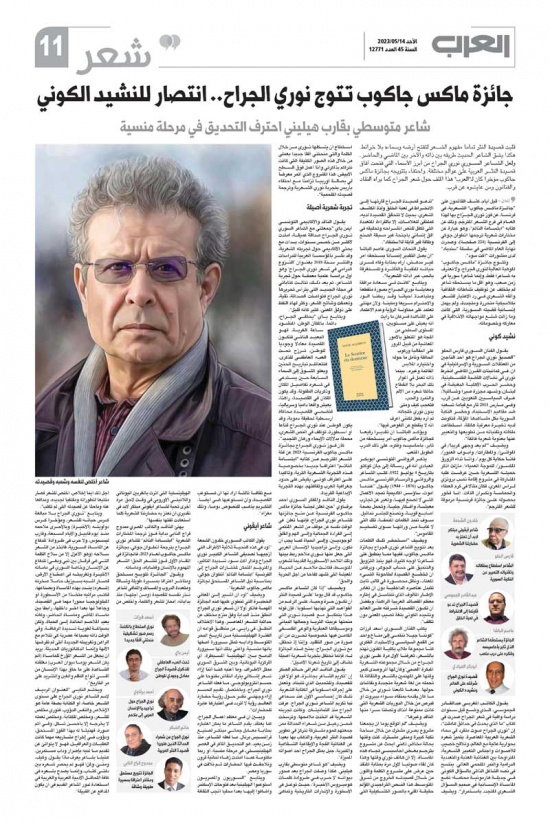الصحة النفسية ترف يغيب عن غالبية التونسيين

تنبئ الوضعية الحالية للخدمات النفسية في تونس بوجود مؤشرات فشل يجب معالجتها بصفة عاجلة، فالحصول على رعاية نفسية حاجة ماسة للمجتمع كما هو للأفراد، بسبب تداعياتها الخطيرة على الإنتاج الوطني.
تونس - صدمت حادثة انتحار طبيبة في مستشفى حكومي أثناء تأديتها لعملها بالفترة الصباحيّة المجتمع التونسي مؤخرا، في مؤشر على هشاشة الوضع النفسي للشباب، في بلد تعتبر فيه الرعاية الصحية النفسية في آخر سلم الاهتمامات.
وفتحت الحادثة الجدل حول الضغوط النفسية وتهميش الصحة النفسية حتى من قبل القطاعات الصحية نفسها، فقد ذكرت منظمة الأطباء الشبان، في بيان لها حول الحادثة، أن “الطبيبة المقيمة كانت قد قدّمت شهادة طبية من قبل طبيبها المباشر تستوجب راحة لمدة شهر وهو ما تم رفضه”، مشيرة إلى أن “رئيس القسم قام بتهديدها بعدم المصادقة على تدريبها، دون مراعاة لحالتها الصحية، وهو ما دفعها إلى الرجوع غصبًا عنها إلى العمل”.
وهذه الحادثة ليست سوى حالة من عدة حالات مسكوت عنها للمعاناة النفسية وتداعياتها على الشباب والعائلات وبالتالي المجتمع.
خدمات الصحة النفسية امتياز
يمثل الأشخاص الأكثر حرمانا على المستوى الاقتصادي – الاجتماعي الشريحة الأكثر تأثرا نفسيا. والكثيرون يجدون أنفسهم محرومين من الخدمات التي من المفروض أن توفّر لهم.
وعلى أرض الواقع يبقى الحصول على الخدمات الصحة النفسية بالنسبة إلى التونسيين غير متكافئ فهو امتيازا يتمتع به البعض وحق لا يمكن الحصول عليه للبعض الآخر. ضحايا هذا التمييز هم بالأساس الأشخاص الذين يعيشون الهشاشة أو من يلاحقهم شبحها.
وأكدت نتائج دراسة ميدانية أجرتها منظمة “إنترناشونال ألرت” حول الصحة النفسية للشباب في الأحياء الشعبية في تونس، أن 27 في المئة من الشباب أعمارهم بين 18 و29 سنة لديهم مشاكل نفسية، حيث تم تقييم حالاتهم النفسية بأنها سيئة أو سيئة جدًا.
وقدّم النتائج خبراء وأطباء متخصصون في الأمراض النفسية والعقلية بحضور ممثلين عن وزارتَي الصحة والشباب، وقالت ألفة لملوم مديرة مكتب “إنترناشيونال ألرت” في تونس إن “هذه الدراسة تُعَدّ الأولى في تونس لجهة المواضيع التي تمّ التركيز عليها، خصوصاً الصحة النفسية للشباب، وكذلك لجهة العدد والعيّنة التي اختيرت لتكون ممثّلة. فقد اختير 1250 شاباً من مختلف المستويات التعليمية ولديهم أنشطة متنوعة، بالإضافة إلى فئات مختلفة من الناشطين والعاطلين عن العمل والباحثين عن عمل. وثمّة أشخاص يتابعون دراستهم أو هم في التكوين المهني”.
8
متخصصين في علم النفس والاجتماع لكل مئة ألف تونسي ما يعني شحا شديدا في الكوادر المهنية
وأوضحت أن “نفس النسبة تقريبًا تفيد بأن هؤلاء الشباب يرغبون في العلاج النفسي”.
وأحدثت التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتتالية ضعفا في سوق العمل في تونس، ما أدى إلى ارتفاع معدّل البطالة وانتشار ظروف تشغيل ”هشة“.
وارتبطت البطالة وتهميش الوظائف بانعدام الأمن الاجتماعي لتقود إلى عدم الاستقرار الاجتماعي، والشعور بالغضب والامتعاض المترافقين مع الاحتقار، وجميعها أصبحت واضحة أكثر فأكثر لدى نسبة من المهمشين. ولهذه المعاناة الاجتماعية مجموعة من العواقب على الراحة النفسية للأفراد والمجموعات.
وتظهر عند الأشخاص الذين عاشوا أحداثا متعلقة بوضعيات بطالة أو فقدان أو صدمات قابلية أكبر للإصابة باضطرابات نفسية أو بمشاكل متعلقة بالإدمان. كذلك، يمكن لهذه الاضطرابات النفسية أن تحدث توقفا في الوظائف النفسية والاجتماعية بما يزيد في تدهور الحالة الاجتماعية والاقتصادية للشخص المصاب فضلاً عن الاضطراب النفسي في حد ذاته.
وتحمل صعوبات الحياة تأثيرات كارثية على الراحة النفسية للشعوب. وتؤكد المنظمة العالمية للصحة أن شخصا من بين خمسة أشخاص يعاني من الاكتئاب أو القلق، وقد سجلت تونس خسائر بقرابة 4.6 مليون دينار بسبب الإجازات الطويلة التي مصدرها مرتبط بأمراض نفسية تتطلب التوقف عن العمل.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن نسبة الإقبال على الحبوب المهدئة في تونس بلغت 15 في المئة كما أن المدمنين فيها يعودون إلى مراكز العلاج ثلاث مرات بعد شفائهم.
ضعف الموارد المالية والبشرية يمثل أول المؤشرات على الخلل الوظيفي من أجل إصلاح ناجع في خدمات الصحة النفسية
وتظهر بالتالي الحاجة إلى العلاج النفسي من أجل تحسين جودة حياة الأشخاص الذين يعيشون وضعيات أو أخطار الهشاشة والحد من الآثار التي يمكن أن تسببها هذه الأخطار من تأثير على المجتمع عموما.
وتمثل إمكانية الحصول على رعاية نفسية تمشيا لا بد منه للحد من المعاناة وأضرارها. ومن الضروري تقييم السياسات العمومية والآليات المعتمدة لديها لتحديثها بجعلها أكثر شمولية وانفتاحا للجميع وبالأخص لأولئك الأشخاص في أسفل السلم الاجتماعي.
وتنبئ الوضعية الحالية للخدمات النفسية بوجود مؤشرات فشل يجب معالجتها بصفة عاجلة. ومنح التشريع التونسي المتعلق بالصحة العقلية لسنة 1992 والمنقح سنة 2004 اهتماما خاصا بالظروف التي يعيشها مرضى مؤسسات الأمراض العقلية، وبالآليات الضرورية لمراقبة العلاجات المقدمة لهؤلاء لأشخاص بسبب الاضطرابات التي يعانون منها.
وكان هناك منذ البداية تركيز على الأوضاع التي تعتبر ”خطيرة“ من الاضطرابات العقلية وتم الاهتمام خصيصا بالمؤسسات النفسية على حساب هياكل أهلية أخرى.
لكن رغم ذلك لا توجد ميزانية مخصصة لخدمات الصحة العقلية، باستثناء ثلاثين ألف دولار تأتي من منظمة الصحة العالمية كل عامين لصالح تطبيق البرنامج الوطني للصحة العقلية والمنح التي تبلغ خمسين ألف دولار من ميزانية البرنامج الوطني للصحة العقلية والتي يمنح جزء هام منها لمستشفى العلاج النفسي، بالإضافة إلى المركزية الواضحة.
ويتم الحديث هنا عن ميزانية لا تتجاوز الواحد في المئة من ميزانية الصحة العمومية والتي يعتبر مستشفى الأمراض النفسية في القطاع العمومي المستفيد الأبرز منها.
ويؤدي ذلك إلى مشكلة تتعلق بتطور الخدمات الاجتماعية المؤهلة لالتقاط التنوع في الطلبات النفسية والاجتماعية على غرار المراكز التي توفر استشارات يومية مكونة من فرق متعددة الاختصاصات.
مشكلة متفاقمة

لا يقتصر النقص على مستوى الميزانية. إذ لا تعدّ البلاد سوى 16 وحدة عمومية متجولة للصحة العقلية و7 معدات مشتركة ومستشفى وحيدا للأمراض النفسية.
ويستفيد من هذه الخدمات أساسا الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الفصام واضطرابات المزاج والاضطرابات العصبية أو الجسدية.
ويحتدم هذا النقص في عدد المهنيين المتخصصين إذ هنالك حوالي 8 متخصصين لكل مئة ألف تونسي. وهذا الشح في المهنيين متفاقم بشكل خاص لدى العاملين النفسيين والاجتماعيين، أي علماء النفس والأخصائيين الاجتماعيين.
وهذا ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة، فنشاط هؤلاء يعتبر حاسما لضمان الرعاية النفسية للمهمشين وغير المستقرين اجتماعيا واقتصاديا.
ويمثل ضعف الموارد المالية والبشرية أول المؤشرات على الخلل الوظيفي والمسارات الأولى من أجل إصلاح ناجع. إذ أن تخصيص تونس 1 في المئة فقط من ميزانيتها للقطاع الصحي للصحة النفسية، يعني أن غالبية المصابين باضطرابات عقلية لا يتلقون العلاج المناسب والمستمر. وصحيح أن الضمان الاجتماعي وأنظمة التأمين المختلفة في تونس تغطي تكاليف الاستشارات الطبية والعلاجات بالأدوية، لكن مع ذلك لا تزال معاناة أولئك الموجودين على هامش الخدمات الاجتماعية والتشخيصية مستمرة.
ولا يخلو النظام التعليمي في تونس من ثغرات ونقائص واضحة طالت الصحّة النفسيّة للتلاميذ حيث أصبح التلميذ التونسي اليوم كثير القلق والتوتّر خاصة في غياب نظام تعليمي يضمن له الإبداع والتميّز وإطار تربوي غابت في البعض منه الأساليب البيداغوجيّة والقيم الأساسيّة فأصبحت المؤسسات التربويّة تعكس مجتمعا غير مستقر وغير متّزن عقليّا وهو ما على الدولة تفاديه باتخاذ تدابير فوريّة ومستمرّة، إذ أن التلميذ هو محور العمليّة التعليميّة والمكوّن الأساسي ومن دونه لا معنى لمثل هذه المؤسسات ولا لمهنة التعليم في حالة تهميش هذه الفئة والتعسّف على صحتها النفسيّة.
المتخصصون يحذرون من أن معدلات الاضطرابات النفسية المبلّغ عنها والعواقب الاقتصادية والاجتماعية والشخصية لسياسة اللامبالاة تجاه المعاناة النفسية للأشخاص الذين يعيشون الهشاشة تنذر بالخطر
ويمكن العمل على حلول تضمن ألاّ تكون الصحة النفسية مجرد ترف من خلال تغيير السياسات العامة وزيادة الاستثمار في الخدمات العامة ودعم الخدمات داخل القطاع الخاص وتدريب المهنيين بشكل مناسب.
وتؤكد الدراسات أن زيادة الاستثمار في قطاع الصحة النفسية من خلال تخصيص ميزانية لتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية أمر بالغ الأهمية.
كما أن التوزيع العادل للاعتمادات التي جرت العادة على تخصيص معظمها لخدمات الطب النفسي سيمكّن من تطبيق اللامركزية في المؤسسات ومن تأهيل الخدمات العامة والأهلية مع احتياجات الأشخاص الذين يعيشون الهشاشة أو المعرضين لخطرها.
ويؤدي ذلك إلى تسهيل الوصول إلى هذه الخدمات وتحسين ظروف المؤسسات الموجودة فضلاً عن جودة الخدمات المقدمة.
وتسمح الميزانية كذلك بدعم خدمات القطاع الخاص وتوفير تغطية اجتماعية لمن لا يتمتعون بها. ومضاعفة الميزانية وتوزيعها بطريقة عادلة منصفة بين المؤسسات المختلفة ستكونان خطوتين مهمتين في معالجة الخلل الحالي.
ومن المهم معالجة عدم التوازن بين التدخلات النفسية والاجتماعية والمعالجة الطبية للاضطرابات النفسية. إذ يجب أن يكون لدى المعنيين إمكانية الوصول إلى التدخلات النفسية والاجتماعية التي تهتم بالمجال الواسع للمعاناة النفسية.
ويجب كذلك تدريب أخصائيي هذا المجال من أجل فهم وتحليل ومن ثمة الاستجابة بشكل مناسب لمطالب المهمشين اجتماعيا واقتصاديا.
ويركز المتابعون على أن الحاجة ماسة في البداية إلى معالجة نقص العاملين النفسيين والاجتماعيين فهو يعوق المعالجة الناجعة لعدد مهم من الأشخاص المحتاجين.

ويتم سد هذا النقص من خلال التوظيف وتثمين المهن المعنية وإنشاء شبكات تعاونية بين المنظمات المهنية المختلفة. كما أنه، ولغاية دمج الصحة العقلية والاعتبارات النفسية والاجتماعية في خطة وطنية للاستجابة للأزمات في جميع القطاعات العامة والخاصة، فإنه من المفيد بشكل خاص إعادة تأهيل الروابط بين القطاع الاجتماعي وقطاع الطب النفسي. فاعتماد الطريقة المجتمعية وتفضيلها وإدماج الجانب النفسي في البرامج التربوية والتواصلية هو بديل يجب أخذه بعين الاعتبار بشكل حتمي.
وتستفيد الدولة من تطوير إستراتيجيات للمناصرة وللتواصل لمكافحة التضليل الإعلامي والوصم الاجتماعي والثقافي للمعاناة النفسية. لذلك يوصى المتخصّصون بالتعاون بين مختلف أعضاء الحكومة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والنقابات والمنظمات المهنية والطلابية من أجل تطوير إستراتيجيات للتواصل وإنشاء برامج تربوية وتوعوية لمسألة الصحة العقلية.
وتعتبر الصحة النفسية حجر الزاوية في صحة ورفاهية الأفراد والمجموعات والمجتمعات. ويحذر المتخصصون من أن معدلات الاضطرابات النفسية المبلّغ عنها والعواقب الاقتصادية والاجتماعية والشخصية لسياسة اللامبالاة تجاه المعاناة النفسية للأشخاص الذين يعيشون الهشاشة تنذر بالخطر.
وعلى السياسات العمومية أن تقلّل الفوارق بين المواطنين من أجل الوصول الشامل والمتاح بسهولة إلى الرعاية النفسية.
ولهذه السياسات فوائد على الاستثمار تفوق بكثير تكلفة تحسين قطاع الخدمات النفسية. فإنتاجية اليد العاملة وتحسين صحة المواطنين المستضعفين على مستويات مختلفة هو في الواقع مكسب هائل لمستقبل المجتمع.