الحضرانية تبشّر بعالم قانونه العنف

يشهد العالم ارتفاعا قياسيا في مستوى العنف الذي يتجسد في العمليات الإرهابية، التي يتبناها مناصرون لتنظيمات إسلامية متشددة، أو قوميون متعصبون يردون على تلك الهجمات بنفس الأسلوب الدموي والعنيف. ويشكل هذا النوع أقصى درجات العنف، الذي يستمد قوته من تطور نزعات قومية ودينية وحضارية لا تنفك تقوى في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، ووصلت هذه النزعات إلى ذروتها في ما بات يطلق عليه اسم “الحضرانية”، وهي وجهة اختيال وغرور حضاريّيْن تمارسهما بعض الشعوب والجماعات لتدلّل على تفوقها على غيرها من الحضارات.
واشنطن - في السنوات الأخيرة توسع الحديث عن أزمات الهوية الحضارية التي انعكست في تصاعد موجات التطرف، بشقيه الإسلامي والمعادي للإسلام، وظاهرة الشعبوية وتصاعد التوجه القومي المتطرف وعودة أفكار من قبيل تفوق البيض والنزعات القبلية، المؤيدة لفكرة انغلاق المجتمعات، حتى لا يتم “تدنيسها” بأفكار العولمة والهجرة والحدود المفتوحة، ما يعني موت التعددية الحضارية والثقافية وينذر بوضع أسس نظام عالمي قوامه العنف ويشكل أكبر تهديد للقيم الليبرالية.
تطورت هذه النزعات، التي تعد ترجمة لتصاعد العنف في المجتمعات وانعكاسا لأزمات اجتماعية داخلية وعالمية، بنسق أسرع من استيعاب المحللين والخبراء والسياسيين لها. وهي تتخذ أشكالا أكثر تطرّفا.
ولم يعد الأمر صراعا بين الحضارات، بل صار حربا عقائدية تسعى لتكريس تفوق حضاري، أحيانا تكون منطلقاته بسيطة كتأثر شاب يعاني نفسيا بتغريدة متطرفة على تويتر فيتحول إلى قاتل، وأحيانا أخرى تكون بأبعاد أكثر تطرفا في علاقة بأيديولوجيا سياسية أو دينية تبرر العنف والإرهاب والعداء للآخر.
ويطلق بعض الخبراء على هذه النزعة مصطلح “الحضرانية” (Civilisationalism) أو “الاختيال (التكبر) الحضاري، ويقصد به اعتداد بعض الشعوب والجماعات بانتماءاتها الحضارية وشعورها بأنها متفوقة على غيرها من الشعوب والحضارات.
ومن بين المحللين الذين استعملوا هذا المصطلح الباحث الأميركي جايمس دورسي، الذي تتركز أغلب أبحاثه على المجالات الاجتماعية من تأثير كرة القدم على الشعوب والسياسة إلى الإرهاب والتطرف وشؤون الشرق الأوسط.
في تحليله انتشار ثقافة العنف في مختلف المجتمعات، يلجأ دورسي إلى هذا المصطلح، الذي لم يحظ بعد بالانتشار على غوغل، الذي ما زال يخلط بين المصطلح الجديد الحضرانية Civilisationalism، وحضارة Civilisation. وهو مصطلح لم يتم بعد إيجاد مرادف عربي دقيق له.
تنعكس الثقافة الحضرانية اليوم في العمليات الإرهابية، التي تنسب إلى المتشددين المسلمين، أو العمليات التي يقوم بها قوميون متطرفون ومؤيدون لأفكار تفوّق البيض ومعادون للمسلمين، كما في تقدم الشعبويين في الانتخابات.
ويذهب دورسي إلى حد القول إنها انعكاس لصعود أنظمة تساوي بين المعارضة والخيانة، وتنظر إلى الصحافة المستقلة على أنها “عدو للشعب”. كما حالة الإحساس بالضياع التي يشعر بها المراهقون، وهي انعكاس لحالة ضياع يعيشها العالم بأسره، ضمن ظواهر تنتهي بتصاعد العنف والعنف المضاد.
ويضيف جايمس دورسي أن مصطلحات مثل الجهادية والتبشير وحتى النزعات المتشددة في الهندوسية والبوذية، هي انعكاس للنزعة الحضرانية. وتلعب هذه النزعة، عن قصد أو عن غير قصد، دورا هاما في إشعال نيران التطرف التي قد تؤدي إلى العنف السياسي.
مسائل الهوية

يقول صاحب نظرية نهاية التاريخ فرانسيس فوكوياما إن السياسة خلال القرن العشرين كانت في الغالب تحددها المسائل الاقتصادية. بيد أن السياسة اليوم تتحكم فيها مسائل الهوية أكثر مما تتحكم فيها المشاغل الاقتصادية.
ويوضح أن اليسار في الكثير من الدول لا يركز على خلق مساواة اقتصادية عريضة بقدر ما يركز على خدمة مصالح تشكيلة عريضة من المجموعات المهمّشة مثل الأقليات والمهاجرين واللاجئين. في الأثناء، يعيد اليمين، المتطرف خاصة، تحديد مهمته الأساسية لتصبح حماية الهوية الوطنية التقليدية التي كثيرا ما ترتبط بشكل صريح بالعرق والإثنية والدين، وبخطاب يشتد تطرفا يوما بعد يوم.
وتتعدد النماذج التي تعكس هذه النزعة. يشكل الشعبويون في شمال وغرب أوروبا مجموعة مميزة داخل دول شمال الأطلسي وأوروبا.
تتميز هذه المجموعات بتوسيع التناقض بين الذات والآخر من المستوى الوطني الضيق إلى الجانب الحضاري الأوسع. وكان التحول الجزئي من القومية إلى الحضرانية في الدول الغربية مدفوعا بفكرة التهديد الإسلامي للشعوب الغربية.
وفي العالم الإسلامي لا يختلف الوضع، وإن كان أقدم زمنيا، حيث يشير الخبراء إلى الجماعات المتشددة، مثل القاعدة، كنموذج أولي للنزعة الحضرانية، التي تتجسد اليوم في أكثر أمثلتها تطرفا في تنظيم داعش. ويرتكز خطاب هذه الجماعات على فكرة “خير أمة أخرجت للناس” لتبرير العنف والإرهاب ومعاداة الآخر.
وأظهرت دراسة حديثة حول مقاتلي داعش الأجانب، خاصة السعوديين، في سوريا أن نزعة الشعور بالتفوق الحضاري المرتبط بالدين، كانت محركهم الرئيسي. ولكونهم أصبحوا نتاجا لنظام تعليمي كان يروج منذ زمن طويل للفكر الإسلامي السني المحافظ، كان الكثير منهم مدفوعا بمخاوف طائفية.
وبالنظر إلى أن العمود الفقري الأخلاقي للمجتمعات يتجذر دائما في القيم التي يروج لها الدين، غالبا ما يوفر الدين إطارا حضاريا مناسبا لتبرير العنف.
ويرى دورسي أن الهجمات الأخيرة على المساجد في نيوزيلندا والكنائس والفنادق الفخمة في سريلانكا والمعابد اليهودية في الولايات المتحدة والعديد من الحوادث الأخرى في جميع أنحاء العالم تدل على أن الأيديولوجيات الحضرانية عملت على تعزيز التفوق والتفرد وإقصاء المجموعات الأكثر ضعفا في المجتمع. كما تستفيد الحضرانية من الاستبداد والحكم المطلق.
ووفق جايمس دورسي، يخلق كل هذا أساسا لإجماع غير معلن على قيم تميل إلى العنف من شأنها ضمان نظام عالمي جديد يشكل أرضية تجمع بين شخصيات مثل شي جين بينغ و فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان و فيكتور أوربان ودونالد ترامب.
ويضيف دورسي أن الحضرانية تعتمد في الكثير من الأحيان على الأساطير التي جاءت من تزوير وإعادة كتابة التاريخ لخدمة غرض استبدادي خبيث. ويصور رجال مثل ترامب وأوربان وأردوغان أنفسهم كأبطال قوميين يحمون الأمة من قوم غزاة.
في بيانه بدا برينتون تارانت، مرتكب هجمات كرايستشيرش، مصدقا لفكرة الغزاة المسلمين الذين وصفهم بأكبر مجموعة غزاة محتقرة ومكروهة في الغرب، مؤكدا أن مهاجمتهم ستلقى أكبر مستوى من الدعم. وقال “الغزاة موجودون في جميع أراضينا، وحتى في أبعد مناطق العالم. لم يعد هناك أي مكان آمن وخال من الهجرة الجماعية”.
أعمال العنف
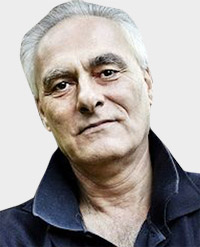
يميل مرتكبو العنف، بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية أو الطبقة الاقتصادية، إلى أن يكونوا أشخاصا مراقبين. في الكثير من الأحيان هم أكثر عرضة للتأثر بالشخصيات الكاريزمية، ويكافحون من أجل التعامل مع مشكلاتهم الشخصية ويسعون دائما لملء الفراغ في حياتهم. وهم نتاج مجموعة تعزلهم بشكل متزايد عن المجتمع وتقنعهم بأن هناك تهديدا مستمرا يأتي من جانب أحد قطاعات المجتمع.
ويؤكد دورسي أن ما يثبت أعمال العنف السياسي، التي حدثت مؤخرا وقبل فترة طويلة، هو أن النيران التي تشعلها أيديولوجيا التفوق الحضاري في أغلب الأحيان لا تحدث عواقبها إلا في الداخل بدلا من أن تلتهم الجانب الآخر من العالم كما كان مخططا له. تعمل هذه النيران على تغذية سياسات الخوف، وتخلق حالات احتقان بين الطوائف والديانات داخل نفس المجتمع، وتعطل وضع سياسات شاملة من شأنها أن تقلل إلى حد كبير من خطر العنف.
يلاحظ عالم الأنثروبولوجيا سكوت أتران، والصحافي جيسون بيرك، أن ظاهرة انضمام المقاتلين الأجانب إلى صراعات بعيدة عن مواطنهم الأصلية لا تتناقض مع حقيقة أن أعمال العنف السياسي تم تنفيذها إما من قبل أشخاص عاديين محليين أو من قبل متشددين محليين.
وتم تحريض البعض منهم من قبل مجندين كانوا مع ذلك يعتمدون على السكان المحليين الأكثر تأثرا بأيديولوجيتهم المتحضرة. وتنعكس النزعة الحضرانية هذه على الأفراد الذين يرتكبون جرائم غير سياسية مثل إطلاق النار على جموع الناس والذين غالبا ما يكونون من الأشخاص المضطربين الذين يعانون من مشاكل شخصية.
حقيقة أن العنف المدني والسياسي اللذين تنتج عنهما مجموعة من الأشخاص الإرهابيين المضطربين، تشكك في الجهود المبذولة لمنع الحوادث التي تركز بشكل شبه حصري إما على المفاهيم الحضارية التي تهمش الجماعات من خلال الصور النمطية وغيرها من التقنيات، وإما على إجراءات التجريم والأمن.
فكرة قوية

الهوية هي “فكرة أخلاقية قوية” حسب تعبير الفيلسوف شارلز تايلر، فيما يقول فوكياما إن السياسة اليوم تتحكم فيها مسائل الهوية والتفوق الحضاري أكثر مما تتحكم فيها المشاغل الاقتصادية؛ ويتفق جايمس دورسي مع هذه الأفكار بقوله إن العنف المتصاعد هو مسألة تتعلق بالأمن وتتعلق أيضا بإحساس عام بالضياع والفراغ، وهي حالة تختلف من مجتمع إلى آخر ومن شخص إلى آخر.
كما أنه يدعو إلى آليات توفر الإنذارات المبكرة، وتمنع الأفراد من الانهيار، وتقدم لهم المساعدة التي يحتاجون إليها للتعامل مع مشاكلهم الشخصية وتظلماتهم وأوقات فراغهم.
ويفسر دورسي هذه النقطة انطلاقا من حادثتين منفصلتين، وقعتا في أكتوبر 2014.
الحادثة الأولى تتعلق بجايلين فرايبيرغ، الطالب الذي أطلق النار على زملائه خلال الغداء في مدرسة ثانوية بالقرب من مدينة سياتل الأميركية. كان فرايبيرغ رياضيا محبوبا، وقبل فترة وجيزة من الحادثة أُطلق عليه لقب “الأمير” في مدرسته.
لكنه لم يعد قادرا على شرح ما دفعه إلى إطلاق النار على زملائه الطلاب وعلى نفسه. إلا أن التحقيقات اللاحقة التي أجرتها الشرطة أشارت إلى أنه كان غاضبا لأن فتاة رفضته واختارت ابن عمه بدلا عنه. وعلى النقيض من ذلك، فإن مايكل زحاف – بيبو، البالغ من العمر 32 عاما والذي اعتنق الإسلام، قتل حارسا في النصب التذكاري الوطني في أوتاوا ثم اقتحم البرلمان الكندي، كانت لديه كل مظاهر الاضطراب في شخصيته.
فقد ذكرت وسائل الإعلام الكندية أن زحاف – بيبو كان يعاني من اضطراب عقلي وكان له سجل إجرامي شمل حيازة المخدرات والسرقة وممارسة التهديد. كان مدمنا على الكوكايين وقضى الأسابيع الأخيرة من حياته في ملجأ بلا مأوى.
ونقلت صحيفة “غلوب آند ميل” عن صديقه، ديف باثورست، أن زحاف – بيبو كان دائما يقول له إن الشيطان كان دائما يتبعه. يقول باثورست “أعتقد أنه يجب أن يكون مصابا بمرض عقلي”.
تثير الحادثتان مسألة الفرق بين إطلاق النار في مدرسة وبين الهجوم الإرهابي ذي الدوافع السياسية في ما يتعلق بكيفية قيام المجتمعات بتبني إجراءات لمنع انتشار العنف.
وتشير الحالات إلى أن مشاركة المجتمع -بالإضافة إلى توفير الخدمات النفسية والاجتماعية- قد تكون بنفس أهمية الأمن وإنفاذ القانون. أصدر كل من فرايبيرغ وزحاف – بيبو، كل بطريقته الخاصة، صيحات استنجاد طلبا للمساعدة. وفي منشور له على تويتر، حذر فرايبيرغ الفتاة التي رفضته من أن تتركه. وربما كان باثورست، صديق زحاف – بيبو الذي اعتنق الإسلام، هو الشخص الوحيد الذي بدا أن زحاف – بيبو يثق به.
ووصف كيف كان يشعر دائما بأنه يتعرض للاضطهاد من قبل الشيطان. وتعمق إحساس زحاف – بيبو بالعزلة عندما طلب منه المسجد الذي كان يذهب إليه هو وباثورست عدم المجيء إلى الصلاة مرة أخرى بسبب سلوكه الشاذ.
تشير حادثتا فرايبيرغ وزحاف – بيبو، من ناحية، إلى ضرورة وضع سياسات وأدوات تسمح للمجتمع بالتدخل قبل أن يلجأ أفراد مثلهما إلى العنف.
ومن ناحية أخرى، تسلط الحادثتان الضوء على التهديد الذي تشكله الأيديولوجيا الحضرانية، بغض النظر عن منطلقاتها الدينية أو القومية أو الهوياتية والنفسية.
تشير كلتا الحالتين -إلى جانب الهجمات في نيوزيلندا وسريلانكا والولايات المتحدة- إلى أن صعود معتنقي الفكر المتحضر -سواء كانوا يتقلدون المناصب الرفيعة أو يشكلون مجموعات اجتماعية وسياسية- يخلق عالما يكون فيه العنف هو الوضع الطبيعي الجديد.
ويكمن الإشكال في أن معاقل الليبرالية -مثل الولايات المتحدة ومعظم أوروبا- هي اليوم تشكل جزءا من المشكلة.


























