التطبيع مع الضحالة
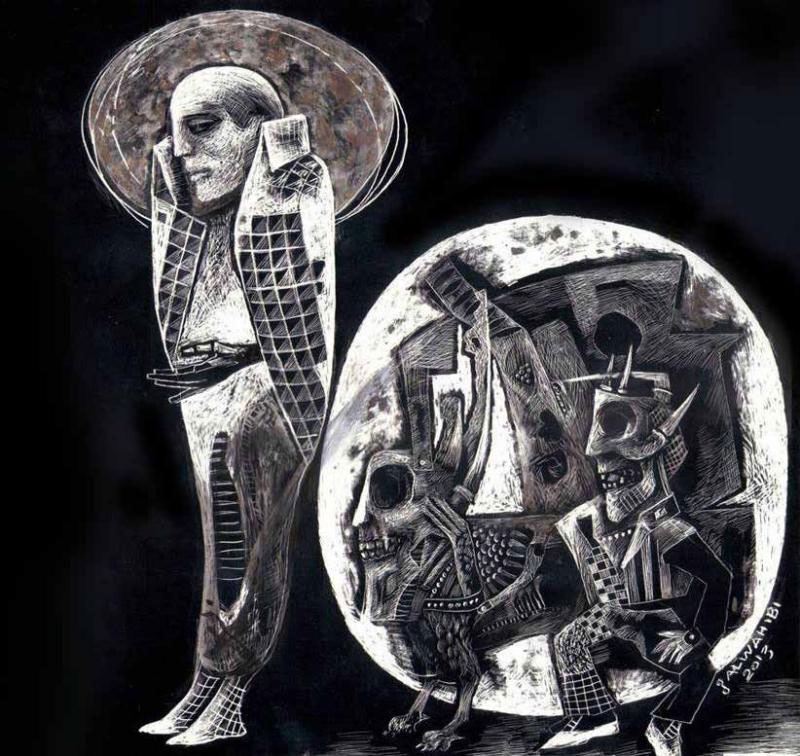
مثلما كان متوقّعا، أثارت مقالتنا السابقة ردود أفعال كثيرة، بعضها جاء تأييدا لما ذهبنا إليه من أن هذه الهجمة على اللغة العربية في تونس ليست مجانية، وأن مساعي الإساءة إليها تزداد يوما بعد يوم، بأوجه متعددة، ووسائل شتى، وتنزع عنها صفة العفوية. وبعضها الآخر كان احتجاجا على موقفنا من المنشورات الصادرة بالعامية، وانتقادا لما اعتبروه مصادرة لحق المبدعين في اختيار اللغة التي يريدون التعبير بواسطتها. بل إن ثمة من رأى في الدفاع عن اللغة العربية وعروبة تونس “موقفا أيديولوجيا هو إلى السلفية الإسلاموية أقرب”.
لا جدال أن اللغة العربية في تونس اليوم يصحّ فيها قول حافظ إبراهيم “سرَت لَوثةُ الإفرنج فيها كما سَرى/ لُعَابُ الأفاعي في مَسيل فُراتِ// فجاءت كثَوبٍ ضَمّ سبعين رُقعة/ مُشَكَّلَةَ الألـوانِ مُختلفاتِ”، وهو وضع لا ينكره إلا عنيد مكابر، أو معادٍ ساخر، أو فاقد وعيٍ سادر، فقد غدت اللغة العربية عندنا كالثوب المقدَّد، يمزق الطّعانُ أوصالَه من كل جانب.
من المؤسسة التربوية أولا، وقد شاهدنا وزير التربية يردّ على نائبة بكلام عامي مخلوط بالفرنسية، ووجدنا من المدرسين من يدعو صراحة إلى الاستعاضة عن الفصحى بالعامية في مخاطبة التلاميذ، لأنهم ما عادوا يفهمون ما يُلقى عليهم ولا ما يُطلب منهم، ولنا أن نتخيل كيف نشرح “سدّ” المسعدي أو “رسالة الغفران” أو “شحّاذ” محفوظ بالعامية، أو نفسّر الفكر الفلسفي ومصطلحاته باللسان الدارج، اللهم إلا إذا عوّلنا على مترجم مذكرات الشابي بالدارجة.
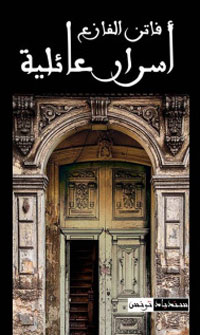
ومن لفيف من الفرنكفونيين ثانيا، يعتبرون أن الأدب لا هوية له، وأنه يمكن أن يصاغ بأي لغة، وأن الوقت حان كي نتخذ العامية لغة وطنية بدعوى أنها اللغة الأم التي نتعلمها في المهد.
وقد عدّوا ما نشر بالعامية من “روايات” جرأة يشجعون أصحابها عليها، وتناسوا أن اللهجات لو كانت قادرة على صياغة أدب راق لاستعملت شعوب الهند وأميركا اللاتينية وأفريقيا السوداء لهجاتها، بدل لغة المستعمِر القديم، فالقلة القليلة التي استعملت السواحلية، كما في كينيا وتنزانيا، أو الأمهرية كما في إثيوبيا، أو اليوروبا كما في نيجيريا، لم تتخط مؤلفاتها الحدود، إذ لم يبرز من كتاب تلك البلدان إلا من اتخذ الإنكليزية لغة كتابة.
ولم نعرف من أدب أميركا اللاتينية إلا ما كتب بالبرتغالية أو الإسبانية، رغم أن الغوارانية لغة رسمية في البراغواي مثلا، إلى جانب الإسبانية. تلك الشعوب، بخلاف العرب، لا تملك تراثا مكتوبا، إلا ما ندر، ولا لغة تؤلف بينها، ما دفعها إلى اعتناق لغة المستعمِر.
ومن الكتّاب أنفسهم ثالثا، وقد وجدنا منهم من يعتبر اللغة العربية لغة مدارس، وكأن الفرنسية وحيٌ من السماء، ويعترف بأنه يدافع عن “تونسية اللغة العربية، لأنها قضية حضارية، لا عن عروبة تونس التي هي موضوع صراع سياسي غير ذي جدوى، يفرّق من حيث توهم أنه يوحّد”، ويدعو إلى الاعتراف لكل مبدع بإبداعه مهما كانت اللغة التي بها يكتب، لأن السّموّ بالناس في رأيه يكون بمستوى الفكرة وأناقة التعبير.
ولا يمر بالضرورة بأداة التعبير في حد ذاتها. وهذا قد ينطبق على الفنون التي تعتمد على الحوار كالسيناريو والمسرحيات والأغاني كما أسلفنا، ولكنه لا يمكن أن ينسحب على لغة السارد في القصة والرواية. لأن العبارة محدودة، محصورة في فضائها الجغرافي، وقد يحتاج واضعها إلى ملحق -بالفصحى- لشرح المقصود داخل البلد الواحد، فما البال بالبلدان الأخرى ولو كانت مغاربية، لتباين اللهجات.
وأما الفكرة فهي في متناول الناس جميعا، ولا يمكن لأحد أن يفاضل بفكرته غيره ولا أن يضفي عليها براءة اختراع. ولنا في ما قاله الجاحظ خير دليل. عندما علم أن أبا عمرو الشيباني استحسن بيتين من الشعر لمعناهما، مع سوء العبارة التي تصوّرهما، قال “ذهب الشيخ إلى استحسان المعنى، والمعاني مطروحة في الطريق، يعرفها العجمي والعربي، والبدوي والقروي، وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخيُّر اللفظ، وسهولة المخرج وكثرة الماء، وفي صحّة الطبع، وجَودة السبك، فإنما الشّعرُ صياغة، وضَربٌ من التصوير”.
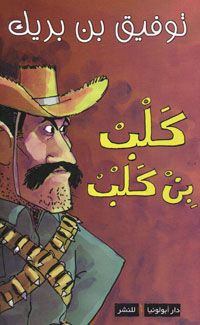
وكان الجاحظ قد بين أن البلاغة والجمال، إنما يرجعان إلى اللفظ، لأن المعنى الشريف قد يؤدّى باللفظ الرديء، إذ يقول “ومن الدليل على أن مدار البلاغة على تحسين اللفظ، أن الخطب الرائعة، والأشعار الرائقة، ما عملت لإفهام المعاني فقط، لأن الرديء من اللفظ يقوم مقام الجيّد منها في الأفهام”.
قد تكون الثيمات التي تناولتها الكتب المنشورة بالعامية كشفا عن المسكوت عنه، وتصويرا للأدواء التي تنهش جسد المجتمع، ولكن صياغتها بالعامية لم ترق بها إلى جماليات الفصحى، بل انحدرت إلى الأداء العاميّ. حسبنا أن نقرأ هذه الفقرة من رواية “أسرار عائلية” التي يعاد طبعها للمرة الثالثة “كي ريتهم حسيت اللي الحب ينجّم يكون زوز كراسي ملوّحة في بحر، غزرة بعينين تلمع، مشية تحت الشتاء، مشموم يتهدى، كعبتين فريكاسي في كرهبة، فرّاشية وقرطاس قلوب، بوسة مسروقة في زنقة. عندو الحق فريد الأطرش كي قال الحياة حلوة بس نفهمها”.
إن الكتابة بالعامية في تونس ليست جديدة، فـ”حركات” لمصطفى الفارسي، و”زهرة الصبّار” لعلياء التابعي تحويان فصولا بالعامية، بل إن “لوز عشّاق” المكتوبة بالدارجة لمحمود بلعيد فازت بإحدى جوائز كومار، ولكنها لم تشكل ظاهرة على غرار ما نشهده اليوم من أعمال تسعى إلى “التطبيع مع الضحالة” بعبارة عامر بوعزة، وتنخرط في عملية تدمير ممنهجة للغة العربية.
وليس ذنب العربية إذا صار أهلها لا يتقنونها في هذا الواقع الذي استشرت فيه الرداءة، كي ندير لها الظهر ونكتب بالعامية، ولنا أن نتصور علاقة الأجيال القادمة بالتراث لو ننشئها على تعلم اللهجات وحدها. فالفرنسيون، الذين ما انفكوا يشجعون سكان المغرب العربي على إقرار العامية، نادمون على ترك اللاتينية، بعد أن لاحظوا تدني مستوى الطلبة، وتعذر الوصول إلى الكتب التراثية، فضلا عن أن الأوروبيين اللاتينيين صاروا يضطرون إلى التخاطب بالإنكليزية في الغالب عند حلولهم بهذا البلد أو ذاك.
أما عن الأطراف التي تغذي هذه الظاهرة، فليس شرطا أن نتلقى منها دعما مباشرا كي نلتحق بالركب. يكفي أن يفتح أحد المستفيدين الباب، وهي اليوم أبواب مُشرَعة في عدد من القنوات الخاصة، كي ينساق آخرون، عن وعي أو غير وعي، كما تنساق الحبوب إلى طاحونة.
مرة أخرى، نؤكد أن اختيار الكتابة بالعامية ليس بريئا. ولا نستغرب أن تكلل تلك النصوص بجوائز مالية هامة، كما حدث في مصر حيث أسندت جائزة سويريس لرواية هزيلة بالعامية، قد تغري المنحرفين والمهربين وذوي السوابق من الجنسين بسرد حكاياتهم بالدارجة، وربما يكونون أكثر صدقا من الهذيان المتفشّي اليوم. على الأقل هم أصحاب تجربة.




























