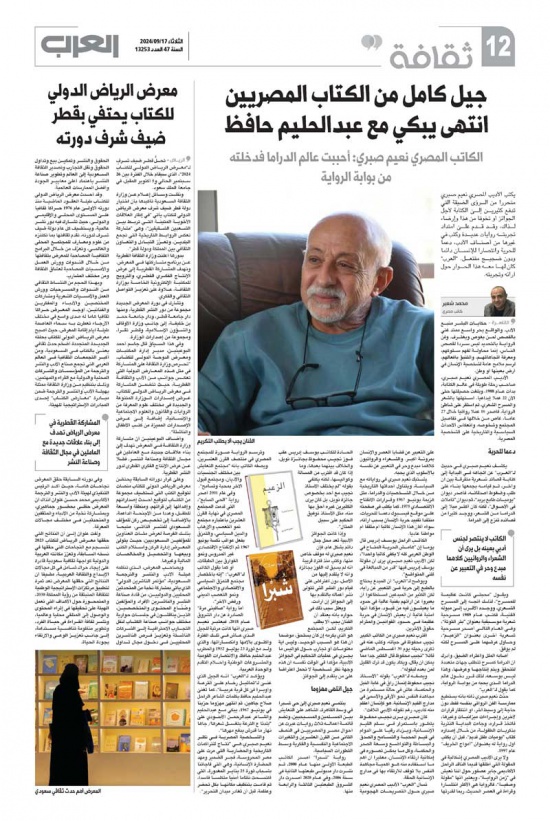الانتقال من الإبتدائي إلى الإعدادي: مرحلة صعبة نفسيا ودراسيا

يدعو خبراء التربية والمختصون في علم النفس بتونس إلى ضرورة توفير المراقبة، والإحاطة النفسية لطلاب المراحل النهائية، مشيرين إلى أن تحولات في التركيبة النفسية والفيزيولوجية لهؤلاء الطلاب ترافق نقلتهم النوعية إلى المستوى الدراسي التالي. ويرى الخبراء أن طلاب الإعدادي (المتوسط) ينتقلون من فضاء ضيق إلى فضاء رحب يحتم عليهم الاندماج والتأقلم سريعا ودون أي تمهيدات مع مرحلة دراسية جديدة.
تونس - يغادر الطلاب المرتقون إلى السنة السابعة من التعليم الأساسي مدارسهم الابتدائية الأصلية للالتحاق بالمدارس الإعدادية، حيث يواصلون مسارهم الدراسي في تجربة جديدة ومليئة بالمتغيرات، وهو ما يجعل العودة المدرسية بالنسبة لهم “استثنائية وخاصة” على عديد الأصعدة.
ولاحظ مختصون في علوم الاجتماع والتربية أن طلاب السنة السابعة أساسيا يعيشون بولوجهم لأول مرة إلى المدارس الإعدادية نقلة نوعية على المستوى الدراسي، ترافقها تحولات في التركيبة النفسية والفيزيولوجية خلال هذه المرحلة العمرية، موصين بضرورة تلقيهم لإحاطة خاصة ومرافقة لمساعدتهم على الاندماج في أفضل الظروف وتأمين انتقال “سلس” من الابتدائي إلى الإعدادي.
وقال الخبير في التربية رؤوف حمدي إن “طالب السنة السابعة أساسيا البالغ من العمر 12 سنة يجد نفسه مدعوا إلى الاندماج والتأقلم سريعا ودون أي تمهيدات مع مرحلة دراسية جديدة ومختلفة تماما من حيث الشكل والمضمون” عن سنوات التعليم الابتدائي، موضحا أن الطالب في سنته الأولى بالمرحلة الإعدادية ينتقل من فضاء “ضيق إلى فضاء أرحب”، حسب توصيفه، ويكتشف، في مقارنة بمدرسته الابتدائية، أن عدد الفصول والمدرسين تضاعف بالمؤسسة التربوية الجديدة وأنها لم تعد مكونة من قاعات تدريس عادية فحسب بل من مخابر بحثية وأقسام علوم تجريبية وفيزيائية وغيرها.
ويدرس طلاب التعليم الابتدائي (مرحلة العموميات) المواد ضمن مجالات تنشئة وعلوم ولغات، بينما تدرس المواد في مرحلة الإعدادي (مرحلة التفاصيل والتوسعة) في شكل اختصاصات محددة يؤمنها أساتذة بالضرورة مختصون بها، ويتدرب طلاب الابتدائي على التفكير المحسوس بينما يتم الاعتماد أساسا على التفكير المجرد خلال مرحلة الإعدادي، وفق تفسير الخبير ذاته.
الطلاب، يعيشون في المراحل التعليمية الانتقالية اضطرابات نفسية وسلوكية تؤدي أحيانا إلى الانقطاع المدرسي لإحساسهم بالخوف من مراحل جديدة
ولتأمين عملية اندماج هؤلاء الطلاب بشكل سلس، أوصى الخبير بتخصيص يوم أو يومين مفتوحين لاستقبالهم وتمكينهم من التعرف على مختلف أقسام وفضاءات المؤسسة، والاطلاع على نظامها الداخلي ونظامها التأديبي، وأخذ فكرة عن طبيعة التوقيت الزمني والأساتذة والمواد المدروسة.
واعتبر أن اطلاع الطلاب على مختلف هذه التراتيب يعد حقا من حقوقهم، مبرزا أهمية تشريكهم في ضبط النظام الداخلي للمؤسسة بطريقة تراعي مصلحتهم الفضلى وإكراهات الحياة اليومية الخاصة بكل جهة من جهات البلاد على غرار مسألة صعوبة التنقل في بعض الجهات الداخلية، وفسح المجال لهم لإبداء آرائهم والاستماع إلى مشاغلهم قبيل مفتتح السنة الدراسية.
ودعا الباحث في علم النفس أحمد الأبيض، إلى ضرورة أن يتفهم الأولياء والمربون هؤلاء الطلاب خلال هذه المرحلة الانتقالية في مسارهم التعليمي لتزامنها مع بداية فترة المراهقة، مبينا أن الطفل يعيش انطلاقا من سن 12 عاما على وقع تغيرات فيزيولوجية وجسدية واضطرابات هرمونية ونفسية، قد يقابلها بالرفض في بعض الأحيان فتجتاحه نوبات انعزال وقلق وتوتر، مما يتطلب رعاية نفسية خاصة لتفادي تأثيراتها على مردوده الدراسي.
وينتج عن هذه الاضطرابات تغير في السلوك كالنزوع إلى الخروج عن سيطرة رموز السلطة (أولياء ومربون..) باعتماد الصد والرفض والعناد، قائلا إن “كل هذه التصرفات هي عبارة عن وسائل دفاع يستعملها المراهق لإثبات الذات وفرض الوجود ولفت الانتباه”.
وأوصى المختص بأهمية توفير الإحاطة الخاصة بالطلاب في هذا السن ليس على المستوى التعليمي فقط وإنما على المستوى النفسي أيضا، لمساعدتهم على التأقلم في الوسط التربوي عموما والاندماج في مؤسساتهم التعليمية الجديدة وتجاوز كل الصعوبات التي قد تعترضهم.
المؤسسات التربويّ أصبحت ة تعكس مجتمعا غير مستقر وغير متّزن عقليّا وهو ما على الدولة تفاديه باتخاذ تدابير فوريّة ومستمرّة في الزمن
وقال الأبيض لـ”العرب” إن طلاب المراحل النهائية يواجهون معضلة الامتحانات الوطنية والمناظرات التي تمثل عقبة بالنسبة لهم وهي مسألة مضخمة في الوعي الجمعي تنتقل إلى التلميذ آليا، وخصوصا مناظرة الالتحاق بالإعداديات النموذجية، وهذا يزيد من قلق الطالب الذي تسعى عائلته لأن يكون متميزا.
وأشار الأبيض إلى أن الآباء والأمهات في الغالب يتصورون أنهم بتوفير مستلزمات الدراسة قد أدوا واجبهم تجاه أبنائهم وأن دورهم قد انتهى.
وحث المختص في علم النفس أولياء أمور الطلاب على أن يقوموا بدور المرافق لأبنائهم، ويساعدونهم على الاندماج مع ما تتطلبه المرحلة الجديدة والتقليل من تهويل المناظرة (لا نريد منك إلا ما أنت قادر عليه) والابتعاد عن المقارنة مع بقية زملائه.
ويعيش الطلاب، عادة، في المراحل التعليمية الانتقالية بين مرحلتي الابتدائي والإعدادي ومرحلتي الإعدادي والثانوي اضطرابات نفسية وسلوكية قد تؤدي أحيانا إلى الانقطاع المدرسي لإحساسهم بالخوف من مراحل جديدة دون التحضير لها مسبقا، حسب ما أفاد به الأخصائي النفسي، طارق السعيدي.
ولاحظ السعيدي أن المراحل التعليمية الانتقالية تتسّم بأكبر نسب من الانقطاع المدرسي، موضّحا في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن المراحل التعليمية المعنية تشمل الانتقال من السادسة ابتدائيا إلى السابعة أساسيا ومن التاسعة أساسيا إلى الأولى ثانويا.
واعتبر أن المرحلة العمرية لهؤلاء الطلاب تتسم بالهشاشة النفسية فهي إما أنها تسبق مرحلة المراهقة أو صلبها وتصاحبها تغيرات نفسية وفيزيولوجية.
ولفت إلى أن مجموعة من الطلاب يعيشون أثناء هذه المراحل التعليمية الانتقالية اضطرابات في التأقلم قد تؤدي في حال عدم احتوائها إلى اضطرابات في المزاج مثل الاكتئاب والقلق.
ودعا إلى الإعداد النفسي والذهني للطلاب لتهيئتهم للمراحل الجديدة وحسن الانتقال إليها من خلال الإنصات إليهم عند الحديث عن مشاعرهم وأحاسيسهم ومخاوفهم من المرحلة المقبلة على أن يتولى المربون والأولياء هذه المهمة.

كما أصبحت المؤسسات التربويّة تعكس مجتمعا غير مستقر وغير متّزن عقليّا وهو ما على الدولة تفاديه باتخاذ تدابير فوريّة ومستمرّة في الزمن، ذلك أن التلميذ هو محور العمليّة التعليميّة والمكوّن الأساسي ومن دونه لا معنى لمثل هذه المؤسسات ولا لمهنة التعليم في حالة تهميشه والتعسّف على صحته النفسيّة. ويرى خبراء التربية أن النظام التعليمي في تونس لا يخلو من ثغرات ونقائص واضحة طالت الصحّة النفسيّة للطلاب حيث أصبح الطالب التونسي اليوم كثير القلق والتوتّر خاصة في غياب نظام تعليمي يضمن له الإبداع والتميّز وفي وجود إطار تربوي غابت في البعض منه الأساليب البيداغوجيّة والقيم الأساسيّة.
ويشكو قطاع التعليم، اليوم، كغيره من القطاعات من عدم الاستقرار، ويظهر ذلك من خلال فشل محاولات إصلاح الأنظمة التعليمية والبرامج، وكثرة الإضرابات من الأساتذة والقيميين، وهو ما أثر وبشكل كبير على نفسيّة التلاميذ ودافعيّتهم للتعلّم. ومما زاد في تفاقم الأوضاع بروز الأزمة الصحيّة التي رافقت جائحة كوفيد، والذي جعل نسبة المشاكل النفسيّة في تزايد مستمر وخاصة أن الجائحة لها آثار نفسيّة طويلة المدى.
وبحسب الخبراء، ينبغي أن يكون التعليم تجربة تتسم بالبهجة وهو ما تؤكده مقولة “علّم الأطفال وهم يلعبون” أي أنه من الضروري أن يحب الطلاب طلب العلم ولا فقط الاقتصار على الدراسة وقت الامتحانات بل يتجاوز التعلم كونه غاية في حدّ ذاته فقط ليصبح وسيلة لبناء شخصيّة فعالة في المجتمع.
وللوصول إلى هذا الهدف يجب اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى وطني فالمعلم أو الأستاذ بمفرده لن يغيّر منظومة بأكملها على الرغم من وجود تجارب إيجابيّة لبعض الأساتذة والمعلّمين، لكنها تبقى محدودة نظرا لغياب خطة وطنيّة شاملة وهو ما فاقم الحاجة إلى تعميم هذه التجارب الإصلاحيّة على كامل البلاد.