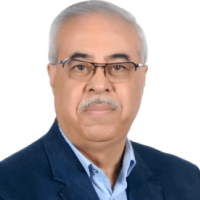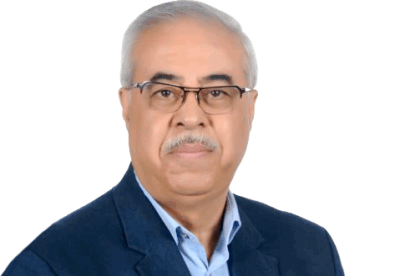الأطباء يعكفون على علاج عباس، لكن من يعالج القضية الفلسطينية

وصل الجمود في النظام السياسي الفلسطيني إلى حد أن أزمته باتت مرتبطة بشخصية الرئيس محمود عباس، بسنّه وصحّته، ما يعني افتقاد هذا النظام لآليات التجديد، وللحركات الداخلية، وللحياة المؤسسية والتشريعية والديمقراطية، علما أن الحديث يدور هنا عن حركة سياسية، هي الأطول بين مثيلاتها العربية، أي عن حركة سياسية ذات تجربة طويلة ومعقّدة وغنية.
هكذا ليس للرئيس الفلسطيني من يخلفه، والحديث هنا يتعلق بمكانته كرئيس للسلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية (أطال الله في عمره)، إذ أن التماهي بين الرئاستين هو أحد أهم أسباب أزمة الحركة الوطنية والنظام السياسي الفلسطينيين، فعلى الرغم من أن المجلس الوطني، الذي عقد قبل أسابيع، أحال صلاحياته إلى المجلس المركزي، إلا أن هذه الإحالة بالذات تنمّ، أيضا، عن عجز وقصور النظام السياسي الفلسطيني.
الحديث يدور هنا بشكل خاص عن واقع الكيانات السياسية، أي المنظمة والسلطة والفصائل والمنظمات، التي انتهت آجالها الدستورية أو القانونية منذ زمن طويل، وباتت أمام استحقاق الانتخابات، أو استحقاق تجديد الشرعية، ما يفاقم من ذلك انحسار مكانتها الشعبية أو التمثيلية، على خلفية تراجع أدوارها النضالية في الصراع ضد إسرائيل، لا سيما مع اعتماد الخيار التفاوضي، وغياب الإجماع الوطني نتيجة الخلافات السياسية.
يقف النظام الفلسطيني إزاء استحقاق إعادة بناء منظمة التحرير والتخلص من عقلية الكوتا (المحاصصة الفصائلية)، واعتماد عضوية المجلس الوطني على قاعدة التمثيل والانتخاب، علما أن الاجتماع الذي عقد مؤخرا للمجلس الوطني جاء بعد 22 عاما على انعقاد سابقه، أيضا ثمة استحقاق انتخاب رئيس للسلطة، وانتخابات للمجلس التشريعي، ناهيك عن ضرورة إعادة بناء المنظمات الشعبية لتجديد حيويتها وفاعليتها. وباختصار نحن إزاء نظام سياسي، وكيانات سياسية، أضحت متقادمة، ومستهلكة، وتفتقد القدرة على تقديم أي إضافة جديدة، ويخشى أنها أصبحت بمثابة سد إزاء أي محاولة لتفعيل هذا النظام وتطويره، للتكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الناشئة.
فوق ذلك ثمة في الساحة الفلسطينية أربع شرعيات، الأولى وهي “الشرعية الثورية”، المتأتية من “عصر الجماهير” في حقبة الخمسينات والستينات، ومصدرها الرأي العام الفلسطيني الذي وجد في انطلاقة الكفاح المسلح، وتضحيات وبطولات الفدائيين محاولة لترميم روحه، وتحقيق آماله. والمشكلة أن هذه الشرعية مازالت تعمل وفق نظام المحاصصة الفصائلية، رغم انتهاء مفاعيلها ومعانيها، ورغم تقادم وأفول معظم الكيانات السياسية المتشكلة منها.
التماهي بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير هو أحد أهم أسباب أزمة الحركة الوطنية والنظام السياسي
أما الثانية، فهي الشرعية التمثيلية، التي مصدرها الشعب، كما تتجسد في صناديق الانتخابات، وقد تمت بعد إقامة الكيان الفلسطيني الناشئ وفق اتفاق أوسلو (1993)، لذلك فهي مثل الاتفاق شرعية جزئية ومنقوصة، لأنها شرعية متأتية من جزء من الشعب فقط على جزء من الأرض، وفق حقوق مقيدة. وهذه أيضا انتهت إطاراتها الزمنية من الناحية القانونية، وهذا ينطبق على مكانة الرئيس ومكانة المجلس التشريعي إذا انقضى على انتخابهما 12 عاما، ولا يوجد في الأفق ما يوحي بالتوجه نحو تنظيم انتخابات جديدة.
وثمة أيضا، شرعية ثالثة، وهي المنبثقة من القيادة الفلسطينية ذاتها، إذ تقوم قيادة منظمة التحرير، ورغم أنها غير منتخبة مباشرة من الشعب، بتشكيل هيئات تضفي عليها شرعية معينة، مستغلة مكانتها، ومستقوية بالشرعية الدولية والعربية التي تحظى بها، وهو ما ينطبق على رئاسة السلطة، التي تقوم بذات العملية، في ظل حال الفراغ في الشرعيات، وتغييب الأطر التشريعية الفلسطينية (المجلس الوطني والمجلس التشريعي)؛ ما يعني أن لدينا حالة تبدو فيها القيادة الفلسطينية وكأنها تنتخب ناخبيها، أو تحدد الناخبين الذين يجددون بدورهم شرعيتها.
أما الشرعية الرابعة والأخيرة فهي الشرعية الفصائلية، فقد بدأت تشتغل بعد انحسار مكانة منظمة التحرير كمرجعية لكل الفلسطينيين، وتبعا للانقسام الحاصل في حركة التحرر الوطني الفلسطيني، بين الحركتين الرئيستين (فتح وحماس)، وانقسام النظام السياسي بين سلطتي الضفة وغزة، ومع أن هاتين الحركتين تتنازعان على مكانة الشرعية والمرجعية والقيادة عند الفلسطينيين إلا أن كل فصيل فلسطيني، مهما كان حجمه، وشكله، ودوره، يتمسك بنظام المحاصصة، وفوقها يدعي، أيضا، أنه يمتلك شرعية، وأنه يتحدث باسم الشعب الفلسطيني، من القيادة العامة وفتح الانتفاضة إلى جبهات التحرير والنضال والعربية وحزبي الشعب وفدا.
وتحظى الساحة الفلسطينية أيضا بنظامين سياسيين، واحد يتمثل في منظمة التحرير، أو ما تبقى منها، وهذا يفترض فيه أنه يمثل كل الشعب الفلسطيني، وأنه يرمز إلى وحدة قضية الفلسطينيين. والثاني يتمثل في السلطة القائمة في الأراضي المحتلة (1967)، وهي خاصة بفلسطينيي الضفة وغزة. المشكلة في النظام الأول أنه مازال يعمل رغم تهميش المنظمة، وعدم تجديد هيئتها التشريعية، وهي المجلس الوطني.
أما النظام الثاني فهو المتمثل بالسلطة في الضفة والقطاع، والتي انقسمت على ذاتها بين الضفة وغزة بسبب الخلاف والتصارع بين حركتي فتح وحماس.
المشكلة أن هذه السلطة تشتغل وفقا للمعايير الإسرائيلية، لا سيما المحددة في اتفاق أوسلو، وضمنها اتفاقية التنسيق الأمني، والاتفاق الاقتصادي، لا سيما أن السيادة مازالت في يد إسرائيل، على الأرض والمياه والكهرباء والعملة والتبادلات التجارية والمعابر والأجواء والمياه الإقليميتين؛ وحتى رئيس السلطة يحتاج إلى تنسيق في تحركاته في الداخل، كما من وإلى الخارج.
بيد أن معضلة الشرعية لا تتوقف على ذلك إذ أن ما يفاقم مشكلتها أنها مرتبطة، بأفول المشروع الوطني الفلسطيني، وإخفاق الخيارات السياسية التي أخذتها حركتهم الوطنية على عاتقها، مع تزايد شعورهم بالضياع، والافتقاد إلى مرجعية في كل ما يتعلق بأوضاع مجتمعاتهم، في الأراضي المحتلة (48 و67) وفي بلدان اللجوء.
من كل ذلك يمكن الاستنتاج أن ثمة معضلة في الشرعية الفلسطينية، في معناها ومبناها، والمشكلة أن القيادة الفلسطينية، أو الطبقة السياسية السائدة، منذ حوالي نصف قرن، لا تشتغل على أساس أنها تدرك مخاطر هذه المعضلة، وضمنها المخاطر المتأتية من تآكل الشرعيات الفلسطينية، الثورية والتمثيلية والفصائلية، بانتهاء زمن الكفاح المسلح وأفول الزمن الفصائلي، وتحول حركة التحرر إلى سلطة، ومع عدم تجديد المجلسين الوطني والتشريعي.